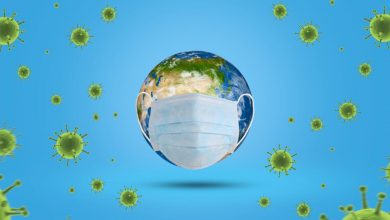الكورونا وقيمة الإنسان عند الله

القرآن الكريم وهو يقص علينا قصة خلق الإنسان وجوداً ومقصداً ووظيفة، وقف عند قضيتين في غاية الأهمية، يثيرهما قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة: آية 38-39]:
الأولى: ارتباط قصة خلقه –والمقصود هنا أبو البشر آدم عليه السلام- بمكانين، الأول جعله خليفة في الأرض، والثاني الجنة التي أمر بسكناها مع زوجه، ولكن لم يكن سكنى الجنة كما يظهر من السياق القرآني مقصوداً للخالق على الدوام من حيث الأصل إلا بعد التحقق الوظيفي للإنسان في الأرض، فكان إدخالهما إلى الجنة فيما يبدو الوقوف على حقيقة المأوى الذي سيؤول إليه الإنسان حالة تحققه بمنهج الاستقامة، ثم التسلح بمنهج المدافعة والمقاومة في مواجهة أعداء هذا الإنسان والذي يمثلهم إبليس وأتباعه من الجن والإنس، ولذلك جاء ذكر الهبوط من الجنة ليس في سياق الاقتران بالخطيئة التي وقع فيها آدم عليه السلام، بل جاء مقترناً بالتوبة والاجتباء، وعلى هذا الأساس فإن التذكير بقيمة الإنسان عند الله تعالى أخذ مداه في الخطاب القرآني، ولذلك جاءت ألفاظ خلق الإنسان في أحسن صورة، والتكريم، والتفضيل على الغير، والاجتباء، والعبدية الصالحة، والهداية والاهتداء .. في غيرها.
الثانية: اقتران الهبوط إلى الأرض بمنهج الهدى والاستقامة؛ ليفهم الإنسان أنه كلف بوظيفة الاستخلاف في الأرض لتحقيق مقاصد عليا من خلقه وإنزاله إلى الأرض، وهي إقامة التوحيد والدعوة إليه، وتزكية النفس بالفضائل، وعمران الأرض بكل ما هو صالح والحفاظ على صلاحية الوجود لمعيشة الإنسان، في مقابل ذلك سخر له هذا الوجود لتحقيق مهمته في الأرض؛ فيكون في هذا إرشاد للإنسان بأنه مكلف بمهمة خلق لأجلها على صورته ومنح فسحة زمنية للقيام بها، وزود بميزان لتقويم إصابته وخطئه في أدائه لها[1]، فقال تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز)[الحديد: آية 25].
فإذا اختل عند الإنسان سؤال وجوده والغاية منه ونسي أو تناسى المهمة والوظيفة التي خُلق من أجلها، وانصرف منها إلى الانشغال بمتع الحياة وشهواتها وملذاتها، وارتبط ذلك كله باستغلالٍ للأرض أبشع الاستغلال، انتهى أمره إلى فساد وإفساد لا محالة، وبذلك تصبح الأرض التي هي محضنه الذي صلح لحياته فيه غير قابلة لاستعياب نشاطه بعيداً عن منهج الهدى والاستقامة، فتتغير معالمها حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت بما جنته يداه، ولكن يبقى للرجوع مجال يجعل الله فيه للإنسان توبة وأوبة وإنابة وندماً، قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)[الشورى: آية 30].
إن المتأمل لحال البشرية اليوم –بعيداً عن منطق العقاب والعذاب- وهي تواجه واحداً من أفتك الأمراض والأوبئة في تاريخها المعاصر، يدرك لا محالة أن الذي أصابها إنما كان سببه الاستغلال البشع لمقدرات الأرض وثمراتها، والمخالفة الصريحة لمنهج الهدى والاستقامة، والانغماس في المحرمات والفواحش، ولقد زود الله الإنسان من خلال شرعه وهديه وكتبه قواعدَ وضوابطَ تحفظه من كل ما يعوق مسيرة حياته، وبأدق تفاصيلها، فجاء التنصيص على محرمات بعينها، أثبت الشرع ضررها على الإنسان، وأثبت العلم الحديث بعد قرون طويلة أنها تدابير تقي الإنسان وتحفظه من الأوبئة والأمراض الفتاكة، وهنا يقول ربنا سبحانه في وصف نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)[الأعراف: آية 157]، وبهذا يظهر فضل الشريعة الإسلامية ومحاسنها، وضرورة أن يضطلع المسلمون بمسؤولية تبليغها والدعوة إليها، وهو قوام مهمتها الحضارية، قال سبحانه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)[البقرة: آية 143]، وحتى تستطيع البشرية مواجهة هذا الوباء وأمثاله عليها أن تعيد النظر في سياساتها العامة المتعلقة بالصحة والغذاء وتغيير أنماطها بما يتوافق مع الحفاظ على الإنسان وبنيته وتأمين مسار معيشته، ولا يضمن ذلك ويكفله إلا اتباع الشرع واستثمار قوانينه الحافظة.
[1] انظر في هذا المعنى: مصطفى جابر العلواني، عالمية الخطاب القرآني، ص124، والسيد عمر، خارطة المفاهيم القرآنية، ص75.