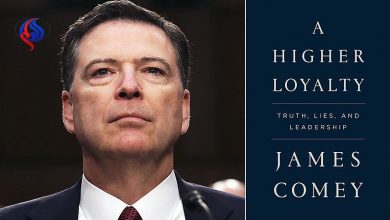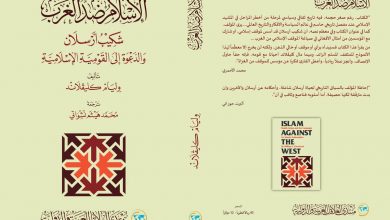المقدمة:
في لحظة مفصلية من تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تتشابك التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، وتُعاد صياغة خرائط النفوذ ومفاتيح القوة، يبرز سؤال العقل الإستراتيجي بوصفه ضرورةً لا ترفًا، ومسؤوليةً لا خيارًا، إذ لم يعد ممكنًا أن تُدار قضايا الأمة – وفي القلب منها الحالة المصرية – بذات الأدوات التقليدية أو الانفعالات اللحظية، بل بات من الواجب أن ينبثق تفكيرٌ أعمق، يُراكم الخبرة، ويعيد قراءة الواقع من منظور مركّب وشامل.
لقد أفرزت المتغيرات العالمية والإقليمية موجات متعاقبة من التحولات، وفرضت على الفاعلين الإسلاميين مراجعة جذرية لأنماط التفكير والتأثير، بعد أن ثبت عجز الكثير من المشاريع والخطابات عن مواكبة تعقيدات الواقع أو التأثير فيه بفاعلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى عقل إستراتيجي: عقل قادر على الفهم العميق، والرؤية الممتدة، وإدارة الواقع بوعي.
انطلاقًا من هذا، نظّم مركز رؤيا للبحوث والدراسات حلقة نقاشية علمية بعنوان:
السبيل إلى بناء عقل إستراتيجي للحالة المصرية
استضاف فيها نخبة من العلماء والمفكرين والدعاة والمشتغلين بالعمل السياسي والفكري، لمقاربة هذا التحدي المركّب.
وقد نُوقش في الحلقة النقاشية محوران رئيسان:
- العقل الإستراتيجي: من التأسيس إلى المأسسة:
عرض هذا المحور الأسس المفاهيمية والفكرية للعقل الإستراتيجي، من خلال ورقة تأسيسية أعدها مركز رؤيا، مع بحثٍ في شروط التحول نحو تكوين البناء المؤسسي لهذا المشروع الضخم.
- الحالة المصرية: مقاربة جديدة:
حيث تناولت الحلقة النقاشية الواقع المصري برؤية جديدة، تُعيد ترتيب المراحل، وتُحدّد الأولويات، وتُراجع الأدوات، في محاولة لتجاوز الإخفاقات السابقة نحو أفق أكثر نضجًا واستيعابًا للمآلات الممكنة.
وكان التركيز في هذه الحلقة النقاشية على الحالة المصرية لاعتبارين أساسيين:
أولهما: أن تعقّد مشاهد الأمة وتعدد تحدياتها يستلزمان تناول كل حالة على حدة، تفاديًا للتشتيت وضمانًا لعمق التشخيص ودقة المعالجة، إذ لا يمكن الإحاطة الشاملة بكل القضايا دفعة واحدة.
وثانيهما: ما تتمتع به مصر من ثقل وتأثير مركزي في الواقع العربي والإسلامي، وهو تأثير لا خلاف عليه، سواء على مستوى الجغرافيا أو في عمقها الحضاري وموقعها من معادلات الأمة الإستراتيجية، على أن تتناول بتوسع في الورشات واللقاءات القادمة بقية الحالات العربية والإسلامية، استكمالًا لبناء رؤية إستراتيجية متكاملة، لتشكّل بمجملها خارطة ضرورية لمأسسة العقل الإستراتيجي الجمعي للأمة.
المحور الأول العقل الإستراتيجي: من التأسيس إلى المأسسة:
بدأت الحلقة النقاشية بعرض تمهيدي تفصيلي للورقة التأسيسية التي أعدّها مركز رؤيا للبحوث والدراسات، والتي مثّلت أرضية مفاهيمية ومنهجية لمشروع “العقل الإستراتيجي”، وقد عالجت الورقة هذا الأمر ضمن هذه الأبعاد المتكاملة التالية:
1. فكرة مشروع العقل الإستراتيجي:
طرحت الورقة في مدخلها العام مبدأً تأسيسيًا مفادُه أن الأمة الإسلامية لا تواجه أزمة في الموارد أو الكفاءات، بقدر ما تعاني من غياب النسق الجامع الذي يوظّف هذه الإمكانات ضمن إطار معرفي وإستراتيجي متكامل.
وأكدت الورقة أنه لا سبيل لمواجهة مشاريع استهداف الأمة إلا بجنس فكرها الذي يتميز بالجمعية والإستراتيجية.
مع ضرورة الاستفادة من رصيد الأمة الهائل المبعثر على مستوى الأفراد والمؤسسات المرابطة على الثغور.
2. أهمية المشروع في السياق الراهن:
أكدت الورقة أن الواقع الراهن للأمة يتّسم بدرجة عالية من السيولة والاضطراب، في ظل غياب قيادة إستراتيجية تضطلع بمهام الرعاية الشاملة وتوجيه المواقف في الأحداث الكبرى.
وشددت الورقة على أن الأمة الآن لا صاحب لها ولا راعي لها، وأن الإصلاحات الجزئية هنا وهناك لا تمنع الانزلاق السريع إلى حيث تتوجس كل قلوب الغيورين عليها.
وأكدت أهمية استنفار طاقات الأمة الكامنة والسعي لرسم خارطة طريق لإخراجها من الأنفاق المظلمة التي دُفعت إليها، وهو ما يُعدُّ واجب الوقت.
3. مهمة الكيان الإستراتيجي المقترح:
تُحدد الورقة جملة من المهام الجوهرية التي ينبغي أن ينهض بها الكيان المقترح، وتتمثل فيما يلي:
- الاجتهاد في بناء الرؤية الإستراتيجية الإسلامية: رؤية منبثقة من المرجعية الشرعية، ومبنية على معطيات الواقع ومتطلباته.
- تحليل المشهد المحلي والدولي: من خلال النظر في القضايا الكبرى التي تعصف بالأمة، والعمل على تقديم تصورات إستراتيجية لكيفية التعامل معها.
- الاستفادة من سعة أفق الفقه الإسلامي: عبر الاتصال بين الفقه التشريعي المحض وبين ما يُعرف بـ”الفقه الحضاري”، الذي يعالج المسائل المركبة المتعلقة بالعمران والنهوض.
4.ماهية العقل الإستراتيجي:
في سياق تأصيل البناء المفاهيمي للعقل الإستراتيجي، تطرقت الورقة إلى تحديد ماهيته بوصفه أداة تسعى إلى تحويل الوعي الإستراتيجي من التنظير المجرد إلى الفاعلية المؤسسية، مؤكدة على دوره في الرصد والتشبيك، وتوليد الرؤية، وصياغة آليات التدبير والتغيير في ضوء مرجعية حضارية متكاملة.. وفيما يلي أبرز خصائص هذا العقل:
- هو كيان شبكي فاعل يسير على هدي بصيرة إستراتيجية، تضع أولويات أزمات الحاضر، وترسم الأهداف الصلبة للمستقبل القريب والبعيد.
- يقوم هذا الكيان بدوره من خلال تفعيل رؤى البصيرة الإستراتيجية وتحويلها لخطط إستراتيجية، قبل الدفع بها إلى دوائر التدبير والحركة.
- يربط أيضًا بين أوعية ومصادر رصد متنوعة تصبُّ كلها في خدمة الإستراتيجية المقررة.
5.تحديات ومعوّقات تأسيس العقل الإستراتيجي:
استعرضت الورقة أبرز العوائق البنيوية والمنهجية التي تعترض تأسيس بنية معرفية إستراتيجية فاعلة، وقد تمثلت هذه التحديات في الآتي:
- المواجهة المستمرة بين الأنظمة المستبدة والقوى الإصلاحية.
- الفصام النكد بين الحركي والفكري.
- التفكير الآني على حساب الإستراتيجي.
- الخطاب الدفاعي المتلبس بعقلية المحنة والأزمة.
- غياب فقه العثرات والكبوات ومنهجية الاعتبار.
- غياب الفقه السنني والمقاصدي.
- تحديات التمويل.
- القوالب الفكرية الجامدة للكيانات القائمة إلا بلطف الله أو تحرر الفكر.
6.محفّزات تأسيس العقل الإستراتيجي:
رغم التحديات، أبرزت الورقة عدة محفزات يمكن استثمارها لإطلاق مشروع العقل الإستراتيجي، من خلال تفعيل مكامن القوة الكامنة وتسخير الطاقات في خدمة الرؤية النهضوية الجامعة.
وجاءت المحفزات على النحو التالي:
- وفرة الإمكانات الفكرية والمادية المطلوبة لهذا البناء الإستراتيجي.
- المشروع الإحيائي يستحق كل جهد وبذل.
- النذير الحضاري والنفير الحضاري، وتفعيلهما في الأمة.
7.معالم كيان العقل الإستراتيجي:
سلّطت الورقة الضوء على أبرز الملامح التي يجب أن يتّسم بها كيان العقل الإستراتيجي، مؤكدة على ضرورة استيعاب تعقيدات الواقع، وبلورة أدوات عملية تراعي طبيعة المرحلة، وتمثلت أهم هذه المعالم فيما يلي:
- الاجتهاد الجماعي.
- تكامل وتكافل التخصصات، ومعايير ومتطلبات نجاح ذلك.
- تحديد مواصفات خمائر وبنية وبناء العقل الإستراتيجي.
- إدراك حقيقة الواقع ودينامياته وتعقيداته وتجديداته.
- المرابطة على هذا الثغر وعدم مغادرته مهما كانت حوادث التدافع الجزئية واليومية.
- أشكال وأوعية الكيان الإستراتيجي (البصيرة – الرصد – التدبير والحركة – الإستراتيجية الجيلية).
- متطلبات مرحلة الإقلاع والانطلاق.
الاجتهاد الجماعي:
تناول العرض أهمية الاجتهاد الجماعي والعقل الشوري كأحد الأعمدة المؤسِّسة للعقل الإستراتيجي، بوصفه مظهرًا من مظاهر الانتقال من الأداء الفردي المتناثر إلى الفعل الجماعي المنهجي، المرتكز على الشورى والتكامل بين التخصصات، وقد برزت معالمه كما يلي:
- إن عظم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تستلزم الارتقاء إلى مستواها بجهود جماعية في كل جانب وعلى كل مستوى.
- العمل المؤسسي سمة العصر الذي لم تعد تنفع به الاجتهادات الفردية غير المتكاملة وغير المتناسقة.
- الاجتهاد الجماعي فيه تأكيد على مبدأ الشورى والتدريب عليه، والحدُّ من ظاهرة الفردية والتبعثر.
- في الاجتهاد الجماعي فتح باب الممارسة الواسعة لكل من فقه الفروض العينية وفقه الفروض الكفائية.
- الاجتهاد الجماعي يمثل لونًا من “الإجماع الواقعي” الذي تحقق مثله في صدر الإسلام على يد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسُمي بعد ذلك إجماعًا.
إدراك حقيقة الواقع ودينامياته وتعقيداته وتجديداته:
يشكل إدراك الواقع بكل أبعاده الديناميكية والمعقدة ركيزة أساسية في بناء العقل الإستراتيجي، إذ لا يمكن تطوير رؤية إستراتيجية فاعلة دون فهم معمّق للتحولات المستمرة التي يمر بها المجتمع والأمة.
المرابطة على الثغور:
المرابطة على هذا الثغر وعدم مغادرته مهما كانت حوادث التدافع الجزئية، وهذا يتطلب: عدم إشغال مكونات الكيان الإستراتيجي بمهام أخرى (على الأقل على مستوى البصيرة الإستراتيجية).
أشكال وأوعية الكيان الإستراتيجي:
يمكن أن يكون له أشكال وأوعية متنوعة؛ ذلك بأن مهام العقل الإستراتيجي تتوزع بدورها على ساحات تتكامل هي:
أ- مراصد إستراتيجية تشمل: مراكز دراسات، مصادر معلومات، مراكز استشراف مستقبل، مراكز استغراب، مراكز قياس رأي واستطلاعات، مراصد وأكاديميات تعليمية وتأهيلية…
ب- بصيرة إستراتيجية: توفر الرؤية الإستراتيجية.
ج- كيان يستقبلها ويحولها ببرامج تشغيل لتدبير وحركة إستراتيجية.
د- إستراتيجية جيلية تراعي تقديم الشباب للقيادة والمسئولية.
متطلبات مرحلة الإقلاع والانطلاق:
- إعداد ورقة تأسيسية بدواعي وأهمية ومعالم الكيان المفترض يسهل تقديمها للمهتمين بالمشروع، ومهمة ورسالة وأهداف ووظيفة وإسناد العقل الإستراتيجي.
- السير من حال التأسيس إلى العملية المؤسسية.
- التكوين لن يكون دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي تراكمي بالاستفادة من الموجود وإدراك وإيجاد المفقود.
- الأخذ في الحسبان التنوع الفكري والجغرافي والثقافي والحركي استيعابًا وفهمًا وتمثيلًا.
- بيان تمايز الفكرة عما عداها أو يشبهها كالمجامع الفقهية.
- رصد الجهود السابقة في القرنين الأخيرين.
- تحديد سقف زمني لانطلاق عمل العقل الإستراتيجي.
- روافع العقل الإستراتيجي:
- جمع إنتاج ذوي العلم والبصيرة ممن عُنوا بهذا الموضوع.
- التكتم والهدوء في لقاءات الكيان وفي تدوين مخرجاته وتداولها.
- التوافق على مواصفات وضوابط واضحة وملائمة لأعضاء الكيان كأفراد، وأخرى للتشكيل الجماعي.
- استطلاع أفكار وآراء الشخصيات المبرزة في التخصصات المختلفة.
- عدم اشتغال الكيان بما اشتغل به السابقون، والاكتفاء به، خاصة في توصيف الحالة الراهنة، وتشريح أسباب التخلف والركود.
9.خوافض العقل الإستراتيجي:
فوات هذه الروافع أو التهاون فيها يعتبر أخطر الخوافض التي تواجه هذا الكيان.
المحور الثاني الحالة المصرية: مقاربة جديدة:
تناول هذا المحور الواقع المصري برؤية جديدة، تُعيد ترتيب المراحل، وتُحدّد الأولويات، وتُراجع الأدوات، في محاولة لتجاوز الإخفاقات السابقة نحو أفق أكثر نضجًا واستيعابًا للمآلات الممكنة.
أولًا: بين إدارة المؤسسات وتدبير شأن الأمة.. مدخل تأسيسي للحالة المصرية:
قدم أحد الخبراء الإستراتيجيين المشاركين في الحلقة طرحًا مهمًّا حول اختلاف طبيعة التفكير الإستراتيجي للأمة في مجال الشأن العام والسياسي عن أساليب إدارة المؤسسات الاقتصادية والشركات وغيرها من الجهات الخاصة.
وفي هذا السياق، استعرض الخبير الحالة المصرية باعتبارها سلسلة من الأزمات المتراكمة والمتعاقبة عبر السنوات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن محاولات ممنهجة لصهر الشخصية المصرية، وتجريدها من ثقتها بنفسها، وفي قدرتها على الفعل وحقها في الحرية.
كما لفت الانتباه إلى استهداف الهوية المصرية الجامعة، لا سيما رمزيتها الحضارية العلمية المتمثلة في الأزهر الشريف ودوره المحوري في تعزيز ونشر العلم والمعرفة.
كما قدّم الخبير مقاربة مغايرة لمسار العمل الإستراتيجي، مؤكّدًا أن الانطلاق لا يكون من تحديد الأهداف الإستراتيجية فحسب، بل من تحديد النتائج المطلوبة أولًا، وهي التي ينبغي أن تُبنى المؤسسات بناءً عليها، وبخاصة تلك المعنية بالعقل الإستراتيجي.
ولتحقيق هذه النتائج، طرح مجموعة من المتطلبات الأساسية، منها:
- احترام التخصص: بوصفه مدخلًا أساسيًّا لبناء رؤية دقيقة ومنضبطة.
- امتلاك المعلومة من مصدرها الأصلي: عبر قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة.
- وضع خارطة للأزمات المصرية: وذلك وفق منهج دقيق لدراسة الأزمات، مع تصنيفها إلى مستويات، وقراءتها بأدوات إحصائية رقمية سليمة، وتوزيعها جغرافيًّا بما يكشف بنية الواقع.
- وضع خارطة للجهات الفاعلة والمؤثرة داخليًّا: بحسب حجم تأثيرها في الحاضنة الشعبية، ومدى قدرتها على صناعة الفعل أو تعطيله.
ثانيًا: منطلقات أساسية لبناء العقل الإستراتيجي للحالة المصرية:
في سياق المقاربة الجديدة للحالة المصرية تبرز الحاجة إلى إعادة التعرف على منطلقات التفكير الإستراتيجي، وقد طُرح في الحلقة النقاشية تصورٌ يقدم أصولًا ومداخل أساسية لهذا العقل.
1-الانتقال من فكرة الثورة إلى فكرة التغيير:
ينطلق هذا التصور من مراجعة عميقة تدعو إلى الانتقال من فكرة الثورة إلى فكرة التغيير، باعتبار أن التغيير مفهومٌ أوسع وأكثر شمولًا، تندرج الثورة ضمن مظلته بوصفها أحد أشكاله الممكنة لا شكله الوحيد، مع التأكيد على ضرورة تجاوز قمقم نموذج الدولة القُطرية إلى أُفق أشمل يتمثل في مفهوم الأمة الإسلامية، انطلاقًا من أن الثورات، وإن بدأت بجهود فردية أو محلية، إلا أن أهدافها ومآلاتها تتصل بالواقع الجماعي للأمة، كما أن إجهاض هذه الثورات والتآمر عليها كان ضمن جهود إقليمية وعالمية، ولم تكن مواجهة قطرية!
مع التأكيد على أهمية العمل داخل أُطر كل دولة بالمقدور عليه وبما يمكن، دون الوقوع في أسر الجغرافيا أو حدود المصالح الضيقة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية تضع الأمة في قلب المشروع، وتتعامل مع الحدود كاعتبارات واقعية لا قيدًا على الانتماء أو الرسالة.
2– تأسيس عِلمَيِ التدبير والحركة:
ضمن المقاربة الجديدة التي طُرحت في الحلقة حول الحالة المصرية، برز التأكيد على ضرورة التأسيس لعلمَيْن مركزيين:
علم الحركة، وعلم التدبير، وهو ما نادى به المفكر الكبير الدكتور حامد ربيع في أطروحاته التنظيرية الرائدة.
مع الإشارة إلى أن علم التدبير هو علم ذو طابع مركّب، ينقسم إلى تصنيفات متعددة، ويشمل مختلف مناحي التفكير والتسيير، كما يغطي مجالات الفاعلية والتأثير، ويتناول بعمق أدوات التخطيط وبناء الرؤية المستقبلية.
ويُعدُّ هذا التأسيس ضرورة إستراتيجية لتوجيه الطاقات نحو مقاصد مدروسة تحقق الفاعلية المنشودة، ويتساند معه علم الحركة القائم على التطبيق والتنزيل على ميدان الواقع وساحاته.
3– طبيعة العقل الإستراتيجي المصري الحالي: بين الاستبداد والتبعية:
تناول هذا المحور بالنقد والتحليل طبيعة ما يُسمَّى بـالعقل الإستراتيجي المصري أو الأمني، والذي يتموضع داخل بنية سلطوية مغلقة تقوم على فرضية أن رأي الحاكم هو الصواب المطلق، وتُدار ضمن حلقات مركبة من الاستبداد.
ويؤدي هذا النموذج عمليًّا إلى تدمير العقل الإستراتيجي الحقيقي عبر استبعاد التفكير الحر، وتهميش النخب، وتحويل الدولة إلى أداة ضبط لا منصة تخطيط.
وخلُص الطرح إلى أن العقل الإستراتيجي في حقيقته نقيض للاستبداد والاستعمار (أو الاستخراب)، إذ لا يمكن لهذا العقل أن ينمو أو يُثمر داخل بيئات تقمع الإرادة، وتُجهض المبادرة، وتُقصي العقلاء، فالمشروع الإستراتيجي النهضوي لا ينفصل عن شروطه الأساسية، وعلى رأسها التحرر من التسلط والتبعية.
4-حول التفكير الإستراتيجي:
في ظل ما تعانيه الأمة من أزمات بنيوية ومخاطر وجودية، جرت الإشارة إلى أن التفكير الإستراتيجي في العالم العربي ما يزال مهضومًا ومهملًا، بينما تسود الفرقة المشهد العام، بجانب أن المفكرين الإستراتيجيين، وهم قلة نادرة، لا تحظى باهتمام يُذكر في فضائنا العربي، رغم أن أحوال الأمة وما تمر به من حروب ومآزق مصيرية تستدعي اجتماع هؤلاء المعنيين وصنّاع الرؤية على طاولة تشخيص الأزمات والتخطيط للخروج منها.
إن غياب هذا النموذج من التفكير يفرض ضرورة تكوين عقل إستراتيجي جمعي، يقوم على الشورى ويُفعل فريضة الكفاية على مستوى الأمة، فـصناعة الإستراتيجية تتطلب ملكات تفكير، ورشدًا في التدبير، ووعيًا بأصول التغيير.
ويتكامل هذا الجهد ضمن مثلث الاهتمام الإستراتيجي:
- وجود مشروع إستراتيجي شامل، يمثل أولوية كبرى.
- الشرعية، عبر الاستناد إلى القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبار الشريعة الإسلامية هي المرجعية الناظمة، ذلك أنّه عقب انقطاع الوحي بوفاة النبي ﷺ، ومع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يكون الاجتهاد هو السبيل، ونصوص الشريعة الإسلامية تُغري العقل بالبذل والاجتهاد، وتفتح له بابًا واسعًا في ذلك حتى لو أخطأ، إذ لا يأثم المجتهد المخطئ، بل يؤجر إن صدق، وهو ما يجعل من الاجتهاد مسلكًا مأمون العاقبة في البحث عن الصواب.
ومن هنا فإن تأسيس العقل الإستراتيجي للأمة لا يمكن أن ينفصل عن الاجتهاد، لأنه لا يُبنى على التقليد الجامد، بل على الفهم العميق للنصوص، والتفاعل الناضج مع الواقع، والتقدير المسؤول للمآلات.
- الشارع، باعتباره شرطًا ضروريًّا لإنفاذ التغيير، فلا يجوز إغفاله أو تجاوز فعله.
إن الجمع بين هذه الأضلاع هو ما يمنح أي جهد إستراتيجي أصالته وفاعليته.
وفي سياق بناء العقل الإستراتيجي، يبرز جانب حاسم يتمثل في “خرائط المجال الإستراتيجي“، وهو الإطار الذي يُعنى برفع الواقع وتقدير الإمكانات وتحديد الاتجاهات الممكنة للفعل، بما يمكن من تكوين رؤية إستراتيجية متكاملة تتعامل مع الحاضر ببصيرة وتستشرف المستقبل بفاعلية. ويقوم هذا المجال على عدة مكونات رئيسة:
أولاً: خرائط الواقع والإمكانات:
- التي تبدأ برفع الواقع بجميع مكوناته، لفهم السياقات البنيوية والسياسية والاجتماعية.
- تحليل الإمكانات المتاحة في البيئات المختلفة.
- رصد القدرات الفاعلة التي تمكّن من تحويل تلك الإمكانات إلى قدرات ومكانة إستراتيجية.
حيث تُحصل الإمكانات بجهد أو قد تكون متوفرة بذاتها، أما القدرات فهي “صنعة الفاعلية” التي تدير تلك الإمكانات وتوجّهها نحو التأثير والتموضع.
ثانيًا: خرائط الفعل والرؤية:
- خرائط الفرص والمنح.
- خرائط التحديات والتحالفات.
- خرائط البدائل والمسارات.
- خرائط الفاعلية؛ أي مراكز الضغط والتأثير، ودوائر الفاعلين الممكنين.
كل هذه الخرائط مجتمعة تُسهم في تشكيل الرؤية الإستراتيجية الكاملة، بما يحقق الفهم العميق للبيئة ويوجّه جهود العقل الجمعي نحو التدبير والبناء لا نحو ردود الأفعال العابرة.
5-خبرات التغيير: نحو مراجعة إستراتيجية شاملة:
لا يمكن للعقل الإستراتيجي أن يؤدي وظيفته بصورة ناضجة دون أن يرتكز على مراجعة دقيقة وشاملة لخبرات التغيير والثورات، باعتبارها تجارب مليئة بالدروس والإشكالات التي ينبغي تفكيكها، وتساؤلات تفرض نفسها بإلحاح على أي مشروع يروم إعادة البناء.
ويطرح هذا الملف الحيوي عددًا من الأسئلة والمداخل التي تستدعي النظر والتأمل:
أولًا: تساؤلات محورية حول الثورات العربية:
- هل كانت الثورات العربية ثورات حقيقية؟
- ماذا حدث فعليًّا في هذه الثورات؟ وهل غاب عنها العقل الإستراتيجي؟
- ما حجم تأثير الزلازل التالية:
- زلزال القوى المضادة (المضادون للثورات) ممن حاربوها بقوة.
- زلزال غياب الإنسانية في التعامل مع تطلعات الشعوب الثائرة من أجل التغيير.
- زلزال إعادة تشكيل المنطقة أو ما سُمي بصفقة القرن أو مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ثانيًا: مراجعة مواقف “الدولتية“:
إذ لا بد من مراجعة موقف من يُطلق عليهم “الدولتيون” الذين يغلقون باب التغيير بدعوى الحفاظ على الاستقرار. وإنقاذ الدولة من الوقوع في الفوضى.
ثالثًا: أهمية علم إدارة المرحلة الانتقالية:
من أبرز المراجعات التي ينبغي التوقف عندها في هذا السياق الاهتمام بإدارة المرحلة الانتقالية ومن ذلك:
- ضرورة إدراك مفهوم إدارة المرحلة الانتقالية بوصفه علمًا قائمًا بذاته.
- لهذه المرحلة خصائص داخلية، وتحديات نوعية، وأدوات خاصة، وغايات محددة تتطلب إدارة رشيدة.
رابعًا: الاستقطاب الداخلي:
من أبرز المراجعات التي ينبغي التوقف عندها في هذا السياق ما يتعلق بكيفية تجاوز آثار الانقسام والاستقطاب وعلى رأس ذلك:
- ضرورة التعامل مع الحالة الاستقطابية، باعتبارها “مقبرة الثورات”.
- التساؤل: هل يمكن بعد الفرقة والاختلاف في إدارة النزاعات أن نُعيد البناء المشترك؟
خامسًا: سؤال التيار المركزي:
- ما الحد الأدنى الجامع له؟
- وما التيار الأساسي للأمة المنوط به قيادة الحراك والثورة والتغيير؟
سادسًا: المستقبل والتأهب له:
- إن التغيير قادم لا محالة.
- الاستعداد له واجب، وذلك عبر تحقيق شروطه وتوفير متطلباته.
إن عقلًا إستراتيجيًّا لا يقف على أطلال التغيير ولا يكتفي بشعاراته، بل يشتغل بتفكيك تجاربه ورفع عِبره وتحويلها إلى معرفة ووعي، هو وحده القادر على الانتقال بالأمة من الوقوف عند عثراتها إلى مسارات نهوضها.
ثالثًا: عرض الحالة المصرية في جوانبها المتعددة: مقاربة تحليلية واقعية:
ضمن هذا المحور الثاني من الحلقة، تُنولت الحالة المصرية من خلال رؤية تحليلية متعددة الأبعاد، تأخذ في الاعتبار التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية، والارتباط بين ما هو اقتصادي وسياسي وأمني وحقوقي.
وقد أُبرزت هذه الجوانب على النحو الآتي:
أولًا:الجانب الاقتصادي:
- يتبدّى من طريقة إدارة النظام المصري الحاكم، وبدعم من قوى إقليمية فاعلة، أن الاقتصاد المصري يُراد له أن يبقى على حافة الهوية، ولكن دون أن يسقط كليًّا، لضمان بقاء مصر تحت السيطرة فاقدةً لاستقلال قرارها.
يظهر ذلك جليًّا في ملف الغاز، حيث تُدفع مصر للاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي كمصدر إستراتيجي، مما يُعمَّق التبعية ويُضيِّق هامش المناورة السيادية.
ويمتد هذا النمط أيضًا في ملفات أخرى داخل الجانب الاقتصادي، وعلى رأسها ملف الديون، حيث تتزايد معدلات الاقتراض الخارجي والداخلي بشكل غير مسبوق، دون وجود خطط واضحة للإنتاج أو السداد، ما يجعل القرار الاقتصادي مرتهنًا للدائنين والمؤسسات المالية الدولية.
ثانيًا: الجانب السياسي:
- يسود انسداد سياسي تام، حيث لا توجد أية آفاق للإصلاح أو الانفتاح.
- يتجلى المشهد في استبداد داخلي يتزايد قمعًا، مقابل تبعية خارجية واضحة وخضوع سياسي للقوى الدولية والإقليمية.
ثالثًا: الجانب الحقوقي:
- لا تبدو لدى النظام أية نية لإحداث انفراجة حقوقية، إذ تستمر الانتهاكات بحق النشطاء والمعارضين، الذين يُعرضون للاعتقال والتدوير دون أفق تغيير واضح.
رابعًا: الجانب العسكري والأمني:
- يقوم المشهد على توازن دقيق بين الجيش وبين رأس النظام عبد الفتاح السيسي، تُراعى فيه مصالح المؤسسة العسكرية في مقابل استمرار دعم بقاء رأس النظام.
- رغم أن الدستور المصري ينص على حق الجيش في التدخل عند تهديد الأمن القومي والذي يشهد تراجعًا ملحوظًا، إلا إن التوازن الحالي بين المؤسسة العسكرية ورأس النظام لا يدفع الجيش حتى الآن إلى النزاع أو التخلص من نظام السيسي القائم.
- يلاحظ في هذا المشهد تأثير الإمارات الخارجي الحاضر بقوة، حيث تُحافظ الإمارات على نفوذها داخل مصر من خلال علاقة توازن دقيقة مع المؤسسة العسكرية.
خامسًا: ملف الأمن القومي:
- يُعدُّ ملف الأمن القومي من أخطر ما يواجهه الواقع المصري، إذ فقدت مصر قدرتها على التأثير في أهم ملفاتها الحيوية، المتمثلة في: السودان، ليبيا، غزة، نهر النيل مع إثيوبيا، علاقاتها الخارجية بشكل عام.
لقد تحوّل الأمن القومي عمليًّا إلى أمن النظام فقط، وانحصر مفهومه في حماية بقاء السلطة لا حماية الدولة والشعب، كل هذا يكشف عن الحاجة الماسّة إلى مراجعة يقوم عليها عقل إستراتيجي يستوعب التحديات والمآلات، من أجل إطلاق مشروع إنقاذ مصر من حالة الانحدار العام الذي تسبب فيها النظام الحاكم في إطار أفق مشروع الأمة الجامع.
مناقشات حول محاور الحلقة النقاشية:
عقب استعراض المحاور الرئيسة التي تناولتها الأوراق المقدّمة، دار نقاشٌ موسّع بين المشاركين، تركز حول جملة من الإشكالات والفرص المرتبطة بمشروع العقل الإستراتيجي. وكان من أبرز ما طُرح في هذا السياق:
- التأكيد على ضرورة وجود (جسم) كيان مؤسسي حاضن للعقل الإستراتيجي، يتولى تحويل ما يُنتج من رؤى وأفكار إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، بحيث لا يبقى المشروع في إطار التنظير المجرد.
- أُثيرت إشكالية افتقار التيارات الفاعلة في الأمة إلى الممارسة المؤسسية للتفكير الإستراتيجي، وهو ما يستوجب جهدًا تربويًّا وتراكميًّا لتوطين هذا النمط من التفكير وتمكين الثقافة والقيم المؤسسية.
- جرى التأكيد على أهمية قيام مراكز الفكر والدراسات بدور استباقي في اكتشاف العقول الإستراتيجية المؤهَّلة، من خلال أدوات علمية ومنهجيات تقويم دقيقة، لتكوين نواة فاعلة ومؤثرة تتولى مهمة التشخيص والبناء والتوجيه ضمن هذا المشروع.
- كما تطرق النقاش إلى مسار تشكّل العقل الإستراتيجي، باعتباره عملية تراكمية تمر بمراحل متمايزة ومتداخلة، تبدأ من المستوى الفردي وتنتهي بالتجليات المؤسسية على أرض الواقع.
وقد جرى التأكيد في هذا السياق على أن العقل الإستراتيجي لا ينشأ دفعة واحدة، بل يمر أولًا عبر مرحلة “العقل الناضج“، وهو العقل الفردي الذي يتسم بالاتزان الفكري والقدرة على استيعاب التعقيدات ومآلات الأحداث.
يلي ذلك مرحلة “العقل الجمعي“ أو الشوري، الذي يُنتج من خلال التفاعل بين عدد من العقول الناضجة في إطار تشاوري، ويُبنى فيه على التفكير التكاملي والشبكي القائم على توزيع الأدوار وتعدد الزوايا.
أما المرحلة الأرقى، فهي “العقل الإستراتيجي المؤسسي“، الذي تنعكس مخرجاته على الواقع عبر خطط وسياسات.
- وتطرق النقاش إلى ملاحظة جوهرية تتعلق بواقع الحضور الإسلامي، حيث أُشير إلى غياب الإسلاميين عن مجالات عمل مهمة، لا سيما في الجوانب الحقوقية والسياسية، مع تركيزهم الكبير على الجانب الخدمي.
وقد جرى التأكيد على أن العقل الإستراتيجي لا يمكن أن يحقق فاعليته ما لم يدلف بوعي وتخطيط إلى هذه المساحات الغائبة، بوصفها ميادين مركزية لصناعة التغيير وحماية مكتسباته، وكسر طوق الاستبعاد والتغييب الذي يُفرض على قوى الأمة الفاعلة.
- دار النقاش كذلك حول العلاقة بين العقل الإستراتيجي والمشروع السياسي، حيث انقسمت الآراء إلى اتجاهين رئيسين:
- الاتجاه الأول: رأى أن المشروع السياسي هو المنطلق والبداية، وأن مهمة العقل الإستراتيجي تكون في خدمة هذا المشروع والعمل على تحقيق أهدافه، من خلال تقديم الرؤى والخطط الكفيلة بترجمته إلى واقع عملي.
- في المقابل، رأى الاتجاه الثاني– وهو ما رُجِّح في خاتمة النقاش-: أن العقل الإستراتيجي هو نقطة البداية والمنطلق، بوصفه الأداة التي تؤسس للمشروع السياسي من حيث التصور والبناء والتقدير، ثم تواكبه في كل مراحله حتى التنفيذ.
وفي كلتا الحالتين، فإن العقل الإستراتيجي لا يمكن أن يكون غائبًا، بل ينبغي أن يكون حاضرًا في كل مرحلة من مراحل التكوين السياسي وإرساء قواعد المشروع السياسي، منذ الفكرة الأولى وحتى التفعيل الميداني، لضمان الرشد، والاستمرارية، والتوازن بين المبادئ والواقع.
- وتطرق النقاش كذلك إلى متطلبات إنجاح فكرة العقل الإستراتيجي وتحقيق أهدافه بفعالية واستدامة، حيث جرى التأكيد على نقطتين جوهريتين:
- وضوح الكيان المستهدف بالعمل: وذلك من خلال تحديد من المُخاطَب بهذا المشروع، وما المجال الذي سيشتغل فيه، وماهية الجمهور أو البنية المجتمعية أو المؤسسية المعنية بثمار عمل العقل الإستراتيجي.
- وجود وحدة إستراتيجية عليا: تضطلع بدور الضبط والتوجيه والحماية للرؤية الكبرى، وتحرص على اتساق الجهود المرحلية مع الغايات النهائية، بما يمنع الانحرافات ويُحصِّن المشروع من الضغوط أو التفكك.
- أكد الحضور في مناقشاتهم على جملة من المرتكزات الفكرية والمنهجية الضرورية لتفعيل العقل الإستراتيجي:
على رأسها أهمية المراجعات: باعتبارها ركيزة تأسيسية للعقل الإستراتيجي، شرط أن تُمارس لا بروح التراجع أو جلد الذات، وإنما بروح التقويم العميق الهادف إلى التصويب والتطوير.
وعلى مركزية الشارع: كعنصر فاعل في إدارة الصراع، لا يمكن القفز عليه أو تجاهله، بل لا بد من إدماجه ضمن معادلة التغيير وصناعة التأثير.
وعلى التأسيس الإسلامي للعقل الإستراتيجي: حيث أشار الحضور إلى أن الإسلام قد بَنَى العقل الإستراتيجي منذ اللحظة الأولى، وذلك من خلال حضوره في الحديث مع بديات نزول الوحي عن العلم والقلم والإنسان، بوصفه نواة للوعي والبصيرة والتغيير.
وتأكد خلال النقاش أهمية فقه السنن: بوصفه أنه يمنح القدرة على فهم القوانين الربانية الجارية في المجتمعات والتاريخ، وتنزيل النصوص المتعلقة بها على الواقع بما يفضي إلى فهمٍ أعمق للمآلات وكيفية التعامل مع الأحداث والتحولات.
وتطرق النقاش أيضًا إلى مسألة تحديد السؤال الجوهري الذي ينبغي أن ينطلق منه العقل الإستراتيجي، حيث تعددت وجهات النظر حول طبيعة هذا السؤال:
- فهل سؤال النهوض هو السؤال المركزي، كما كان مناسبًا في أواخر الدولة العثمانية، حين كانت الأمة تعاني من ضعف في بنية الدولة المركزية ومؤسساتها؟
- أم أن سؤال التحرر من الاحتلال هو الأسبق، بالنظر إلى ما تعرضت له الأمة من احتلال مباشر ثم غير مباشر عبر وكلاء بعد سقوط الدولة العثمانية؟
- أم أن سؤال التجديد الحضاري هو الأصل الجامع، الذي يسبق النهوض والتحرر، ويُعنى بإعادة بناء العقل والواقع وفق مقاصد الشريعة وروح العصر، بما يشمل تجديد المنظومات والمناهج والأدوات؟
لأن تحديد منطلقات التصور الحضاري ضرورة لا غنى عنها قبل الانخراط في مقاربة أي مشهد جزئي سواء كان سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو غيره، كما أن الإجابة عن الأسئلة الكبرى يجب أن تسبق العمل التنفيذي.
الخاتمة:
ركزت هذه الحلقة النقاشية على محورين رئيسين:
العقل الإستراتيجي، والحالة المصرية، تناول المشاركون خلالها مفهوم العقل الإستراتيجي باعتباره ضرورة لبناء رؤية واضحة قادرة على مواجهة التحديات، مع التطرق إلى خصائصه وصعوباته وكيفية تفعيله.
كما استعرضت الواقع المصري من جوانبه المتعددة؛ الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإشارة إلى أهمية فهم الأزمات والتحديات بدقة والعمل على رؤية شاملة للتغيير، واتفق الجميع على أن نجاح التغيير يعتمد على وجود عقل إستراتيجي جماعي مؤسسي، يعمل بتنسيق، ويستند إلى المرجعيات الشرعية مراعيًا إمكانات الشارع، من أجل مواجهة الواقع بطريقة صحيحة لتحقيق نهوض حقيقي للأمة.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 21]
وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.