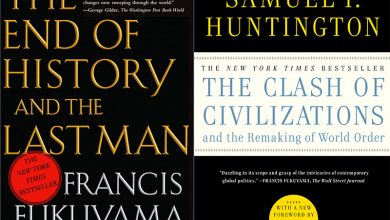اللغةُ والهُويَّة بين الاستلاب الحضاري واستعادة الوعي (5)
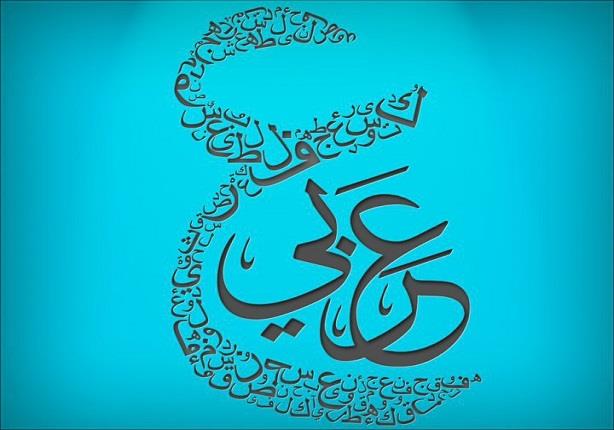
خامساً: أطوار منهج التذوق وتطبيقاته
كان من طبيعة منهج التذوق قديماً قلة التعليل أو ندرته في إطلاق الأحكام؛ لأن الدربة والممارسة والتجربة تتحصل منها حاسة ذوقية تستعصي على التعليل والتفصيل، وإنما يدركها أهلها ولا يترادون فيها لحصول الذوق عند جميعهم كما هو عند واحدهم؛ ولذلك تكثر في دواوين العربية الكبرى كلمات وجمل من قبيل: (ليس هذا من شعر فلان، وليس هذا من نسجه، أو هذا نسج فلان، أو لا يصح أن يكون هذا كلام أعرابي، أو هذا نسجٌ حضري)، وذلك حين ينسبون قصيدة أو بيت شعر لشاعر بعينه وينفونها عن شاعر آخر، أو يثبتون وينفون شعراً إسلامياً أو جاهلياً أو مولداً، حتى أن أصحاب الحديث من علماء الأمة كانوا ينفون الأحاديث الموضوعة أول ما ينفونها اعتماداً على ذوقهم بداهة؛ فينظرون في متن الحديث ودرجة مشابهته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: (ليس هذا من كلام النبوة، أو: ليس عليه رداء النبوة)؛ وذلك لطول ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودقة تذوقهم لكلامه، ثم لا تجد بعد ذلك من يُرادهم طالباً التعليل والشرح لعلمه أن التعليل يستتبع سنوات من الدرس والخبرة والتجربة والدربة قضاها الناقد والأديب والعالم في مصاحبة الآثار الأدبية والدينية فأنتج كلُّ ذلك حكماً معتمداً على ذوق خاص لم يولد بين عشية وضحاها. ونحن نرى في عصرنا الحاضر اختلاف أساليب وأنماط ومذاهب الشعراء في القول حتى أن الناقد المكثر لقراءة شعر شاعر بعينه ليعرف شعره وينسبه إليه حتى لو لم يكن ممهوراً باسمه.
وقد كانوا يميزون من خلال هذا المنهج بين شعر وشعر، وشاعر وشاعر، ويعرفون به ما يصح في كلام العرب وما لا يصح، ويضعون أيديهم على شعر شاعر بعينه من بين عدة شعراء؛ فلا يخفاهم نسقه وأسلوبه وطريقته، والأمثلة على مثل هذا في دواوين العربية القديمة كثيرة، ومن ذلك ما رواه الأصفهاني في الأغاني حين ذكر أن الهجاء كان قد لَجَّ بين ذي الرمة وهشام المرئي” وكان ذو الرمة مستعلياً هشاماً حتى لقي جريرٌ هشاماً، فقال جرير: غلبك العبد، يعني ذا الرمة، قال هشام: فما أصنع يا أبا حزرة وأنا راجز وهو يقصد والرجز لا يقوم للقصيد في الهجاء ولو رفدتني، فقال جرير- لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق عليه- قل له:
غضبت لرجل من عدي تشمسوا وفي أي يوم لم تشمس رجالها
وفيم عـدي عنـد تيم من العلا وأيامنـا الـلاتي تُـعد فعالها
وضبة عمي يا بن جل فلا ترم مساعي قوم ليس منك سجالها
يمـاشي عدي اً لؤمها لا تجنه من الناس ما مست عدياً ظلالها
فقـل لعـدي تستـعن بنسائها عليَّ فـقـد أعيـا عدياً رجالها
أذا الرم قـد قلدتَ قومك رمة بطيـئاً بـأمر المطلقين انحلالها
فلما بلغت الأبيات ذا الرمة قال: والله ما هذا بكلام هشام ولكنه كلام ابن الأتان. يعني جريراً.. ثم إن ذا الرمة لقي جريراً بعد ذلك وعاتبه على إرفاده للمرئي رغم القرابة التي بينهما وتبرأ أمامه من تفضيل الفرزدق عليه حتى رضي، ثم استنشده جريرٌ بعض شعره في المرئي فأنشده، فقال جرير: ما صنعتَ شيئاً، أفأرفدك؟ قال: نعم، قال: قل:
يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا
يعدون الرباب وآل سعد وعمراً ثم حنظلة الخيارا
ويهلك بينها المرئي لغواً كما ألغيت في الدية الحوارا
فغلبه ذو الرمة بها، ثم إن ذا الرمة مر بالفرزدق فقال له: أنشدني أحدث ما قلت في المرئي؛ فأنشده قصيدته وفيها الأبيات السابقة؛ فأطرق الفرزدق ساعة ثم قال: أعد، فأعاد؛ فقال: كذبت وأيم الله ما هذا لك ولقد قاله أشد لحيين منك وما هذا إلا شعر ابن الأتان.([1])
فانظر إلى تذوق ذي الرمة شعرَ جرير في شعرِ هشام المرئي ومعرفته به لاختلاف النمطين والأسلوبين، ثم انظر إلى تذوق الفرزدق شعرَ جرير أيضاً في شعر ذي الرمة واكتشافه صورة جرير وصوته ومذهبه في هذه الأبيات القلائل، وقس على هذا ما رده علماء العربية من الشعر إلى أصحابه أو أسقطوه ونفوه عمن ادعاه في قضايا عدة ، كالانتحال والسرقات الشعرية وشعر الجن وشعر آدم والشعر المنسوب إلى عاد وثمود وجسم وجديس وتلك الأمم الغابرة. بل إن هذا المنهج المركوز في نفوس العرب هو الذي ألجمهم عن أن ينسبوا القرآن الكريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ودفعهم إلى الإيمان بنبوته لِمَا جُبلت عليه طبائعهم من تذوق الكلام الذي أوصلهم لليقين بأن هذا القرآن الذي يتلوه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال أن يكون كلام بشر.
أطوار منهج التذوق في المدونات العربية:
وقد استمر هذا الذوق الفطري الخالي- غالباً- من التعليل حتى جاء عصر التدوين فظهرت تباعاً تلك الشروط والقواعد والأصول التي استنبطها الشيخ محمود شاكر في تطبيقات النقاد والأدباء العرب، ومثلت بعض مؤلفات الأدباء والنقاد العرب قديماً علامات مفصلية في مراحل تطور هذا المنهج وتدرجه، ككتابات ابن سلام، وابن قتيبة، والآمدي، والقاضي الجرجاني، وعبد القاهر الجرجاني.
وقد حام ابن سلام في كتابه (طبقات فحول الشعراء) الذي يُعدُّ من أقدم وثائق النقد المدونة حول مفهوم منهج التذوق وإن لم يُسَمِّه، وذلك حين أرجع البَتَّ في صحة نسبة الشعر ومعرفة جيده ورديئه إلى أهل الاختصاص من النقاد والعلماء؛ فأكد في غير موضع من كتابه على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم، وعدم الاعتداد بكلام غيرهم من الصُحفيين، مستشهداً في ذلك برد خلف الأحمر حين قال له قائل:” إذا سمعتُ أنا بالشعر أستحسنُهُ فما أبالى ما قلتَ أنت فيه وأصحابك؛ فقال خلف: إذا أخذتَ درهماً فاستحسنته فقال لك الصَّرَّاف: إنه ردئ فهل ينفعك استحسانُك إيّاهُ.”([2])، وكذلك إشارته إلى الأخطاء التي تصدر عن غير المختصين الذين يتصدون للشعر وروايته في مثل قوله:” وجدنا رواة العِلم يغلطون في الشعر ولا يضبط الشعر إلا أهله.”([3])، ثم ذكر الشروط الواجب توافرها في الناقد فشدَّد على أهمية الذوق والاستعداد الفطرى وبيّن أثر الدربة والممارسة في العملية النقدية؛ فقال:” وللشعر صَناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصَّناعات، منها ما تَثْقَفهُ العين ومنها ما تَثْقَفهُ الأُذن ومنها ما تَثْقَفه اليد ومنها ما يَثْقَفه اللسان، من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجَهْبَذَةُ بالدينار والدرهم لا تُعرَف جَوْدتُهما بلونٍ ولا مَسٍّ ولا طِرَازٍ ولا وَسْمٍ ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة”.([4])

ثم خطا هذا المنهج خطوة أخرى مع ابن قتيبة في كتابه (الشعر والشعراء)؛ وذلك حين قسم الشعر- معتمداً على لفظه ومعناه اللذين لا يخرجان عن مفهوم التذوق- إلى أربعة أضرب: ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب حسن لفظه وحلا فإذا فتشته لم تجد هناك طائلاً، وضرب جاد معناه وقصرت الألفاظ عنه، وضرب تأخر لفظه وتأخر معناه.([5])، ثم في حديثه عن المتكلف من الشعر والمطبوع من الشعراء، وتعريفه للمتكلف بأنه الذي نزل بصاحبه من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعاني حاجة إليه وزيادة ما بالمعاني غنى عنه، أو أن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره ومضموماً إلى غير لفقه. وأما المطبوع من الشعراء فهو الذي سمح بالشعر واقتدر على القوافي وأراك في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته، وتبينت في شعره رونق الطبع ووشي الغريزة، وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحّرْ.([6])
والشعراء في الطبع- كما يرى- مختلفون؛ فمنهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من تتيسر له المراثي، ويعسر عليه الغزل، ولما قيل للعجاج إنك لا تحسن الهجاء قال: هل رأيت بانياً لا يحسن الهدم!! ويرد ابن قتيبة على قول العجاج مبيناً خطأه؛ لأن المديح بناء والهجاء بناء، وليس كل بانٍ بضرب بانياً بغيره، فذو الرمة مثلاً أحسن الناس تشبيهاً وأجودهم تشبيباً وأوصفهم لرمل وهاجرة… فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع، وكان الفرزدق زير نساء وصاحب غزل، وكان مع ذلك لا يجيد التشبيب، وكان جرير عفيفاً عن النساء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيباً، وكان الفرزدق يقول:” ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري، وما أحوجني إلى رقة شعره”.([7])
وغني عن البيان أن هذه النظرات النقدية إنما مردها إلى التذوق بدايةً ، رغم ما أُخذ على ابن قتيبة من تقريرية في تقسيم الشعر وسيطرة للروح العلمية على نقده أحياناً، إلا أن هذه السيطرة للروح العلمية عنده كانت صائبة في دعوتها إلى تحكيم النظر الشخصي والاستقلال بالرأي وتقدير الأشياء في ذاتها، ورفضه قبول القديم دائماً لقدمه ورفضه رد الحديث أبداً لحداثته، وقد وفق في هذه النزعة أكثر من توفيقه في النقد ذاته، ولعل ضعف النقد عنده يرجع إلى غلبة تفكيره على حسه الأدبي فهو أقرب إلى التوجيه من النقد وإلى تقعيد القواعد من تطبيقها. وقد سعى إلى طرح الأحكام التقليدية ورأى أن تستمر دراسة النصوص الأدبية القديمة الجيدة حتى إذا تكوّن الذوق الشخصي لطول الممارسة حكمناه فيما نقرأ وصدرنا عنه. وكان له فضل كبير في إيقاف طغيان التيارات الجديدة التي اعتمدت منطق اليونان وفلسفتها في نقد الشعر فوقف في وجهها وسفهها ورفضها وأعاد للتذوق الأدبي قيمته المعتبرة، وإن لم يكن أقام مكان ما رفضه نظرية متكاملة.([8])
الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي:
أما التحول الكبير الذي طرأ على هذا المنهج الأصيل دون أن يفقد جذوره الثابتة وخصائصه الأولية فقد جاء علي يد أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيي الآمدي في كتابه (الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري)، وقد خطا فيه خطوات واسعة قاربت التقعيد العلمي والتأصيل المنهجي اللذين نراهما في عصرنا الحديث عند أساطين علماء المناهج عرباً كانوا أم أوربيين؛ فلا نكاد نجد شرطاً من شروط المنهج التي وضعها الشيخ محمود شاكر إلا وقد تحقق في هذا الكتاب؛ من جمع للمادة من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، إلى تصنيف المجموع تصنيفاً يوائم بين أجزائه ويلائم بين متنافره، إلى تمحيص مفردات المجموع تمحيصاً دقيقاً، إلى تحليل أجزاء المجموع الذي تم تمحيصه بدقة ومهارة وحذق وحذر، إلى ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدِّها، إلى استيعاب احتمالات الخطأ أو الهوى أو التسرع، إلى تحري الدقة في وضع كل حقيقة من الحقائق في موضع هو حق موضعها.
ونستطيع أن نلمح كل هذه الشروط واضحة في كتابه من المقدمة إلى الخاتمة لا يكاد يُسقط منها شرطاً إن لم يزد عليها شروطاً؛ فهو في مقدمته يأخذ نفسه بالموضوعية والمحايدة واعتماد الحق وعدم اتباع الهوى؛ فيذكر حجج الفريقين وعلل تفضيلهما لكلا الشاعرين؛ فمن فضل أبا تمام فقد” نسبه إلى غموض المعاني ودقتها، وكثرة ما يورده مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام”([9])، ومن فضّل البحتري فقد” نسبه إلى حلاوة اللفظ وحسن التخلّص ووضع الكلام في مواضعه وصحة العبارة وقرب المأتى وانكشاف المعاني، وهم الكتّاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة.”([10]). كما يذكر أن هناك من ساوى بين الشاعرين وجعلهما في طبقة واحدة، وأن هناك من خالف بينهما من حيث الالتزام بعمود الشعر، ثم يعلن اختلاف مذاهب الناس في الشعر مبدياً توقفه عن تفضيل شاعر بعينه على الآخر تاركاً الحكم للمتلقي المتذوق بعد أن يقرأ موازنته بين الشاعرين في قصيدتين لهما متفقتين وزناً وقافية وإعراب قافية، أو معنيين جديدين لهما، ويخاطب القارئ بعد ذلك بقوله:” ثم أحكم أنت حينئذ على جملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علماً بالجيد والرديء.”([11])، ثم يستشف موقف القارئ وحكمه من خلال ميله وذوقه؛ فيقول له:” فإن كنت ممن يفضّل سهل الكلام وقريبه ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق؛ فالبحتري أشعر عندك ضرورة، وإن كنت تميل إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على ما سوى ذلك؛ فأبو تمام عندك أشعر لا محالة”.([12])
وقد قسم كتابه إلى جملة أقسام: المحاجّة بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتري، ثم مساوئ الشاعرين، ثم محاسن الشاعرين، الموازنة بين معنى ومعنى، مقدماً لكل هذه المحاور بمقدمات مفصلة تحتوي على ما يناسب الموضوع من استشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر وأقوال الرواة وعلماء اللغة، وابتدأ بذكر حجج الفريقين ثم مساوئ أبي تمام وسرقاته وأخطائه، ثم مساوئ البحتري وأخطائه، ثم محاسن الشاعرين ومميزاتهما وخصائصهما وما قيل فيهما إنصافاً من الفريق المضاد لهما.. وحين وجد الآمدي نفسه غير متمكّن من الموازنة بين قصيدتين للشاعرين اتفقتا في الوزن والقافية والروي- وهو الأمر الذي أخذ به نفسه من البداية- اضطر إلى أن يوازن بين معنى ومعنى”.([13])
وقد ظهر في موازنة الآمدي بين الشاعرين في هذه المعاني تفضيل أبي تمام في بعضها، ثم تفضيل البحتري في أغلبها، ولكنه حين أحس بميله إلى البحتري- وكان قد ألزم نفسه بترك الرأي للقارئ- قال:” بالله استعين على مجاهدة النفس ومخالفة الهوى وترك التحامل؛ فإنه جل اسمه حسبي ونعم الوكيل”.([14])
وواضح مما سبق أن التذوق عند الآمدي قد تحول إلى منهج ذي أسس وأصول وإجراءات قوامها التعليل والتفصيل والتحرز وضرب المثال؛ لأنه إنما يعرض الحجج والآراء على عقول الناس وأذواقهم، والعارض- في حالة كهذه- لا بد له من تفسير عرضه وتفصيله وجمع جوانبه وضم أجزائه ولَمِّ شتاته، دون أن يتورط في إطلاق أحكام عامة كتلك الأحكام التي نقرؤها في كتب التراث الأدبي عن أغزل بيت وأمدح بيت وأفخر بيت وأرثى بيت؛ فهو إذن رجل منصف دارس محقق لا يقبل شيئاً بغير بينة ولا يقدم حكماً بغير دليل، وواضح أيضاً أن (المنهج) على يديه قد قام على أمرين: المعرفة والتذوق، وهذا التذوق تم له بعد أن ألمَّ إلماماً واسعاً بعلوم عصره العربية والأجنبية، يقول الدكتور محمد مندور:” وهو فيما يبدو لم يكن يجهل شيئاً لا من علوم العربية وآدابها التقليدية فحسب بل ولا من العلوم الفلسفية المستحدثة، وإن تكن العلوم لم تبهره ولا ضللت أحكامه عن الشعر والأدب، وعنده- كما رأينا- أن أساس كل نقد صحيح هو الذوق فمن حُرمه لا يمكن أن يستعيض عنه بأي شيء آخر”.([15])
وهذا الذوق الذي هو في ذاته مَلَكةٌ مستقلة لا بد أن يُدرب- بحسب رأي الآمدي- على صناعة النقد تدريباً طويلاً، ولا يكفي أن يحفظ المرء القصائد الطوال ويعرف أصول اللغة ليكون ناقداً كما وَهِمَ الصولي، أو يدرس فلسفة أرسطو وتشقيقاته فيصلح لأن يكتب كتاباً عن نقد الشعر كما فعل قدامة بن جعفر؛ فالشعر ليس علماً وإن كان العلم من أدواته، وليس فلسفةً وإن كان جمال الصياغة يرفع الفلسفة إلى مستوى الشعر، وهو في تركيزه على الذوق يرى أن المعنى اللطيف حين لا تُحسن صياغته يكون مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق أو نفث العبير على خد الجارية القبيحة الوجه، وأن حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف المتداول بهاءً وحسناً ورونقاً وغرابة وزيادة لم تعهد فيه، وهذا- كما يذكر محمد مندور-” هو رأي معظم نقاد أوروبا اليوم الذين يرون أن أمر المعاني في الشعر ثانوي بالنسبة إلى الصياغة”.([16])
دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني:

استطاع الإمام عبد القاهر الجرجاني أن ينقل هذا المنهج إلى البلاغة محاولاً وضع قواعد فنية للبلاغة العربية من خلال اعتماده على الجمال الفني وحسن التذوق؛ فأطلق نظريته الشهيرة بـ(نظرية النظم) التي سبقه إليها أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم الذي ألف كتابا سماه (إعجاز القرآن في نظمه)، غير أن الجرجاني كان هو الذي بسط القول فيها وأقام على أساسها فلسفة كتابه (دلائل الإعجاز) متأثراً بنشوب الصراع الذي أثاره امتزاج الثقافات وتعصب المتأثرين بالفلسفة اليونانية لها ودفاع مفكري العربية وعلمائها عن تراثهم وثقافتهم، ومنها الثقافة النحوية. ولعل أوضح مثال لهذا الصراع تلك المناظرة الحادة التي قامت بين الحسن بن عبد الله المرزباني المعروف بأبي سعيد السيرافي وبين أبي بشر متى بن يونس في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات.[17]
وخلاصة نظرية النظم” أن ترتيب المعاني في الذهن هو الذي يقتضي ترتيب الألفاظ في العبارة، وأن اللفظ لا مزية له في ذاته وإنما مزيته في تناسق معناه مع معنى اللفظ الذي يجاوره في النظم.. وأن الجمال الفني رهينٌ بحسن النسق وحسن النظم، كما أنه لا اللفظ منفرداً موضع حكم أدبي، ولا المعنى قبل أن يُعبر عنه في لفظ، وإنما هما باجتماعهما في نظم يكونان موضع استحسان أو استهجان.”([18])؛ فالنظم عند الجرجاني هو:” تعليق الكلم بعضها ببعضٍ وجعل بعضها بسببٍ من بعض.”([19])، فـ”لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض, ويُبنى بعضها على بعض وتُجعل هذه بسبب من تلك.”([20])، وأن الألفاظ” لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها، في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها.”([21])؛ لأنك لا تجد أحداً يقول:”هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها”.([22])
فاستحسان عبد القاهر للفظ مشروط بحسن تلاؤم معنى اللفظة مع معنى الألفاظ المجاورة لها، ومراعاة ترتيب المعاني في النفس ثم اختيار الألفاظ الدالة عليها،” فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم؛ لما اختلف بها الحال ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً”.([23])
غير أن المعنى يكتسب عند عبد القاهر أهمية كبيرة من حيث هو أساس للفظ واللفظ رداءٌ له، ولأن الألفاظ صورة صوتية تحمل المعاني ورموز تُحركها داخل الذهن، وهي مرتبة في نفس المتكلم حسب ترتيب المعاني، فإن تبدلت المعاني أو اضطربت في الذهن والتفكير؛ تبدلت الألفاظ واضطربت تبعاً لتبدل المعاني واضطرابها، ومن هنا جاءت الصلة الداخلية والتلاحم المستكن بين المعنى الدائر في النفس وبين اللفظ المناسب له؛ فالكاتب حين يكتب والشاعر حين ينظم لا يفكر في الألفاظ ولا يطلبها بحال، وإنما يطلب المعنى فتجيء ألفاظه على قدر ما طلبه من معانٍ؛ لأن عملية التفكير بالمعنى سابقة على عملية التفكير باللفظ؛ ولذلك يقول عبد القاهر:”.. وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكرة هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من عملية ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها”.([24])
وقد كان لعبد القاهر ونظريته فضل كبير في الدراسات اللغوية، وربط منهج التذوق معنى ولفظاً باللغة وتراكيبها؛ فهو في تعريفه الأساس لنظرية النظم يؤكد على أن النظم هو: وضع الكلام في الوضع الذي يقتضيه علم النحو، فليس المهم في اللغة الألفاظ مجردةً بل المهم هو الصلة بين هذه الألفاظ وما تقوم عليها، ولا تقوم اللغة إلا على العلاقة التركيبية بين الألفاظ وليس على الألفاظ المجردة. وكأنه يقصد بالنظم من خلال تعريفه هذا ما يطلق عليه الغربيون اليوم علم التراكيب (syntaxe)، وهو عندهم أهم أجزاء النحو.([25])
وقد لفت الدكتور محمد مندور الانتباه إلى هذه الأسس اللغوية لمنهج الجرجاني مبيناً أن هذه الأسس هي أحدث ما وصل إليه علم اللغة في أوربا على يد العالم السويسري فردناند دي سوسير، وموضحاً سبق الجرجاني له بمئات السنين في التركيز على الفكرة القائلة بأن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات( système de rapports )، وعلى هذا الأساس العام بنى عبد القاهر كل تفكيره اللغوي الفني”.([26])
إلا أن بعض النقاد أخذ على عبد القاهر الجرجاني إغفاله- في غمرة تأسيسه لمحورية المعنى- للجانب الصوتي من اللفظ مفرداً ومجتمعاً من خلال الإيقاع الموسيقي والظلال الفنية التي تكتنف اللفظ في ذاته دون النظر إلى نظمه في العبارة أو نسقه في الجملة ([27])، وكان الدافع إلى هذا المأخذ عند البعض أن النظرية التي جاء بها الجرجاني جاءت مكتملة وسابقة لعصرها ومؤسسة لمجموعة من النظريات المنبثقة عنها، ولا يصح بحال أن يغفل الجرجاني رغم هذا الاكتمال جانباً مهماً يمثل إغفاله نقصاً في هذه النظرية، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد زكي العشماوي بقوله:” لا ينبغي أن نكتفي في منهج لغوي كهذا بالإشارة إلى هذا الجانب مجرد إشارة، بل إن الموقف كان يحتم على عبد القاهر أن يكثف علاقة الأصوات باللغة ووظيفتها في أداء المعنى، وعلى الأخص أنه متهم- لفرط حماسته وغيرته على تأكيد الوحدة بين اللفظ والمعنى- بإغفاله جانب اللفظ وإنكاره لقيمته من حيث هو صوت مسموع، ومع إيماننا بأن اللفظ المفرد لا يكتسب قيمته الصوتية أو الشعورية إلا إذا جاء في شكل سياق، إلا أننا لا نذهب إلى إنكار قيمته الصوتية في الشعر جملة، كما أننا لا ينبغي أن نكتفي بمجرد الإشارة إلى أن الصوت جزء من المعنى بل ينبغي أن نحدد طبيعة العلاقات الإيجابية بين الأصوات ومعانيها”.([28])
بيد أن هذا المأخذ في النظرية لا يمثل نقصاً مؤثراً فيها؛ لأن الجرجاني إنما كان يدرس بلاغة الكلام من حيث علاقاته اللغوية وارتباطاته النحوية من خلال قضية إعجاز القرآن الكريم الذي تَمَثَّلَ في نظمه ونسقه، وليس في لفظه منفرداً أو في معناه منفرداً، وكان هدفه الأساس هو رد آراء القاضي عبد الجبار المعتزلي عن جزالة اللفظ وحسن المعنى، وعن الوجوه التي يقع بها التفاضل في فصاحة الكلام، وأن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، وأن المعاني لا يقع فيها التزايد، وغير ذلك من آراء المعتزلة في قضية إعجاز القرآن التي ضمها كتاب (المغني) للقاضي عبد الجبار، وردها الجرجاني دون أن يشير إلى صاحبها لشهرته آنذاك وشهرة آرائه.([29])
وسيكون من نافلة القول بعد هذا الرصد المختصر لأطوار منهج التذوق في كتابات العلماء والأدباء العرب أن نشير إلى أن غالب من ألف وكتب في العربية والأدب العربي كان يتكأ في دراساته الأدبية واللغوية على أساس من منهج التذوق الذي هو ألصق شئ بالعرب كجنس، وألصق شيء بالأدب العربي كتراث، حتى كأن اللغة العربية نفسها تذوقية بحتة، تظهر ألفاظها بمعانيها في أشكال وهيئات تكاد تكون محسوسة وملموسة تصوراً وخيالاً.
منهج التذوق في العصر الحديث:
وقد عاد هذا المنهج العربي الأصيل إلى الظهور بقوة- رغم المعوقات التغريبية التي واجهته- في العصر الحديث مع بداية ظهور تيارات التأصيل في الأدب العربي على يد فريقين من النقاد:
فريق التزم التزاماً كاملاً بالأصالة العربية واعتمد عليها في تجديد هذا المنهج وإعادة صياغته من جديد، أمثال: حسين المرصفي، ومصطفى صادق الرافعي، ومحمود شاكر.
وفريق تأثر تأثراً واضحاً بالمثاقفة السلبية أو الإيجابية مع الغرب ثم عاد إلى المنهج الأصيل مع انتقال الانطباعية الغربية إلى النقد العربي بمسميات مختلفة (كالتأثرية أو الذاتية أو الانفعالية)، وقد اعتبر بعضُ الباحثين طه حسين رائداً للنقد الانطباعي التذوقي في العصر الحديث، رغم التحامه الواضح بالمنهج التاريخي؛ لأنه أدرك- كما يرى هؤلاء- أن طبيعة النص الأدبي ليست في يد المؤرخ، وأن الحضور الانطباعي ضرورة يقتضيها النقص الذي يواجه الناقد/المؤرخ.([30])
وبمثل ذلك يؤمن تلميذه الدكتور محمد مندور الذي تظل (الانطباعية التذوقية) عنده هي الثابت النقدي الكبير في تحولاته المنهجية المختلفة لاعتقاده أن” المنهج التأثري الذي يسخر منه اليوم بعض الجهلاء ويظنونه منهجاً بدائياً عتيقاً بالياً لا يزال قائماً وضرورياً وبديهياً في كل نقد أدبي سليم، ما دام الأدب كله لا يمكن أن يتحول إلى معادلات رياضية أو إلى أحجام تقاس بالمتر والسنتي، أو توزن بالغرام والدرهم”.([31])
ويتضح اهتمام مندور بهذا المنهج والمنافحة عنه من خلال المعركة الأدبية التي نشبت بينه وبين الدكتور زكي نجيب محمود حين اختلفا في قيام النقد على الذوق أم على العلم؟ فبينما يرى مندور أن النقد ليس علماً وما ينبغي أن يكون، وأن قوام النقد ومرجعه كله إلى التذوق، وأن للذوق الشخصي الكلمة العليا في نقد الفنون، وأن الذوق المقصود هو الذوق المدرب المصقول بطول الدربة والممارسة؛ أي الذوق المعلل في حدود الممكن؛ كان زكي نجيب محمود يرى أن النقد علم، والعلم عنده هو منهج البحث؛ أي مجموعة القوانين التي تفسر الظواهر، ومرجعه إلى العقل لا الذوق، وأن الاحتكام المطلق إلى الذوق هو إشاعة للفوضى النقدية؛ فالقارئ الذي سيصبح ناقداً إنما يقرأ القراءة الأولى فلا يسعه إلا أن يحب ما قرأه أو يكرهه، ثم يهم بالكتابة ليوضح وجهة نظره، أي ليعلل رأيه، والتعليل عملية عقلية؛ لأنه رد الظواهر إلى أسبابها، ومعنى ذلك أن الذوق خطوة أولى تسبق النقد، وليس هو النقد، إذ النقد يجيء تعليلاً له؛ فهناك إذن مرحلتان: مرحلة أولى يميزها ذوق يختار ما يقرأ لا يتجاوز دوره إعداد المادة الخام للعملية النقدية، ومرحلة ثانية يميزها العقل والمنهجية العلمية التي تحلل وتعلل وتفسر وتستعين بكل ما أمكن من علوم.
وبعد نحو ستة عشر عاماً من تلك المعركة بين الناقدين رأينا محمد مندور يميز- في نطاق النقد التأثري الانطباعي- بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة (الذوق الفردي)، ثم مرحلة (التبرير والتفسير الموضوعي) معرباً عن أن الناقد الذي يقف على عتبة المرحلة التأثرية مكتفياً بأن يقول: هذا جميل وذاك قبيح، وهذا أسود وذاك أبيض، فإنه في الحقيقة لا يعتبر عندئذ ناقداً على الإطلاق بل يعتبر معتوهاً أو مستهتراً لا يعبأ بما يقوله أحد ولا ينبغي أن يعبأ”. وقد عاود الإعراب عن القناعة ذاتها في كتابه المتأخر (معارك أدبية) والذي يقول فيه:” والنقد التأثري لا زلت أعتقد أنه الأساس الذي يجب أن يقوم عليه كل نقد سليم، وذلك لأننا لا يمكن أن ندرك القيم الجمالية في الأدب بأي تحليل موضوعي ولا بتطبيق أية أصول أو قواعد تطبيقاً آلياً، وإلا لجاز أن يدعي مدع أنه قد أدرك طعم هذا الشراب أو ذاك بتحليله في المعمل إلى عناصره الأولية، وإنما تدرك الطعوم بالتذوق المباشر، ثم نستعين بعد ذلك بالتحليل والقواعد والأصول في محاولة تفسير هذه الطعوم وتعليل حلاوتها أو مرارتها على نحو يعين الغير على تذوقها والخروج بنتيجة مماثلة للنتيجة التي خرج بها الناقد بفضل ملكته التذوقية المدربة المرهفة السليمة التكوين.”([32])، ثم يختم كلامه بالإشارة إلى أن مذهبه النقدي قد استقر في صورته المنهجية الأخيرة على أساسين اثنين:” أساس إيديولوجي ينظر في المصادر والأهداف وفي أسلوب العلاج، وأساس فني جمالي ينتظم في مرحلتين حاول دائما أن أجمع بينهما في كل نقد تطبيقي أقوم به وهما: المرحلة التأثرية التي أبدأها دائما بأن أقرأ الكتاب المنقود قراءة دقيقة متأنية، لأحاول أن أتبين الانطباعات التي خلفها في نفسي، ثم مرحلة التعليل والتفسير، وهي المرحلة التي أحاول فيها تفسير انطباعاتي وتبريرها بحجج جمالية وفنية يمكن أن يقبلها الغير وأن تهديه إلى الإحساس بمثل ما أحسست به عند قراءتي للكتاب المنقود.”([33])، وواضحٌ أن هذا الكلام من مندور هو رجوع إلى رأي زكي نجيب محمود عن مراحل النقد ذوقياً وعلمياً.
وكذلك دعا الناقد يحي حقي في مقدمة كتابه: (خطوات في النقد) الجيل الجديد إلى ألا يحطوا على الفن كلاكل نظريات النقد المستوردة التي تخنقه، معرباً عن انتمائه للمنهج التذوقي ورافضاً إثقال الأعمال الأدبية المليئة بالمشاعر والأحاسيس والعواطف بالنظريات والتقسيمات الجافة.([34])
وعليه؛ وإن منهج التذوق هو أكثر المناهج نفاذاً إلى منظومات المناهج الأدبية كلها، ولن نكون مغالين إذا قلنا: إن خصوصية منهج التذوق تكمن في عموميته؛ فهو أكثر المناهج تفاعلاً مع غيره، ولن نجد منهجاً أدبياً إلا احتاج إليه أو اتكأ عليه أو انطلق منه في مرحلة من مراحله
وعليه؛ وإن منهج التذوق هو أكثر المناهج نفاذاً إلى منظومات المناهج الأدبية كلها، ولن نكون مغالين إذا قلنا: إن خصوصية منهج التذوق تكمن في عموميته؛ فهو أكثر المناهج تفاعلاً مع غيره، ولن نجد منهجاً أدبياً إلا احتاج إليه أو اتكأ عليه أو انطلق منه في مرحلة من مراحله؛ فصاحب المنهج التاريخي الذي يستهدف في دراسته معرفة مدى تأثر النص ببيئته والبيئة المحيطة به، ومعرفة مدى تأثر الأدب والأديب بوسطه، ومعرفة الأطوار التي مر بها فن من الفنون الأدبية، ومعرفة الآراء السابقة التي قيلت في النص والموازنة بينها، ومعرفة الخصائص المحيطة بأدب أمة من الأمم، والتوثق من صحة نسبة النص لقائله.. صاحب هذا المنهج لابد أن يبدأ أولاً من التعرف على النص متذوقاً ومحللاً، حتى يستطيع الوصول إلى معرفة كل ما سبق. وصاحب المنهج النفسي الذي يهتم بكيفية العمل الأدبي وتحديد عناصره الشعورية وغير الشعورية، والتعرف على العلاقات النفسية بين موضوع التجربة الشعورية و التغييرات اللفظية، ثم البحث عن الدوافع الداخلية والخارجية التي أدت إلى إنشاء العمل الأدبي، ومعرفة دلالة العمل الأدبي على نفسية الأديب والتطورات التي مر بها وميوله واتجاهاته، ومعرفة الأثر الذي تركه النص في قرائه مع تحديد العلاقة بين النص وتجارب قرائه وتحديد نوع هذا الأثر.. صاحب هذا المنهج لا بد له أيضاً أن يبدأ من النص متذوقاً ومحللاً ليصل إلى معرفة كل ما سبق. وتقاس على ذلك أيضاً بقية المناهج اللغوية والجمالية والاجتماعية وما أحدثته الحداثة من مناهج أسلوبية وبنيوية وتفكيكية؛ فكلها تبدأ من النص وتنتهي به، مع ما في إجراءاتها من تباينات شديدة تكاد توقعها في التضاد والتناقض.
ولهذا؛ فإن منهج التذوق يتعامل مع النص ذاته دون أن يُغفل علاقته بنفس صاحبه أو تفاعله ببيئته تأثراً وتأثيراً ، ولكنه يحتفظ للنص بقيمه الفنية ؛ فلا يغرقها في البحوث التاريخية والدراسات النفسية، ويحتفظ لصاحب النص بشخصيته الذاتية؛ فلا تضيع في غمار الجماعة ومتغيراتها، ويحتفظ للمؤثرات العامة بأثرها في التوجيه والتلوين وليس خلق الموهبة أو في تكوين طبيعة إحساسها بالحياة.([35])
وإذا كان العقل والعاطفة والحس من عناصر التذوق، والبيئة والزمان والجنس والتربية من المؤثرات في التذوق؛ فليس غريباً أن نجد للمنهج التاريخي، وللمنهج الاجتماعي، وللمنهج النفسي، ولمنظومات المناهج اللغوية، بصماتٍ واضحة في منهج التذوق تزيد من فعاليته وقدرته على مواجهة العمل الأدبي، وتُكوِّنُ خواص هذه المناهج وإجراءاتها التطبيقية روافد مهمة تضاف إلى آليات منهج التذوق دون أن تجور على أسسه الثابتة. وما دام الأدب نتاجاً إنسانياً إبداعياً لغوياً فإن على الناقد ألا يهمل أي جانب من الجوانب التي قد تضئ المناطق المظلمة في العمل الأدبي.
وليس معنى هذا أن منهج التذوق منهجٌ تلفيقيٌ توفيقيٌ، أو منهج غائم لا ملامح له، بل معناه أنه منهج يحمل في ذاته خصوصية الانفتاح التكاملي على المناهج الأخرى؛ يؤثر فيها ويتأثر بها؛ فيمنحها الأسس الأولية لمصافحة العمل الأدبي وموضوعاته المختلفة، ويأخذ منها الأدوات الإجرائية التي تصلح لمواجهة الجزئيات التفصيلة في العمل الأدبي.
ولأمرٍ ما كان منهج التذوق بخصوصيته العامة وعموميته الخاصة أكثر المناهج ملائمة لطبيعة اللغة العربية وآدابها؛ لأنه أكثر المناهج انفتاحاً- تأثيراً وتأثراً- على المناهج الأخرى.. وقد ساعدت عودةُ هذا المنهج في العصر الحديث في عودة اللغة العربية وآدابها إلى طبيعتها التذوقية بعد اطلاع الرواد الأوائل في العصر الحديث على ما أخرجته المطابع من كتب التراث العربي عموماً والأدب خصوصاً؛ فجاءت اليقظة اللغوية الأولى عربية خالصة مَثَّلَ قلقُ الرواد الأوائل فيها على حال اللغة والأدب حجر الزاوية في اكتمال بنائها واتضاح أبعادها..
وهذا ما سنعرفه- إن شاء الله- في المقال القادم حين نتناول عوامل يقظة اللغة العربية في العصر الحديث بعد خمولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]ـ الأغاني ـ أبو الفرج الأصفهاني ـ تحقيق : سمير جابر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط2 ـ ج 18 ـ ص 23 ـ 24
[2]ـ طبقات فحول الشعراء 1 ــ 7 .
[3]ـ طبقات فحول الشعراء ـ 1 ـ 60 .
[4] ـ طبقات فحول الشعراء ـ ابن سلام 1ـ 5 .
[5]ـ الشعر والشعراء ـ ابن قتيبة ـ تحقيق : د. مفيد قميحة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت1985م ـ ط2 ـ ص7ـ9 .
[6] ـ الشعر والشعراء ـ ابن قتيبة ـ ص26 .
[7] ـ الشعر والشعراء ـ ابن قتيبة ـ ص 28ـ29 .
[8] ـ النقد المنهجي عند العرب ـ محمد مندور ـ ص 48 .
[9] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص 6
[10] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص 6 .
[11] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص7 .
[12] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص7 .
[13] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص 405
[14] ـ الموازنة ـ الآمدي ـ ص405
[15] ـ النقد المنهجي عند العرب ـ محمد مندور ـ ص 119 .
[16] ـ النقد المنهجي عند العرب ـ محمد مندور ـ ص 122 .
[17] ـ البيان العربي ـ د.بدوي طبانة ـ دار العودة ـ بيروت ـ ط5 ـ ص165-166 .
[18] ـ النقد الأدبي ـ سيد قطب ـ مرجع سابق ـ ص 143 .
[19] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ قرأه : محمود شاكر ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة1989م ـ ص77.
[20] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ص13.
[21] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ص59.
[22] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ص53 .
[23] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ص55.
[24] ـ دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني ـ ص59 .
[25] ـالنقد الأدبي الحديث ـ محمد غنيمي هلال ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ ص 277 .
[26] ـ في الميزان الجديد ـ محمد مندور ـ مكتبة نهضة مصر ـ ط3 ـ ص 175 .
[27] ـ النقد الأدبي ـ سيد قطب ـ ص145 .
[28] ـ قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث ـ د.محمد زكي العشماوي ـ ص305
[29] ـ انظر: مقدمة الشيخ محمود شاكر لكتاب دلائل الإعجاز ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة 2004 ـ ط5
[30] ـ انظر : المرايا المتجاورة ، دراسة في نقد طه حسين ـ جابر عصفور ـ دار قباء للطباعة والنشر ـ 1998م ـ ط1 .
[31]ـ في الميزان الجديد ـ محمد مندور ـ مكتبة نهضة مصر ـ القاهرة ـ ص 70.
[32] ـ معارك أدبية ـ محمد مندور ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة 2009م ـ ط2 ـ ص 32 .
[33] ـ معارك أدبية ـ محمد مندور ـ ص 40 .
[34] ـ خطوات في النقد ـ يحي حقي ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة 2008م ــ ط1 ـ ص 5 .
[35] ـ النقد الأدبي ـ سيد قطب ـ ص255 ـ 256 .