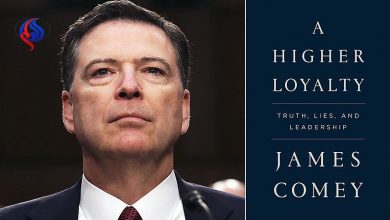1-مقدمة:
في ظل ما يشهده العالم الإسلامي من مدافعات متسارعة وتحولات جذرية على المستويين الفكري والسياسي، وفي زمنٍ تتكثف فيه العواصف التي تستهدف هُوية الأُمَّة وتعيد صياغة وعيها الجمعي تحت تأثير القوة الصلبة حينًا والناعمة حينًا آخر، بات من الضروري أن يعيد الفاعلون في الحقل الإسلامي النظر في أدواتهم، واستراتيجيات خطابهم، وعلاقة دعوتهم بمسارات التأثير السياسي.
ولا يخفى أن مشهد طوفان الأقصى، بتجلياته المتنوعة، شكّل لحظة فارقة في وعي الأمة، ودقّ ناقوسًا ينذر بأن المشروع الإسلامي بكل روافده الفكرية والدعوية بحاجة إلى مراجعة جادة، تُعيد ضبط البوصلة وتُحصِّن الخطاب من التشوش والانحراف.
من هذا المنطلق، عقد مركز رؤيا للبحوث والدراسات حلقة نقاشية علمية بعنوان: “العمل الإسلامي وآفاق المستقبل”، حضرها عدد من المشتغلين بالعلم والدعوة والفكر والسياسة، للوقوف عند أهم التحديات التي تواجه العمل الإسلامي، واستشراف ملامح المستقبل في ظل هذه المعطيات المتشابكة.
وقد نوقشت هذه المحاور عبر عدة أوراق بحثية تناولت بعمق محددات العلاقة بين الدعوة والسياسة في ضوء التجارب الإسلامية المعاصرة، ومعالم التجديد في الخطاب الإسلامي ومتطلبات النهوض به، بالإضافة إلى الإشكاليات المنهجية التي تواجه العمل الإسلامي في ظل التحولات الجيوسياسية والإعلامية الراهنة.
وقد سبقت عرض هذه المحاور مقدمة توضيحية بيّنت أهم المداخل النظرية الجامعة التي ينبغي أن يستند إليها النظر في واقع العمل الإسلامي واستشراف مستقبله بما يُعزّز مناعة الأمة الفكرية ويستأنف دورها الرسالي في عالم يموج بالفوضى والمراجعات العميقة.
الورقة الأولى: مداخل نظرية جامعة للعمل الإسلامي:
أولًا– منظومة الفعل المتكاملة في عالم الإسلام والمسلمين:
تناولت الورقة الأولى في البداية الحديث عما تفرضه اللحظات الفرقانية في غزة وسوريا من مراجعة شاملة لمسار العمل الإسلامي، بما يفضي إلى بناء منظومة فعل متكاملة تجمع الدعوة والسياسة والمقاومة والفكر في عمل منسق وواعٍ، فالمعركة واحدة، والتحديات مترابطة، ولا سبيل للنهوض إلا بتكامل الجهود على أساس مرجعي موحّد، يعيد للأمة فاعليتها.
ثانيًا: التفكير في المستقبل:
يدعونا قوله تعالى: {وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} إلى المراجعة الذاتية وتأمل المستقبل بعين المسؤولية لا التوقُّع المجرد، غير أن اعتماد منهج “السيناريوهات” وخاصة بطريقة “القسمة العقلية” قد يقيِّد التفكير، ويجعل العقل أسير الاحتمالات المحدَّدة سلفًا، بينما الإبداع يحتاج إلى فضاء أرحب يتجاوز الحسابات الجامدة إلى الرؤية الملهمة والبصيرة الرسالية.
ولا بد من الموازنة بين النظر في السيناريوهات كوسيلة تحليلية، وبين الإبقاء على مساحة الاجتهاد والتجديد، فالتعامل معها مسألة تقديرية لا ينبغي أن تُحجر على العقول، فالسيناريوهات ليست قوالب جامدة، بل أدوات تتأثر بالمتغيرات المتسارعة، وينبغي ألا نُغفل “السيناريو المرغوب” أو “الواجب“، والذي يرتبط بالواجب الكلي للأمة، فعملنا الإسلامي اليوم في أمسّ الحاجة لاجتماع الهمم على واجب الوقت، وتوجيه الطاقات نحو مشروع جامع يستشرف المستقبل بعقلٍ مؤمن، وبصيرة نافذة، وإرادة جماعية لا تعرف الوهن.
ثالثًا: مُهماتٌ عشرٌ للعمل الإسلامي:
1- المهمة المتعلقة بعالم المفاهيم:
أُولى مهمَّات العمل الإسلامي اليوم هي تصحيح الإدراك واستعادة المفاهيم الإسلامية المختطفة، وفي مقدمتها مفاهيم الجهاد، والمقاومة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحضارة وغيرها، فلقد شُوّهت كثيرٌ من المفاهيم بفعل الغزو الثقافي والاستعمالات السياسية المنحرفة، فكان لزامًا على العمل الإسلامي أن يبادر إلى غربلتها وردّها إلى نصوص الوحي وروح الشريعة، لتكون منارات وعي وربطها بطوفان الأقصى والثورة السورية كفرص يمكن تعظيمها والاستفادة منها في هذا السياق.
2- المهمة المتعلقة بأدوات الضغط:
العمل الإسلامي مطالب بصناعة حالة ضاغطة تُحرّك الواقع ولا تكتفي بردود الأفعال، تُمارَس على النظم الاستبدادية الحاكمة، وعلى العلماء الرسميين المرتبطين بالسلطة الذين باتوا يُلبسون الباطل لبوس الحق، وذلك بدون الارتهان بالمفهوم الغربي للضغط السياسي، فينبغي تطوير أدوات ضغط تستمد مشروعيتها من الوحي، وتُعبّر عن وعيٍ جماهيري يفرض كلمته ويُعيد التوازن إلى معادلة القوة في المجتمعات.
ويتحقق ذلك من خلال بناء “جماعة ضاغطة” فاعلة، تتكوّن أولًا من جماعة علمائية مستقلة ناطقة بالحق، وثانيًا بالقدرة على الحشد والتعبئة الجماهيرية الواعية، وثالثًا عبر تحريك المفاصل الحية في الأمة من نقابات واتحادات وهيئات مستقلة، ورابعًا من خلال استثمار الوسائط الحاضنة كوسائل التواصل والفضاء الرقمي، وخامسًا ببناء خطة استراتيجية بخطاب تواصلي مؤثر يربط الرسالة بالواقع، ويعبّر عن ضمير الأمة بلغة قريبة وأسلوب جامع.
3- المهمة المتعلقة بساحة الحاضنة الشعبية:
الحاضنة الشعبية هي الساحة الكبرى التي تُمدّ الفاعل الإسلامي والمقاوم بعمقه الحيوي وشرعيته الجماهيرية.
فالأمة هي الحاضن الأكبر للمشروع الإسلامي، بما تملكه من طاقات إيمانية وتاريخية وشعبية، وتشمل في داخلها حواضن فرعية متعددة وهي حواضن يمكن استنهاضها وتفعيلها بمشروع تواصلي واعٍ، يعيد إشراكها في مشروع النهضة والمقاومة.
4-المهمة المتعلقة بأصول التفاعل بين الخطاب الدعوي وترشيد العلاقة مع المؤسسات الدينية الرسمية:
وهي مهمة تتعلق بإحياء أصول التفاعل بين الخطاب الدعوي والمؤسسات الدينية، بما يُعيد لهذه المؤسسات موقعها الطبيعي في توجيه الأمة وقيادتها، لا تبعيتها للسلطة السياسية، فالمؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية مطالبة بأن تنهض بدور مستقلٍّ، يُعبّر عن ضمير الأمة وقيمها، ويعيد الثقة بجماعة العلماء بوصفهم حملة الرسالة لا أبواق السلطان.
5- المهمة المتعلقة باستثمار ساحات الخطاب الإعلامي:
تتمثل هذه المهمة في استثمار ساحات الخطاب الإعلامي كأداة قوية لصناعة الوعي الجمعي للأمة حول قضاياها المختلفة، إذ يجب على العمل الإسلامي أن يوسع استخدام وسائل الإعلام المتنوعة لصناعة خطاب توعوي يربط الأمة بقضاياها المصيرية ويُحرض على الفعل والمقاومة، فالإعلام اليوم هو أحد أوجه الجهاد الكبرى التي تعكس الواقع وتؤثر في الوعي العام، وينبغي استغلاله لإعادة بناء العقل الجمعي وتعزيز الانتماء للقيم الإسلامية.
6-المهمة المتعلقة بمنظومة القيم الإسلامية وبناء النماذج الواعية:
تتمثل هذه المهمة في بناء منظومة من القيم الإسلامية المتكاملة، وتطوير نماذج فردية وجماعية واعية يمكنها التفاعل مع التحديات المعاصرة، ويُستفاد في هذا السياق من عرض تجارب شخصيات معاصرة مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وغيرهم من القيادات التي برزت في طوفان الأقصى، حيث تجسد تلك الشخصيات مبادئ الشجاعة والصبر والتضحية، وربط هذه النماذج بنماذج السيرة النبوية العطرة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جسدوا أسمى معاني البطولة والإيمان في سبيل الله، مما يعزز من قدرة الأمة على تقديم نماذج حية في مواجهة التحديات.
7- المهمة المتعلقة بضبط العلاقة بين الخطاب الدعوي والممارسة السياسية:
من الضروري ضبط هذه العلاقة، فالتوازن والتناسق بين الدعوي والسياسي يعدّان من الأسس الأساسية لنجاح العمل الإسلامي في العصر الحديث؛ لأن هذا التوازن يعزز من مصداقية المشروع الإسلامي ويضمن بقاءه موجهًا نحو خدمة الأمة والحفاظ على هُويتها.
8-المهمة المتعلقة بحقائق وأصول العلاقة بالآخر:
تتعلق هذه المهمة بضرورة تبني خطاب إسلامي رسالي يعزز من فهم العلاقة بالآخر، ويعمل على تقديم الإسلام في صورته الحقيقية باعتباره رسالة عالمية، ومن خلال التأثير الواسع الذي أحدثه طوفان الأقصى، يمكن تسليط الضوء على التأثيرات الحضارية التي أحدثها هذا الصراع في الحضارة الغربية وحضارات الشرق مما يسهم في تعريف وإيضاح قضايانا وتبنيها.
9- المهمة المتعلقة بمراصد الفرصة وحقائق النصرة:
تتمثل هذه المهمة في إدارة الفرص المتاحة للأمة الإسلامية في ظل الظروف الراهنة، حتى لا تضيع الفرص التي قد تتاح في هذه اللحظات التاريخية الخاصة بطوفان الأقصى، كما يجب أن نُعيد تعريف النصرة ونوضح معانيها العميقة في هذا السياق، إذ إن النصرة الحقيقية للأقصى لا تقتصر على الدعم العسكري فقط، بل تشمل الجهود السياسية، الإعلامية، والاقتصادية، مع الدعوة المستمرة لهذا المبدأ والعمل على ترسيخه في الوعي الجمعي للأمة.
10-المهمة المتعلقة ببناء عقل استراتيجي نوعي يتعلق بالخطاب الإسلامي:
تتمثل هذه المهمة في ضرورة بناء عقل استراتيجي نوعي يتعلق بالخطاب الإسلامي واستراتيجيته والخطاب الدعوي على وجه الخصوص، يكون قادرًا على تحليل الواقع المعاصر وتوجيه الخطاب الدعوي بما يتناسب مع التحديات المستجدة، وينبغي أن يكون هذا العقل الاستراتيجي بعيدًا عن الردود العاطفية أو السطحية، بل مستندًا إلى فهم عميق للمقاصد الشرعية ومتطلبات المرحلة.
وخلصت الورقة إلى أن هذه المهمات العشر تمثل حجر الزاوية في صياغة السيناريوهات المستقبلية للأمة الإسلامية في ضوء ما يمكن تسميته بـ “السنن الشَّرطية” التي تنظم حركة الأمة في مساراتها المختلفة كما يمكن من خلال هذه المهمات، بناء المخيال الجمعي الذي يحدد المقاصد الأساسية والأهداف التي تسعى الأمة لتحقيقها، مما يسهم في تشكيل السيناريو المرغوب والواجب تنفيذًا لقوله تعالى: “وَلِتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ”.
الورقة الثانية: محددات العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي، وإشكاليات الخلط وعدم التمييز بينهما في ضوء التجارب المعاصرة:
وقد استعرضت الورقة بداية ظهور إشكال العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي وحدودها عند الجماعات التي تحركت وفق فهم يرى أن شمولية الإسلام تقتضي شمولية الجماعة في العمل والحركة، حيث إن هذه الجماعات اعتبرت أن الإسلام نظام شامل لا يقتصر على العبادة بل يمتد إلى السياسة والمجتمع، ومع تطور الفكر، ظهرت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الدعوة والسياسة، وتحديد حدود التداخل بينهما، بما يحفظ استقلالية كل منهما ويجنب التدخلات السياسية في الشؤون الدعوية.
كما وقع كذلك من بعض الجماعات الدعوية التي دخلت المجال السياسي عندما حصل انفتاح سياسي.
وهذا الإشكال المتعلق بمن هو صاحب الأمر: الحاكم أم العالم، والذي لم يكن مطروحًا في عصر سلفنا الصالح، حيث كان الحاكم في الأصل عالمًا جامعًا بين الأمرين، لكن مع مرور الزمن وظهور التحولات السياسية، حدث الانفصال بين القرآن والسلطان، مما أدى إلى تباين أدوار العلماء والحكام، وزيادة الإشكالات حول العلاقة بين الدعوة والسياسة.
أولًا: تعريف الدعوي والسياسي:
– الخطاب الدعوي: وهو الخطاب الذي يتعلق بالنشاط الذي يهدف إلى ترسيخ وجود الإسلام في المجتمع من خلال ثلاثة أصول: بلاغ الرسالة، والتزكية، والتعليم، ويتميز الخطاب الدعوي بأنه طويل الأمد، يعتمد على العطاء والمنح، ويقوم على بناء الوعي والتوجيه الروحي في سبيل نشر قيم الإسلام.
– الخطاب السياسي: يتعلق بإدارة الشأن العام وصناعة القرار في ضوء أحكام الإسلام، بهدف تحقيق المصالح وتمكين الأمة، وهو ساحة للمغالبة والمصادمة في مواجهة التحديات السياسية، بخلاف الخطاب الدعوي الذي يركز على التأثير الروحي والتربوي، مما يجعله مجالًا مختلفًا تمامًا من حيث الأهداف والوسائل.
ثانيًا: محددات العلاقة بين المجالين:
العلاقة بين الخطاب الدعوي والسياسي ليست علاقة تطابق، بل هي علاقة تكامل تضمن لكل منهما خصوصيته، وعلى الرغم من اختلاف الطريق بين مجالي الهداية والولاية، فإن الغاية واحدة.
أهم مجالات العمل الدعوي تشمل:
- التبليغ والإرشاد: نشر معاني الإسلام وبيان العقائد والأحكام.
- التربية والتزكية: بناء الشخصية المسلمة، الروحية والأخلاقية والسلوكية.
- الإصلاح المجتمعي: توجيه الناس إلى القيم والمبادئ في علاقاتهم الاجتماعية والأسرية.
- تعزيز المعرفة الدينية: تعزيز الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية في ضوء متغيرات الواقع.
- التعليم والتدرج الرباني: بناء مدارس علمية مستمرة تنشر العلم وتؤهل الأجيال وفقًا للمفاهيم الشرعية السليمة. كما قال تعالى: (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ).
ومن أبرز مجالات العمل السياسي:
- النظر في السياسات العامة: معالجة قضايا الحقوق والحريات والأولويات العامة بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
- إدارة الدولة ومؤسسات الحكم: بناء هيئات ومؤسسات حكومية قائمة على العدالة والشورى.
- تحقيق الأمن والعدالة: عزيز الأمن الداخلي والخارجي وتوزيع الثروات بشكل عادل بين أفراد المجتمع.
- فض النزاعات وسيادة القانون: توفير آليات لحل الخلافات وتحقيق العدالة وفقًا لمقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية.
- العلاقات الدولية والتمثيل: ناء علاقات دولية قوية مع الدول وفقًا لمبادئ الأخلاق والعدل.
- بناء التحالفات وتحقيق المصلحة العامة: إقامة تحالفات استراتيجية لخدمة الأهداف العليا للأمة.
- المدافعات السياسية: الدفاع عن قضايا الاختيار والشورى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الولايات العامة من الخروج عن الشرعية والمشروعية.
هذه المجالات تمثل أبعادًا حيوية لفهم الإسلام في سياق الحياة المعاصرة، والتزام المسلمين بتفعيلها يمكن أن يسهم في بناء مجتمع متوازن وقوي؛ لذلك يمكن القول إن العمل الدعوي يركز على التربية والتزكية، بينما السياسي يتعامل مع تدبير الواقع وصناعة السياسات، وتختلف المرجعية أيضًا؛ ففي الدعوي توجد مرجعية تربوية تستهدف القلوب والعقول، بينما في السياسي توجد مرجعية دولة ذات سلطة وإكراه، كما أن الأدوات المستخدمة في التأثير تتفاوت بين النصح والوعظ في الدعوي، والتشريع والقوانين في السياسي، مع تباين أولويات العمل بين تركيز على القاعدة في الدعوي، وتركيز على القمة في السياسي.
إشكاليات الخلط بين الدعوي والسياسي في التجارب الإسلامية المعاصرة تظهر في عدة جوانب، أبرزها:
- فقدان الخطاب الدعوي لحياديته: عندما يختلط الخطاب الدعوي بالخطاب السياسي، يفقد مصداقيته ويصبح أداة دعاية حزبية.
- اضطراب الأولويات بين التربية والتمكين: حين يغلب الطابع السياسي على الدعوي، تضعف وظائف الدعوة الأساسية ويحولها إلى مشروع سلطوي.
- فقدان المصداقية في نظر المجتمع: تقلُّب المواقف السياسية يضعف الثقة في الخطاب الدعوي، مما يؤثر سلبًا على تأثيره في المجتمع.
- خلل في البنية الهيكلية: تضارب داخلي في البنية التنظيمية بين المهام الدعوية والسياسية يضعف فعالية التنظيمات.
- عرقلة التكامل والتخصص: الخلط يعيق بناء مؤسسات متخصصة ويؤدي ضعف التنسيق بين المجالات لحالة مشوشة ضعيفة الإنجاز.
- الاستهداف وضرب الجميع: غياب التمايز بين الدعوي والسياسي يعرض العمل الدعوي للاضطهاد السياسي.
تجارب معاصرة في العلاقة بين الدعوي والسياسي:
من خلال مراجعة التجارب الإسلامية المعاصرة نجد أنها تكشف عن تنوع نماذج هذه العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي:
- نموذج الدمج الكامل (جماعة الإخوان المسلمين): تبنَّت الجماعة منذ نشأتها نموذجًا يجمع بين العمل الدعوي والسياسي، مما أدى إلى توسيع القاعدة الشعبية وتعزيز الروح الدعوية والتعليمية، إلا أن التداخل بين المجالين أدى إلى إرباك وظيفي، وفقدان التمايز، وظهور صراعات أضعفت المشروع.
- نموذج الدمج الكامل مع غلبة السياسة (الحركة الإسلامية السودانية): حققت الحركة الإسلامية السودانية مكتسبات سياسية واسعة، بما في ذلك ممارسة الحكم. إلا أن غلبة الطابع السياسي جعلها تُعتبر حركة ذرائعية، وضربت مؤسساتها الدعوية والسياسية معًا بعد الانقلاب.
- نموذج الفصل الجزئي (حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي): اتبعت هذه الحركات نموذج الفصل بين الدعوي والسياسي، مما ساعد في حماية الدعوة من تقلبات السياسة، ومع ذلك، فقد وُجِّه النقد هذا الفصل من قبل المفكر فريد الأنصاري الذي حذر من تهميش الدعوة والانشغال بالسياسة على حسابها.
- نموذج الفصل في سياق ديمقراطي محافظ (حزب العدالة والتنمية التركي): تبنى الحزب نموذج الفصل بين الدعوي والسياسي مع تقبل القيم الديمقراطية، ورغم تحقيقه لمكتسبات اقتصادية وسياسية، فقد تعرض هذا النموذج لانتقادات بسبب القطيعة شبه التامة مع الخطاب الإسلامي والاتهامات بالتنازل عن المبادئ لصالح الواقعية السياسية.
نماذج حركات دعوية خالصة: مثل الحركات السلفية العلمية والدعوية، وجماعة التبليغ، أو الصوفية التقليدية:
اختارت هذه الجماعات التركيز على العمل الدعوي بعيدًا عن السياسة، معتبرة أن انخراطها في المجال السياسي قد يؤدي إلى الفساد أو الانحراف عن أهدافها.
تتمثل إيجابيات هذه الحركات في صفاء الخطاب الدعوي، مما يعزز الحضور القوي والشعبي لها، ومع ذلك، فإن غياب تأثيرها في القرار العام يضعف من فاعليتها في تحقيق الإصلاح الشامل للمجتمع، مما يجعلها أقل تأثيرًا على المدى البعيد، كما أنه لا يجعلها بمأمن عن الاستهداف من الأنظمة المستبدة التي ترفض الفكرة الإسلامية جملة وتفصيلًا!
توصيات ختامية للورقة:
- تبني رؤية تأصيلية واضحة: تبني مجال الدعوة والمجال السياسي من حيث المرجعية الوظيفة والخطاب، مع تحديد وظيفة كل منهما بوضوح، وتجنُّب الخلط بين ما هو تعبدي وما هو اجتهادي تدبيري، مع احترام قطعيات الثبوت والدلالة في الأحكام الشرعية.
- تطوير خطاب دعوي مستقل: بعيد عن الاصطفافات السياسية، يعبر عن مرجعية دينية ثابتة، ويؤسس للثقة والصدق في مخاطبة الناس.
- بناء مسار يتوافق مع خصوصية كلٍّ تخصص: بما يتناسب مع طبيعة التخصص وأدواته، وتجنب الازدواجية أو الانفصام بين المجالات المختلفة، بحيث تتناغم الممارسة مع القيم الإسلامية.
- إجراء مراجعات نقدية للتجارب الحركية السابقة: بهدف التعلم منها، وتصحيح المسار، وبلورة نموذج جديد يجمع بين الرشد الدعوي والنضج السياسي.
- الانفتاح على فقه الواقع: مع مراعاة مقاصد الشريعة في بناء العلاقة بين المجالات الدعوية والسياسية، وتجنب العزلة الدعوية أو التحلل السياسي.
الورقة الثالثة: عن طبيعة العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي:
بدأت الورقة بعرض قضية أولية وهي أن طرح الإشكالية الخاصة بعلاقة المجال الدعوي بالسياسي جاء في الأصل من خارج نطاق الحركات الإسلامية، وكان بمثابة محاولة من أعداء العمل الإسلامي لتقييد دورها وتأثيرها في المجتمع. وكان الهدف من ذلك هو تحجيم قدرة هذه الحركات على التأثير في الواقع السياسي، وتحويل اهتمامها إلى الجوانب الدعوية فقط، مما يعزلها عن ميدان العمل السياسي الذي يمثل جزءًا مهمًّا من رسالتها في الإصلاح الشامل.
وأشارت الورقة إلى تجربة الإسلاميين في الحكم بمصر، حيث تصدت جماعة الإخوان للعمل الحزبي بجانب الدعوي. وأن هذا الجمع بين الدعوة والسياسة أظهر لفئات من الناس تناقضًا، بين دعوة الناس للإصلاح الروحي ثم منافستهم سياسيًّا، الأمر الذي دفع الجماعة للتفكير في قضية فصل العمل الدعوي عن السياسي، بهدف تجنُّب التداخل الذي قد يؤثر على مصداقيتها ويُضعف دورها.
وأشارت الورقة كذلك إلى ضرورة مراعاة مراحل العمل الإسلامي، التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسة:
- مرحلة الإعداد للتغيير المنشود.
- ومرحلة التغيير نفسه.
- ومرحلة البناء والاستقرار.
حيث يختلف العمل في كل مرحلة عن الأخرى، وبالتالي تتغير طبيعة العلاقة بين المجالين الدعوي والسياسي بناءً على المرحلة التي يتم فيها العمل.
وشددت الورقة على أن من حق الإسلاميين، مثل غيرهم، تبني المفاهيم الخاصة بفكرهم السياسي والترويج لها، إذ لا يجوز حصرهم في العمل الدعوي داخل المساجد فقط، خاصة في ظل حملهم لرؤية كلية وشاملة للإصلاح، فالإسلاميون لا يقتصر دورهم على الجانب الديني فقط، بل يسعون لإحداث تغيير شامل وهذا حقهم.
كما أوضحت الورقة أن وظيفة إقامة الدين لا تكون مقتصرة على الأفراد فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب العمل المؤسساتي، ولا بد من الدعوة لها والترويج لها عبر مؤسسة سياسية تُسهم في نشر المبادئ والقيم الإسلامية في المجال العام.
وفيما يخص مرحلة البناء، وهي المرحلة الثالثة والنهائية من مراحل العمل الإسلامي، ستكون العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي على مستويين:
الأول: هو المستوى الدعوي، الذي يتكفل به المتخصصون في الناحية التربوية والإيمانية، من خلال المؤسسات الدعوية مثل المساجد، حيث يُركز على ترسيخ القيم الدينية وتعزيز الوعي الروحي لدى الأفراد.
أما المستوى الثاني: فيتعلق بإقامة الدين من خلال مؤسسات سياسية، حيث تطبق المنطلقات الإسلامية في الشأن العام، لتحقيق الإصلاح في مختلف الجوانب مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها.
وركزت الورقة كذلك على أن الدعوة الإسلامية لا تقتصر على الجانب المحلي فقط، بل إن لها دورًا رساليًّا يشمل الناس جميعًا، مستندة إلى قوله تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ”، فالدعوة تقدم نموذجًا متكاملاً يطمح له البشر جميعًا.
وبينت الورقة أن الخلل الذي حدث في النموذج المصري كان بسبب غياب الوضوح، حيث كان واقع الحال أن إدارة الحزب السياسي تُدار عمليًّا من خلال الجماعة وتحت إشرافها التام، دون توضيح هذه المنهجية للناس، ولو كان الأمر يتمتع بالوضوح منذ البداية، ببيان أن هذه هي طبيعة منهج الجماعة، لأسهم ذلك في تجنب الكثير من الإشكالات والالتباسات التي نشأت نتيجة لهذا الغموض.
وفيما يخص مرحلة الإعداد التي تعيشها الحركات الإسلامية الآن في غالب الدول، أكدت الورقة أن الحديث عن فصل الدعوي عن السياسي يُعتبر من قبيل الترف الفكري، إذ إن واقع الاستضعاف الذي يعيشه العمل الإسلامي في العديد من البلدان يشكل ضغطًا كبيرًا على هذه الحركات، وفي ظل هذا الواقع، لا مجال لمناقشة هذا الفصل بشكل جدِّيٍّ، حيث إن القضايا السياسية والاجتماعية تلتقي بشكل واقعي.
وتحدثت الورقة عن الوضع الدولي الحالي، وما يمر به العالم من لحظة فاصلة في ظل تراجع الإمبراطورية الأمريكية في عهد ترامب، هذا التراجع الذي يمثل فرصة كبيرة لتقديم النموذج الإسلامي بشكل واضح وصريح، مما يفتح الطريق أمام هداية الآخرين إلى هذا النموذج الفريد في الإصلاح الذي يطمح له الناس جميعًا.
وختمت الورقة بأن المشروع السياسي، إذا لم يتبنَّ أسسًا تربوية إيمانية عميقة، سيتحول إلى مشروع مفرغ من مضمونه، بعيد عن غايته، فاقد لمصداقيته، لذا، فإن ترابط المشروع الدعوي والسياسي يُعد ركيزة أساسية لبناء عمل إسلامي راشد، قادر على تحقيق التغيير المنشود.
مناقشات حول الورقات:
بعد عرض المحاور المذكورة في الأوراق، دار النقاش بين الحضور حول عدة نقاط رئيسة، كان أبرزها:
1-إقامة الدين مهمة سياسية ولابد من مؤسسة تدافع عن قيمها الإسلامية:
إقامة الدين هي مهمة سياسية بامتياز، من هذا المنطلق، يجب أن تكون هناك مؤسسة إسلامية قوية تسعى إلى الدفاع عن هذه القيم الإسلامية وتعمل على تحقيقها في مختلف أبعاد الحياة العامة، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة، وذلك كما تفعل كل التيارات الأخرى مع أفكارها وقيمها مثل الليبرالية والاشتراكية وغيرها.
2-بناء شخصية شمولية دعوية سياسية:
دار نقاش حول كيفية بناء شخصية شمولية دعوية سياسية يتطلب موازنة بين العمل الدعوي الذي يركز على التربية والتزكية، والعمل السياسي الذي يتعامل مع تدبير الشأن العام، لأن كليهما ركن في هذا الدين الحنيف.
3- التخصص والأهلية في كل مجال:
دار نقاش حول أهمية التخصص والأهلية في كل من العمل الدعوي والسياسي، حيث أُكد على ضرورة وجود خبرات وكفاءات متخصصة لكل مجال، فالعمل الدعوي يتطلب فهمًا عميقًا للتعاليم الدينية، بينما يحتاج العمل السياسي إلى مهارات إدارة الشأن العام وصناعة القرار بما يتماشى مع قواعد ومبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية.
4- ضرورة استئناف الحياة الإسلامية من حيث وقف من قبلنا:
دار نقاش حول ضرورة استئناف الحياة الإسلامية من حيث توقف أسلافنا، مشددين على أهمية تفعيل مؤسسات الأمة مثل الأوقاف، الفتوى، والقضاء، لضمان استدامة التنمية الإسلامية على أسس صحيحة، واستكمال الدور الذي بدأه العلماء والفقهاء في تنظيم شؤون الأمة.
5-التركيز على الحاضنة:
دار النقاش حول أن الحاضنة الأساسية للمشاريع الإسلامية هي الأمة نفسها، وهي المنوط بها حمل ودعم مشروع الأمة، وأُكد على ضرورة عدم التركيز فقط على المشاريع الحركية، بل يجب الاهتمام بتعزيز الحاضنة الشعبية وتفعيل دورها في دعم المبادرات الإسلامية، لضمان نجاحها واستمراريتها.
الورقة الرابعة التجديد في العمل الإسلامي والخطاب الدعوي وأثره على الحاضنة الشعبية للأمة:
انطلقت الورقة من أن الحاضنة الشعبية تراجعت في العشر سنوات الأخيرة، وأصبح من الضروري استعادتها باعتبارها أحد المكونات الأساسية لنجاح العمل الإسلامي، وأن تحقيق ذلك يتطلب تجديد وتفعيل الخطاب الدعوي ليواكب احتياجات الأمة ومتغيرات الواقع، مع التركيز على تعزيز وعي الجماهير بمسؤولياتها تجاه قضاياها ومشاريعها الإسلامية.
حول الخطاب الدعوي:
الخطاب الدعوي يتطلب شكلًا ومضمونًا يتسمان بالتجديد والفاعلية ليواكب احتياجات العصر. الدعوة لا تقتصر على الأفراد، بل هي مسؤولية جماعية، كما ورد في قوله تعالى: ” أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ” .
فمن الضروري مراعاة طبيعة الخطاب حسب حال المخاطب، والهدف منه، وظروف المرحلة، وهذا الأمر يتجلى ظاهرًا في اختلاف أسلوب الخطاب الدعوي القرآني بين المرحلة المكية التي اتسمت بالتأسيس والمرحلة المدنية التي كانت مرحلة تنظيم وبناء.
شكل الخطاب الدعوي:
الخطاب الدعوي ينبغي أن يتسم بعدة مواصفات أساسية لضمان فاعليته:
- دقيق: خالٍ من الأخطاء، خصوصًا في عصر المعلومات الذي يسهل فيه رصد الأخطاء ومعرفة الصواب.
- حماسي: يختلف عن الدرس العلمي الهادئ، حيث يهدف إلى تحفيز القلوب وتوجيه العقول بقوته.
- إيماني: يثير جوانب الإيمان في قلوب المستمعين، ويحفز فيهم جوانب الخير والهداية.
- مرغب في العمل: يسعى إلى توليد رغبة العمل في الحاضرين، وتحفيزهم نحو الفعل النافع الدائم.
- لغة سهلة: تُستخدم لغة بسيطة، مع مفردات تناسب المتلقي، دون أن تكون منفرة أو تحتوي على تقريع.
مضمون الخطاب الدعوي:
الخطاب الدعوي يوجه للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ويختلف مضمونه بحسب الفئة المستهدفة:
- للمسلمين: يهدف إلى إيقاظ صحوة جديدة تتناسب مع واقعهم الحالي وتحدياته، يركز على تعزيز الوعي الديني وتوجيههم نحو العمل الصالح وفق متغيرات العصر.
- لغير المسلمين: عبر الاشتباك في مجامعهم وعرض الإسلام في إطار الدور الرسالي للمسلم، مع بيان الحق في قضايا الأمة وإظهار المفاهيم الصحيحة التي تتعلق بالعدالة في الإسلام.
محددات الخطاب الدعوي:
- الجهد الجماعي: الدعوة تتطلب جهدًا جماعيًّا لتعظيم تأثيرها، فالتعاون بين أفراد الجماعة يعزز الرسالة ويوصلها بشكل أقوى وأكثر تأثيرًا، مما يُسهم في توحيد الجهود نحو هدف مشترك.
- وضوح الهدف: يجب أن يكون الهدف من الخطاب الدعوي واضحًا ومعروفًا قبل تصديره، وإن معرفة الرسالة التي يراد توصيلها يسمح بصياغة خطاب فعّال، موجّه نحو تحقيق الهدف المنشود.
- التخصص: لا بد من أن يتصدر للخطاب الدعوي الأشخاص المتخصصون في المجال المعني، فالتخصص في مختلف جوانب الدعوة يسهم في تقديم رسالة صحيحة ومبنية على معرفة دقيقة وراسخة.
الخاتمة:
لقد أظهرت هذه الحلقة النقاشية محاور متكاملة ترتبط ببعضها في إطار مشروع العمل الإسلامي المعاصر.
فالورقة الأولى، تناولت المداخل النظرية الجامعة للعمل الإسلامي، مع التركيز على ضرورة صياغة رؤية شاملة تنطلق من المبادئ الإسلامية الثابتة لمواكبة تحديات العصر ومتطلباته، أما الورقة الثانية، فقد استعرضت محددات العلاقة بين العمل الدعوي والسياسي، وناقشت إشكاليات الخلط وعدم التمييز بينهما في ضوء التجارب المعاصرة، مع التأكيد على ضرورة التوازن بينهما لضمان التأثير الفاعل والامتداد المستدام.
أما الورقتان الثالثة والأخيرة، فقد ركزتا على التجديد في العمل الإسلامي والخطاب الدعوي، ودوره في استنهاض الحاضنة الشعبية للأمة، مع التأكيد على أهمية تطوير الخطاب الدعوي ليواكب التحولات الراهنة ويؤثر في الشأن العام، وعلى ضرورة استعادة الحاضنة الشعبية من خلال تجديد أساليب الدعوة وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية.
وقد طرحت في نهاية الحلقة فكرة لمبادرة تهدف إلى إعداد دليل لأهم الاحتياجات والموضوعات التي ينبغي تسليط الضوء عليها دعويًّا، بحيث تكون مادة متكاملة في يد الدعاة، مع ضرورة أن تقوم جهة دعوية خاصة ذات تركيز قوي على تجهيز هذه الموضوعات، وهذه المبادرة يمكن أن تسهم بشكل فعّال في تعزيز العمل الدعوي وتوجيهه نحو قضايا الأمة ذات الأولوية، وتوفير إطار عمل منظم يساعد الدعاة على تفعيل رسالتهم في ظل التحديات المعاصرة.
ومن خلال هذا الاستعراض تظهر حاجة العمل الإسلامي إلى رؤية شاملة ينضجها عقلٌ استراتيجي واعٍ، تأخذ في الاعتبار الترابط بين النظرية والتطبيق، مع التأكيد على أهمية التخصص والتعاون الجماعي في تحقيق الأهداف الكبرى للأمة الإسلامية.