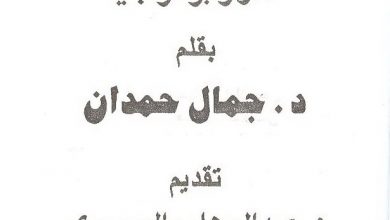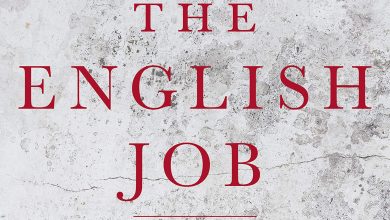الإمبراطورية الأميركية: الجذور والسياسات

مقدمات بين يدي الكتاب:
يعد الوقوف عند البعد الاستراتيجي للسياسة الأمريكية بنسقها الداخلي والخارجي أمراً في غاية الأهمية؛ لكونه يساهم بدرجة كبيرة في إحسان توصيفها وتحليلها؛ ومن ثم النظر في مآلاتها صناعةً وإدراةً، ولئن كانت الولايات المتحدة تستند على إطار مرجعي هو منهجيتها الليبرالية فكراً ومنظوراً، وديمقراطيتها نظاماً، ورأسماليتها اقتصاداً؛ فإنها تتأثر بالدوائر المحيطة بها صعوداً وهبوطاً في درجة تمسكها بها بحسب ما تمليه عليها مصالحها وأهدافها الحيوية، دون أن يكون هذا المؤثر قاضياً على نسقها المرجعي، وهو ما انعكس على توجهات الولايات المتحدة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية.
وفي هذا السياق يقدم لنا الدكتور عصام عبد الشافي قراءته للإمبراطورية الأمريكية بحثاً في جذورها المؤسسة، ومراحلها التكوينية، واستراتيجياتها في صناعة سياساتها منذ تأسيسها إلى واقعها المعاصر، واقتراب عبدالشافي من النسق الأمريكي لم يكن وليد اللحظة، إذ سبق أن تعرض له في سياقين مختلفين في مرحلة تكوينه المعرفي في الدراسات العليا، الأول: (الدور السياسي للأقليات الإسلامية في المجتمع الأمريكي). والثاني: (حول البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى تعرضه لهذا النسق في مرحلة ما بعد التكوين، من خلال كتابه: (السياسة الأمريكية والثورة المصرية)، في غيرها من البحوث والدراسات والأوراق البحثية، وهذا يعطينا مؤشراً على دراية الباحث بهذا النسق في بعده السياسي وانعكاساته في الواقع بجميع مظاهره، وقدرته في الوقوف على مفاصله وتفاعلاته، وكتابنا الذي نحن بصدد مراجعته والنظر فيه يظهر أن مؤلفه بعد تعرضه لبعض مضامينه في كتابه السياسة الأمريكية والثورة المصرية، قصد التوسع في موضوعه في سياق مستقل، فكان هذا الكتاب عنواناً ومضموناً.
إطلالة مراجع:
وقبل التلبس بالمراجعة في كتاب الدكتور عبدالشافي نقف على جملة من الكتب والمراجع التي خُصصت للحديث عن الولايات المتحدة في سياقها الإمبراطوري، فتكون قد اتحدت من حيث عناوينها من هذه الجهة، ولكن باختلاف زوايا النظر بحسب مقيدات الموضوع التي اقترنت به، ومنها مثالاً:
الاستثنائية الأمريكية:
مقدمة الكتاب على صغرها رسمت بعداً كلياً للموضوع بحيث تجعل القارئ يستحضره في كل صفحات الكتاب، إذ ابتدأها الباحث بتوصيف الولايات المتحدة على أنها دولة فريدة استثنائية؛ لكونها متميزة بموقعها الجغرافي، وبنائها الاجتماعي الخاص، وهذا بالضرورة منحها في مراحلها الزمنية اللاحقة قدرة على التأثير في السياسة الدولية، وقد ضمن المؤلف المقدمة في آخرها مقصوده من وضع الكتاب، وهو الوقوف على أبعاد رحلة الأمة الأميركية نحو الإمبراطورية بالنظر في ركائزها وأدواتها في عملية البناء.
التاريخ الأمريكي: سياسات الإدماج، وخطوات التكوين
ثم تجاوزها منطلقاً في استعراض الأمة الأمريكية في سياق تكوينها، مخصصاً له الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان: (أمة المهاجرين: سياسات إعادة التكوين)، والعنوان وما تضمنه من مباحث يوحي بادي الرأي فضلاً عن الغوص فيه بأن المهاجرين الأوائل الذين شكلوا البنية الأولى للمجتمع الأمريكي كانوا في الأصل هجيناً غير متجانس؛ لاختلاف بنيتهم الاجتماعية نشأة وصفة ولغة ومذهباً وثقافة، ولكن قدرة المجتمع الأمريكي على استيعابهم جاءت بسبب عوامل ساعدت في تحقيق ذلكم الاستيعاب، وهي: حركة الأمركة، وفكرة البوتقة، والتعددية الثقافية، إلا أن المجتمع من حيث صيرورته الحضارية لم تتبلور له هوية متميزة بشكل كامل؛ بسبب هشاشة القومية الأمريكية، وهو ما يبعث على التقرير كما أشار المؤلف بأن الولايات المتحدة هي بلد المتناقضات، وأكثر المجتمعات تنوعاً وتفاوتاً في العالم.
ولأجل أمركة المجتمع الجديد في سياق جامع وتحقيق إمبراطوريته، شهد خطوات تكوينية قاصداً بناء الدولة ونظامها السياسي وبروز التأثير على المستوى الدولي، وأبرز المحطات التاريخية التي أوجزها المؤلف في تحقيق ذلك، هي:
أولاً: مرحلة التأسيس التي شهدت مخاضاً اتسم بالعنف والشدة، وخاضت المستعمرات الأمريكية لأجله حروباً، وأبرزها الحرب الأمريكية البريطانية من أجل الاستقلال، وقد تمخض عنها نظام دستوري تأسس على فلسفة دولة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وانبنى على الوثيقة الدستورية التي تمت المصادقة عليها في أيلول/سبتمبر عام 1787م؛ لتكون دستوراً جديداً للبلاد، ثم أضيفت لها التعديلات العشر في أول كونغرس عقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر عام 1789م.
ثانياً: الحرب الأهلية التي اندلعت في نيسان/أبريل عام 1861م، بين الشمال والجنوب على خلفية مطالبة الولايات الجنوبية بالانفصال وتشكيل كونفدرالية خاصة بها، وقد أفضت إلى اتفاق الطبقة السياسية الأمريكية حول جملة من القواعد الدستورية والسياسية التي تحمي وحدة الدولة وتصون حريات الأفراد، وقد تجلى في الاتفاق حول مضمون الحقوق المدنية عام 1883م، وتعديلات الدستور التي كانت حلولاً وسطى للتسوية الملائمة بين وجهات النظر المتضاربة، ثم بروز الظاهرة الحزبية في صيغة الثنائية الحزبية بين الحزب الجمهوري باعتباره ممثلاً للتيار المحافظ، والحزب الديمقراطي باعتباره ممثلاً للتيار الليبرالي.
ثالثاً: الأزمة الاقتصادية العالمية 1929م: وقد واجهتها الولايات المتحدة بنهج أطلق عليه “السياسة الاقتصادية الجديدة” بقيادة الرئيس فرانكلين رزفلت، وكان لها أثر في بنية الدولة على المستوى الإداري، وترتب عليها ظهور قوى اقتصادية واجتماعية لها تأثيرها على مجريات العملية السياسية.
رابعاً: الحروب العالمية الأولى والثانية والباردة: وهي بمجملها أثرت على توجهات الحكم وصناعة السياسات الأمريكية، إذ ترتب عليها إدماج معادلات سياسية جديدة وتوازن جديد في العلاقة بين مؤسسات الحكم (الرئاسة والكونجرس)، بالإضافة إلى ظهور مؤسسات سياسية فرعية للجهاز التنفيذي لها دورها الفاعل في العملية السياسية (وزارتا الخارجية والدفاع، مجلس الأمن القومي، الوكالات التنفيذية: وأبرزها وكالة المخابرات المركزية، ثم هيئة مستشاري الرئيس، ومراكز الدراسات الاستراتيجية).
خامساً: ما بعد أحداث أيلول/سبتمبر عام 2001م وما أفرزته من تغيرات سياسية ومؤسسية في النظام السياسي الأمريكي، وتوجهاته الداخلية والخارجية، على غرار التغير في صورة القيادة السياسية، وفي طبيعة التوازن بين الرئاسة والكونجرس في صنع السياسة الخارجية، فعلى الرغم من احتفاظ النظام السياسي الأمريكي بشكله الرئاسي إلا أن تضافر التعديلات المتتالية على الدستور، وظهور معطيات وظواهر سياسية، أدخلت على هذا النظام تغييرات كبيرة وأدت لتعقيد العملية السياسية في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل الآراء والتحليلات تتباين في اجتهاداتها إزاء مسألة تحديد خصائصه، وآليات اشتغال مؤسساته، وبالنظر إلى طبيعة النظام السياسي بأنه نظام يقوم على الفصل بين السلطات، إلا أنه في حقيقة الأمر نظام مؤسسات منفصلة تشترك في السلطات، بمعنى أن هناك تداخلاً ومشاركة في ممارسة السلطات فيما بينها.
مؤسسات الإمبراطورية وعلاقات التفاعل:
وفي الفصل الثاني الذي جُعل تحت عنوان: (تكوين الإمبراطورية: بناء المؤسسات)، يعرض المؤلف لعملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية بالوقوف على المؤسسات الفاعلة فيها بحسب ما تتيحه لها المرجعية الدستورية، والمرجعية التقريرية التي تتمثل في النفوذ والسلطة الواقعية التي تكتسبها من المؤسسات الفرعية للجهاز التنفيذي، والمرجعية الاختصاصية المتعلقة بالخبرات والإمكانات المعلوماتية، ثم المرجعية التحكيمية عند نشوء نزاع سياسي أو قانوني يحال إلى إحدى المؤسسات الدستورية لحسمه، وصناعة القرار السياسي الأمريكي تقف على أربعة أركان رئيسة، وهي حسب ترتيب المؤلف:
أولاً: الكونجرس: وهو المؤسسة الدستورية الأولى من حيث منزلتها في ترتيب مواد الدستور، ويتكون من مجلسي الشيوخ والنواب، ويضم مجلس الشيوخ نائبين عن كل ولاية، بينما يضم مجلس النواب 435 نائباً على حسب التفاوت بين الولايات من حيث حجمها، وتتمثل سلطات الكونجرس في المجال الدستوري من خلال إصدار التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين، وفي المجال التشريعي المتعلق بإصدار القوانين الفيدرالية بمختلف صورها، وفي المجال التنظيمي حيث يشارك الكونجرس الرئيس في تعيين كبار الموظفين والقضاة، ويمكنه كذلك الاعتراض على التعيينات، ومن المهم التنبيه على أن دور الكونجرس محكوم بالتأثيرات السياسية التي تتجاوز نطاق الاختصاصات الدستورية، بسبب الدور الفاعل للأحزاب وجماعات اللوبي والزعماء البرلمانيين والمؤسسات الاقتصادية العملاقة، بالإضافة إلى علاقات التأثر والتأثير بين البرلمانيين ومسؤولي الجهاز التنفيذي، والمبادرات التي يقوم بها الرئيس.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة: ويعد الرئيس فيها مهيمناً على السلطة التنفيذية حسب مقتضيات الدستور، وتتمثل وظائفه في رسم السياسة العامة، والبت والتقرير في مجموع خططها وبرامجها، وبسبب طبيعة النظام الرئاسي للولايات المتحدة فإنه لا وجود لمجلس وزراء، وإنما تضم إدارته مجموعة من المستشارين الذين يديرون وزارات الإدارة التنفيذية، وأما سلطاته فتتمثل حسب الدستور في السلطات العسكرية، والتنظيمية، والدبلوماسية، والتشريعية، وتقف منظومة الرئاسة على مجموعة من الأجهزة التنفيذية لها دورها الفاعل في صناعة القرار السياسي، وأهمها في هذا السياق: أجهزة الإدارة التنفيذية، وتضم الوزارات الرئيسة في الدولة، وأهمها في صنع السياسة الخارجية وزارتا الخارجية والدفاع. ثم الديوان التنفيذي للرئيس: ويتألف من البيت الأبيض، وديوان الإدارة والميزانية، ومجلس المستشارين الاقتصاديين، ومجلس الأمن القومي، وديوان التمثيل التجاري. فضلاً عن الوكالات التنفيذية وهيئة المستشارين ومراكز الدراسات الاستراتيجية، وقد أثارت صلاحيات الرئيس جدلاً من حيث توصيفها وحدودها بين الإطلاق والتقييد، والمؤلف في هذا السياق يقرر أن الدستور منح الرئيس سلطات واسعة لكنها مقيدة بجملة من الحدود الدستورية والواقعية، ثم إن هذه السلطات خاضعة لمؤثرات العديد من العوامل والسياقات في بعديها الداخلي والخارجي، وأخيراً الولايات المتحدة دولة كبيرة ويصعب لشخص واحد استيعاب قضاياها الداخلية والخارجية والهيمنة على مقاليد قرارها الرئاسي، وهنا يبرز الدور التكاملي والتوظيفي لمؤسسات النظام السياسي، وتطرأ بلا شك إشكالية العلاقة بين الكونجرس والرئاسة وأشكال العلاقة بينهما.
الكونجرس والرئاسة: أنماط التفاعل والنزاع
تفاوتت مظاهر العلاقة بين الكونجرس والرئاسة بحسب التأثيرات السياسية في كل مرحلة زمنية من مراحل هذه العلاقة، وقد أدت التغيرات السياسية الخارجية إلى تغاير في الدور الوظيفي لكل من مؤسستي الكونجرس والرئاسة بما أملته مقتضيات التغير السياسي في هذه المراحل، وقد وقف المؤلف عند بعض مشاهد النزاع بين الطرفين مشيراً إلى مسوغاته الدافعة باتجاهه، مقرراً تفاوت ميزان القوى لصالح الكونجرس تارة، ولصالح الرئاسة تارة أخرى، وإزاء ذلك وما ترتب عليه من تطورات تفاعلية في مشهد صناعة القرار السياسي الأمريكي حدد المؤلف متفقاً مع بعض الباحثين أنماطاً للتفاعل بين الكونجرس والرئاسة بحسب القراءة الكلية للمشهد، مقرِناً بكل نمط منه مثالاً تاريخياً، وهي إجمالاً: نمط التعاون، ونمط توجيه الكونجرس للسياسة، ونمط الخضوع، ونمط إعلان السياسة، ونمط الرقابة.
ثالثاً: السلطة القضائية: كانت للطبيعة التكوينية للولايات المتحدة دورها في تعدد مكونات هذه السلطة، إذ وُضع فيها قانونان، الأول القانون الفيدرالي، والثاني قانون الولايات، وهما يعدان سبباً رئيساً في تعدد مكونات السلطة القضائية، والمرجع الرئيس الذي تستند عليه هو الدستور، حيث وضع لها الحدود بين القانونين الفيدرالي والولايات، بالإضافة إلى تقسيمه السلطة الفيدرالية بين السلطات الثلاث، ومن مصادره القضائية كذلك عند عدم التنصيص الدستوري مصدران: الأول: القانون العام، الذي يتمثل في مجموعة من القرارات القضائية، والعادات والمبادئ العامة، والثاني: السوابق القضائية، وأما مكونات هذه السلطة، فهي قائمة على ثلاثة أركان: المحكمة العليا، ومحاكم الولايات، وبعض المحاكم الفيدرالية الخاصة، وتعد المحكمة العليا بحسب الدستور هي السلطة القضائية العليا، ويعد رئيسها بروتوكولياً ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة، وفيما يتعلق ببعدها السياسي فإن معايير اختيار القضاة مرتبطة بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى الصفات والخصائص المؤهلة لممارستها من الكفاءة والنزاهة، وهذا بمجمله حسب المؤلف أكد على الدور السياسي للمحكمة، والمساعدة في تشكيل الملامح الأساسية للنظام السياسي الأمريكي.
رابعاً: الأحزاب السياسية: على الرغم من أن الدستور الأمريكي لا يتضمن أي إشارة للتنظيمات الحزبية أو دورها في النظام، إلا أنها تعد من أهم المؤسسات التي تساهم في عملية صناعة القرار السياسي الأمريكي، وكانت بداية تكوينها في أوائل القرن التاسع عشر في سياق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضحت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر جزءاً راسخاً من تقاليد الحياة السياسية الأمريكية، ومثلت قناة أساسية لتلقي مطالب الأفراد والجماعات كالنقابات والجمعيات المهنية والمنظمات المحلية، والظاهرة الحزبية في الولايات المتحدة يتغلغل فيها حزبان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ويسيطران على رئاسة الجمهورية والكونجرس ومناصب الولايات والمجالس التشريعية التابعة لها، والرؤساء الأمريكيون منذ منتصف القرن التاسع عشر كانوا حصراً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأبرز الاعتبارات في ترسيخ نظام الحزبين في الولايات المتحدة، النظام المتبع لانتخاب المشرعين على المستوى القومي ومستوى الولايات، وسيطرة الحزبين الجمهوري والديقراطي على الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى أن قانون الحملة الانتخابية الفدرالي يمنح فوائد خاصة للأحزاب الرئيسة، وهذا لا يمنع من وجود أحزاب أخرى تظهر في المشهد السياسي الأمريكي فيما يسمى بظاهرة الأحزاب الثالثة، وعلى الرغم من عدم قدرتها على لعب دور أساسي في هذا المشهد إلا أنها في بعض مراحله أثرت في نتائج الانتخابات، مالت الكفة بسببها إلى أحد الحزبين.
الأمة الأمريكية: نشر القيم واستراتيجيات الهيمنة
وبالانتقال إلى الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان: (الإمبراطورية.. رحلة الصعود)، نرى عند المؤلف تقريراً بأن الحالة الأمريكية منذ النشأة الأولى تعبر عن قوة متطلعة ذات طابع إمبراطوري خارج فكر التوازن الدولي، وعلى هذا الأساس بنت الولايات المتحدة سياساتها ورؤاها في ممارساتها في العلاقات الدولية، فمسيرة سياستها الخارجية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الآن استجابة لعاملين: القوة المتنامية باطراد، والمصالح التوسعية الإمبراطورية، متراوحة في ذلك بين مبدأ المثالية الذي صاغة ويلسون ومبدأ القوة الذي صاغة روزفلت، ولكن دون وجود خلاف على هدف السيادة الأمريكية الكونية.
وفي هذا السياق يقف المؤلف عند إطارين متلازمين:
الأول: القيم الأمريكية ومقاصد التعميم
فاعتماد الولايات المتحدة في بناء قوتها الذاتية على التوسع من الداخل إلى الخارج داخل أراضيها، واستكمالها سيطرتها الكاملة على أراضيها وتأسيسها دولتها الجديدة، شرعت بالتوسع نحو مجالها الاستراتيجي، وفي إطار هذا التوسع، أصبح هدف المشروع الأمريكي جذب كل أنام الكوكب إلى مجتمع مثالي، تشكل على الأرض الأمريكية، وتحقيقه أولاً بالتسامح، ثم بالقوة عند الاقتضاء، وأخيراً بالتجارة، ومن ثم قصدت تعميم أنموذجها في الهيمنة الكونية، وفكر الهيمنة لم يكن وليد القرن العشرين بحسب المؤلف، بل ترسخ مع البدايات الأولى للدولة، وجرى في هذا الإطار التعبئة الفكرية والتصريح المباشر على مستوى النخب الحاكمة والنخب الفكرية بأن الولايات المتحدة دولة أسست لكي تتوسع وتهيمن على النظام الدولي، وقد وظفت هذه الفكرة ومقولاتها من قبل تيار المحافظين لتكون الركيزة الأساسية في استراتيجية الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، الذي نظر إليه على أنه القرن الأمريكي الخالص، وبيد من سماهم المؤلف: المحافظون الجديد .. صقور الإمبراطورية، ولأجل فرض هيمنتها الدولية وصولاً إلى القرن الأمريكي الجديد، فقد اتخذ الولايات المتحدة عدة استراتيجيات تصب في سياق الهيمنة، من أبرزها: استراتيجية الاحتواء والردع التي مارستها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م لاحتواء الفراغ الناجم من ضعف بريطانيا وانهيار النظام الأوربي، ثم استراتيجية الاعتماد المتبادل في تسعينيات القرن العشرين التي قصد بها بناء النظام الدولي من خلال العلاقات السياسية المؤسسة على اقتصادات السوق المتكاملة، ثم نشر القيم والمعايير الأمريكية خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، حيث مارست الضغط على العديد من دول العالم لتبني وتطبيق القيم الأمريكية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنع الدول من تطوير قدراتها العسكرية بما يوازي القوة الأمريكية، ثم ما تصدره الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في دول العالم تستخدمها لابتزازها باتجاه التأثير في توجهاتها الخارجية.
الثاني: مشروع القرن الأمريكي الجديد
ويعد هذا المشروع خلاصة الرؤى والمعتقدات داخل حركة المحافظين الجدد، وثمرة من ثمار استراتيجيات الهيمنة الأمريكية، وتسعى الولايات المتحدة من خلاله ترسيخ فكرة الهيمنة الأمريكية متجاوزة الأطروحات التاريخية حول سقوط الدول القوية في حالة وصولها إلى أعلى مستويات القوة، وتساءل المؤلف: لماذا يعتقد منظرو العلاقات الدولية الأمريكيون وصانعو السياسة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تنجح حيث أخفق الآخرون؟ هناك ثلاثة أسباب أو مبررات يسوقها أنصار فكر الهيمنة الأمريكية في هذا السياق: أولها: أن الآخرين لا يوازنون قوة أمريكا كما هي، والدول تقيم توازناً ضد الدول التي تستخدم أسلوب التهديد، والولايات المتحدة كزعيم سليم لا تفعل ذلك، وثانيها: أن الولايات المتحدة تحسب حساباً لمصالح الدول الأخرى، لهذا ترغب هذه الدول في التحالف معها بدلاً من إقامة توازن ضدها، وثالثها: أن جاذبية قيم أمريكا الديمقراطية وثقافتها تبرر لها ممارسة قوة الزعامة والهيمنة. ولئن كانت هناك عوامل دافعة تصب في صالح التفرد والهيمنة كتوافر الموارد الاقتصادية والتكنولوجيا الجديدة، إلا أن هناك عوامل معوقة تحد من الهيمنة الأمريكية المطلقة، ومن ذلك تصاعد التهديدات العالمية التي تسهم في استنزاف القوة الأمريكية، تآكل أدوات الهيمنة الأمريكية على الصعيدين الاقتصادي والتنكنولوجي، ثم احتمال ظهور دول كبرى جديدة.
السياسة الأمريكية بعد سبتمبر 2001م: جدالات كبرى ورؤى متغايرة:
وفي الفصل الرابع والأخير الذي جاء تحت عنوان: (إمبراطورية ما بعد سبتمبر 2001) يعرض المؤلف لأربع مراحل في مسار صناعة السياسة الأمريكية، تعكس مدى الإشكاليات حول مضامين وأبعاد وقضايا هذه السياسة في العلاقات الدولية:
المرحلة الأولى: الحرب على ما يسمى بالإرهاب
فمع وقوع أحداث سبتمبر عام 2001م، وفي ظل سيطرة تيارات اليمين الديني والسياسي على الإدارة الأمريكية، اتجه أنصار هذه التيارات إلى القول بأن ضعف القدرة الأمريكية على الحسم وضعف الرادع الأمريكي كان من بين العوامل المشجعة على هذه الهجمات، ولهذا تغيرت الاستراتيجية الأمريكية بعد هذه الأحداث واتخذت بعداً مغايراً يتمثل في تغاير رؤيتها تجاه العالم، واتخذت مساراً تحدد في سياقه حلفاءها وأعداءها، ولا شك أن أحداث سبتمبر تعد سبباً لإضفاء الشرعية على رئاسة بوش الابن في ولايته الأولى بعد تحوله إلى مدافع عن أمن الشعب الأمريكي، وارتفاع شعبيته في تجنيده للشعب والعالم لشن حرب عالمية على الإرهاب، ومن هنا أصبحت الإدارة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر أكثر ميلاً لاتباع سياسة خارجية نشطة.
وقد انعكس ذلك كله على استراتيجية عام 2002م المتضمنة ثلاثة مبادئ: الأول: مبدأ بوش المتضمن الحرب ضد الإرهاب وضد الدول التي تدعم النشاط الإرهابي، والثاني: مبدأ الحرب الوقائية والاستباقية، بحجة عدم القبول بتمكين الأعداء من توجيه ضربة إليها أو إلى حلفائها، والثالث: مبدأ التدخلية الإجبارية، ويقوم على الاقتناع بأن العالم الخارجي ما هو إلا فناء خلفي للولايات المتحدة، وكل ما فيه يخصها، ولذلك من حقها التدخل في مختلف القضايا العالمية، وفي هذا السياق جاء التدخل العسكري المباشر في أفغانستان والعراق.
المرحلة الثانية: مهمتنا القضاء على الاستبداد الحاضن للإرهاب
بعد التجديد لبوش الابن أواخر عام 2004م، أعلن أنه سيسعى إلى العمل مع أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، لتعزيز التنمية والتقدم، ولهزيمة الإرهابيين، ولتشجيع الحرية والديقراطية كبديلين للاستبداد والإرهاب، وعلى هذا الأساس جاءت استراتيجة الأمن الوطني عام 2006م، انطلاقاً من التسليم بأن الولايات المتحدة في حالة حرب، وأن عليها ألا تميز بين الإرهابيين والدول التي تؤويهم، وسعياً نحو تحقيق هذا الهدف، وغيره من أهداف تمثلت الأفكار الرئيسة التي تضمنتها هذه الاستراتيجية في: أن تكون الولايات المتحدة قوية وآمنة، والعمل على أن تهزم استراتيجية مكافحة الإرهاب أيديولوجية المتطرفين البغيضة من خلال الترويج لوعد الحرية والديمقراطية، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه المؤلف في سياق مقولات النخب الفكرية الأمريكية من أمثال سانو تري، وتوم بيري، وإيمانويل والرشتاين أن السياسة الخارجية الأمريكية تتسم باعتبارها سياسة دولة عظمى بالاستمرارية والاستقرار على مستوى الأطر العامة والتوجهات الكبرى، أما التغيير فينال فقط السياسات والآليات التي تعتمد عليها في تحقيق أهدافها، وفي ترتيب أولويات هذه السياسات.
المرحلة الثالثة: عقيدة أوباما والقيادة من الخلف
مع تولي باراك أوباما الرئاسة في أمريكا في يناير عام 2009م، واجه أعباء كبيرة على خلفية السياسات والممارسات التي قام بها سلفه بوش الابن، وفي مقدمتها تحسين الصورة الذهنية عن الولايات المتحدة، ومحاولة الانسحاب التدريجي الهادئ من مناطق التوتر التي انغمس فيها بوش بعد عام 2001م، وهنا برز مفهوم القيادة من الخلف الذي يعد أقرب إلى تكتيك سياسي منه إلى عقيدة، ويرى البعض أن سياسة أوباما اتسمت بالتردد والإرجاء وشابها اللا قرار، وأن مبدأ القيادة من الخلف هو حكم يطعن في مؤهلات أوباما القيادية، ويرى المؤلف أن إدراة أوباما اتجهت لتبرير فلسفة القيادة من الخلف، بدعوى فكرة أفول قوة الولايات المتحدة النسبية في وقت تبرز قوى منافسة مثل الصين، وفكرة أن أميركا مكروهة في العالم، وهو ما لم يسلم به بعض المفكرين الأمريكان؛ باعتبار أن القوى المنافسة كروسيا والصين لا يمكن أن تقارن بالقدرات العسكرية الأمريكية، ويرى فريق من الباحثين أن هناك تراجعاً تشهده الولايات المتحدة على مستويات عدة: دولية وإقليمية ومحلية.
وفي هذا السياق من التراجع جاءت استراتيجية عام 2010م معترفة بتعقد التحديات التي سوف تواجهها الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، وأن بيئة اليوم لا يتحكم بها تهديد واحد، ولكن خليط معقد من التحديات والفرص على النطاق العالمي، وأن العولمة من شأنها أن تقود إلى عالم متعدد القطبية ستكون فيه القيادة الأمريكية قوة رئيسة في تعزيز الأمن القومي الأمريكي، وأن الحلفاء والشركاء والائتلافات عناصر ضرورية لمواجهة التهديدات العالمية، وهذه الرؤية انتقلت بالاستراتيجية من تركيز الاهتمام بالعسكرة، كما كان سائداً خلال إدارة بوش الابن بولايتيه إلى الاهتمام بعناصر القوة الشاملة والتأكيد على العلاقة العضوية بين المكون المحلي والمكون العالمي، وعولمة الأمن القومي الأمريكي ليصطبغ بالصبغة العالمية.
وفي مرحلة التجديد لأوباما جاءت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي عام 2015م، لتتناول المبادئ والأولويات المتعلقة باستخدام أمريكا لقوتها، وتأثيرها على العالم استناداً إلى قوة وقيم الولايات المتحدة، وأكدت على مضاعفة التزامات أمريكا تجاه الحلفاء والشركاء، وأشارت الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة أعادت معظم جنودها إلى أرض الوطن بعد أن عدلت من استراتيجية مكافحة الإرهاب، كما أنها قادت جهوداً دولية لإيقاف انتشار الأسلحة النووية من فرض عقوبات جديدة على إيران، كما أكدت على إعادة النظر في حساباتها لإعادة التوازن إلى علاقاتها في آسيا والمحيط الهادئ، والبحث عن امتيازات واستثمارات جديدة في أفريقيا والأمريكيتين. وفي سياق التقويم لعهد أوباما بولايتيه أصدر الباحث الأمريكي كولن دويك كتاباً بعنوان: (عقيدة أوباما: الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة اليوم)، رأى فيه أن الحذر الشديد الذي صبغ سياسات أوباما من حالة ترقب للحدث مع غياب للمبادرة كان من شأنه أن يظهر الولايات المتحدة بمظهر الضعيف وليس المراقب، وأن سياسة التقشف والحرص التي رسمت مسار سياسة أوباما الخارجية كانت ناجحة لوقت ما على صعيد شحذ شعبيته الداخلية، بل ساهمت في تسريع وتيرة تحقيق رؤيته في السياسات المحلية الأمريكية، إلا أن هذه النجاحات لم تأت بلا ثمن؛ بل كانت على حساب سمعة الولايات المتحدة في المحيط الخارجي.
المرحلة الرابعة: ترمب وهيلاري صراع التوجهات
في هذا السياق يعرض المؤلف لبرنامجي دونالد ترمب وهيلاري كلنتون باعتبارهما مرشحين رئيسين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن خلال ورقتين بحثيتين وقف عند توجهات السياسة الخارجية لترمب وهيلاري، ففيما يتعلق بتوجهاته في سياسته الخارجية يتبنى ترمب مبدأ أمريكا أولاً، ومبدأ العزلة الأمريكية، وأن على أمريكا ألا تتدخل في تنظيم شؤون العالم من حولها، ورفض فكرة التدخل الإنساني كأساس أو دافع للتدخل في الشأن الداخلي للدول، مع وقوفه بشدة ضد الهجرة، وأخيراً يتبنى مبدأ الحماية التجارية للسوق الأمريكي، وفي إطار توجهاته نحو العلاقات الدولية يرى أن على دول أوربا تحمل عبء الدفاع عن نفسها وتكالفيه المادية، كما أنه ينادي بتعزيز التقارب الأمريكي الروسي، ولكن من موقع قوة لا ضعف، ويرى كذلك التقارب مع الصين وأن تقوم معها علاقة احترام مبنية على القوة.
وأما فيما يتعلق بهيلاري كلنتون، فتتبنى مفهوم الديمقراطية الليبرالية كخلفية أساسية لتوجهاتها الدولية، باعتبارها مؤمنة بالعالمية كمنظور لهذه التوجهات، لكن في سياق مفهوم التعاون، وتقوية الحلفاء، وضرورة الاعتماد على القوة الذكية التي تعني مزج عناصر القوة الصلبة والقوة الناعمة في الوقت المناسب، وترى هيلاري كذلك أن الدبلوماسية السياسية إحدى أهم الأدوات التي يمكن استخدامها على الساحة الدولية، وقد أطلقت مبادرة عرفت باسم: الكفاءة أو القدرة السياسية على إدارة الدولة في القرن الحادي والعشرين، أو أصول الحكم في القرن الحادي والعشرين، وحقيقتها استكمال أدوات السياسة الخارجية التقليدية بأدوات ووسائل جديدة مبتكرة تثري وتزيد من فاعلية الشبكات والتكنولوجيا والقطاعات الديمغرافية المتشابكة حول العالم، وتخاطب أجندتها قوى جديدة قادرة على إحداث تغييرات واسعة الانتشار، وأما عن تواجهاتها في العلاقات الدولية، فتحبذ التوجه إلى آسيا والتوسع في العلاقات معها، وترى ضرورة تعزيز العلاقة مع الصين في إطار الحوار والتعاون بعيداً عن توازن القوى، أي العمل في إطار نظام دولي متعدد الأطراف، وفيما يتعلق بكوريا الشمالية فإنها تشير إلى ضرورة العمل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفع العقوبات عنها والحد من توسعاتها النووية إلى جانب العمل مع الصين والاستفادة من جهودها في ذلك.
وفي ختام الفصل تعرض الدكتور عصام عبد الشافي بإيجاز لعدد من إسهامات المفكرين في الربع الأخير من القرن العشرين حول تحديات الإمبراطوية الأمريكية ومسارات التحول فيها، من أمثال روس بيرو، وجور فيدال، وإيمانويل تود، وتشارلمرز جونسون، وجيمي كارتر، ، ووضعه في إطار جامع تحت عنوان: (بقاء الإمبراطورية: التداعي والصمود)، وخلاصتها استقراء من مقولات المفكرين بأن الولايات المتحدة تعاني بالفعل من العديد من التحديات التي قد تؤثر سلباً على طموحاتها العالمية، على أصعدة مختلفة: عسكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
ولكن في سياق خاتمته للكتاب رأى عبد الشافي في أبرز نتائجها
برأينا وهو ينظر إلى بعد يتجاوز الحالة الأمريكية أن العديد من مؤشرات الانهيار التي تعاني منها الولايات المتحدة لا تعد في حقيقتها خاصة بها، بل هي مؤشرات تعاني منها جميع دول العالم كبيرها وصغيرها، كما أن سلبية السياسات الأمريكية تجاه المنطقة العربية ومصالحها لا يعني إنكار قوتها، وتوجه برسالة إلى الفكر العربي والإسلامي بضرورة تأسيس خطاب يلتمس السبل لبناء النهضة والقوة التي تستطيع بناء قدر من التوازن مع القوى الأمريكية وغيرها.
وبعد: فالكتاب يعد بحق إضافة جديدة إلى المكتبة بسياقها العربي حول موضوع يهم الفكر العربي والإسلامي، ويوقف العامة فضلاً عن الخاصة على محددات السياسة الأمريكية وكيفية صناعتها والتعامل مع الفواعل الخارجية، ويمنح القارئ بعداً كلياً في كيفية تحليل السياسات وصناعتها، وهي مهنة يحسنها المؤلف، بالإضافة إلى كون الكتاب خرج عن النسق السردي والصحفي الذي تمتاز به كثير من الكتب التي تعرضت للحالة الأمريكية بإضافة البعد المنهجي الأكاديمي، ولكن مع ذلك لا يسلم عمل بشري من هنات، يقع فيه من استحال في شأنه الكمال، والكتاب جاء فيه شيء من التكرار في القراءة التاريخية في مراحل التكوين الأمريكي الذي كان يسع المؤلف تجاوزه، بالإضافة إلى بعض الهنات الطباعية التي لا يخلو منها عمل، ونسأل الله للمؤلف التوفيق والسداد.