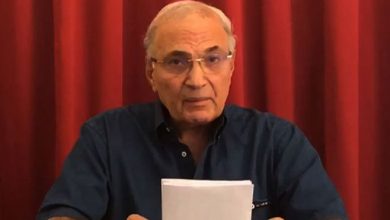السبيل إلى بناء عقل إستراتيجي للحالة السودانية!

المقدمة:
في مرحلة حاسمة من مسار الأمة الإسلامية، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، وتتبدل موازين النفوذ ومصادر القوة، يبرز السؤال حول العقل الإستراتيجي كضرورة حتمية وليست خيارًا، ومسؤولية لا ترفًا.
إذ لم يعد ممكنًا إدارة قضايا الأمة باستخدام الأدوات التقليدية أو الاستجابات الانفعالية اللحظية، بل أصبح واجبًا إطلاق تفكير أعمق، يُراكم الخبرة، ويعيد قراءة الواقع بمنظور شامل ومعقد.
لقد أفرزت المتغيرات العالمية والإقليمية موجات متعاقبة من التحولات، وفرضت على الفاعلين الإسلاميين مراجعة جذرية لأنماط التفكير والتأثير، بعد أن ثبت عجز الكثير من المشاريع والخطابات عن مواكبة تعقيدات الواقع أو التأثير فيه بفاعلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى عقل إستراتيجي: عقل قادر على الفهم العميق، والرؤية الممتدة، وإدارة الواقع بوعي.
وقد ابتدأ المركز هذه السلسلة بحلقة نقاشية تناولت الحالة المصرية، بعنوان: (السبيل إلى بناء عقل إستراتيجي للحالة المصرية)، ونثني في هذه السلسلة بهذه الحلقة عن الحالة السودانية، والتي هي بعنوان:
“السبيل إلى بناء عقل إستراتيجي للحالة السودانية“
استضافت الحلقة نخبة من العلماء والمفكرين والدعاة والمشتغلين بالعمل السياسي والإعلامي، لمقاربة هذا التحدي المركّب. وقد نوقشت في الحلقة النقاشية المحاور التالية:
- ضرورة العقل الإستراتيجي للحالة السودانية.
- رفع الواقع الحالي: سياسيًّا وعسكريًّا ومعيشيًّا، والقوى الفاعلة.
- جملة السياسات السودانية الداخلية والخارجية لمواجهة التحديات القائمة.
- الدور العلمائي لمستقبل السودان.
- الدور الإقليمي السوداني والمثلث الإستراتيجي (مصر-ليبيا-السودان).
- السودان بين بناء الدولة وبناء الأمة.
المحور الأول ضرورة العقل الإستراتيجي للحالة السودانية:
بدأت الحلقة النقاشية بعرض تمهيدي تفصيلي للورقة التأسيسية التي أعدّها مركز رؤيا للبحوث والدراسات، والتي مثّلت أرضية مفاهيمية ومنهجية لمشروع “العقل الإستراتيجي”، وقد عالجت الورقة هذا الأمر ضمن هذه الأبعاد المتكاملة التالية:
1-أهمية المشروع في السياق الراهن:
أوضحت الورقة أنه لا سبيل لمواجهة المشاريع الهادفة إلى استهداف الأمة إلا عبر استحضار جنس فكرها، وبيّنت أن الإصلاحات الجزئية، المتفرقة في هذا الميدان أو ذاك، لا تكفي لوقف الانحدار السريع نحو مآلات تخشى كل القلوب الغيورة على الأمة بلوغها، كما شددت الورقة على ضرورة استنفار الطاقات الكامنة للأمة، والسعي الجاد إلى صياغة خارطة طريق واضحة لإخراجها من الأنفاق المظلمة التي زُجّت فيها، مؤكدة أن هذا المسعى يمثل واجب الوقت وأولوية المرحلة.
2-مهمة الكيان الإستراتيجي المقترح:
بيّنت الورقة مجموعة من المهام المحورية التي ينبغي أن يتبناها الكيان المقترح، وفي مقدمتها:
- الاجتهاد في بناء الرؤية الإستراتيجية الإسلامية: رؤية تنطلق من المرجعية الشرعية، وتستند إلى قراءة دقيقة لمعطيات الواقع واحتياجاته.
- تحليل المشهد المحلي والدولي: عبر دراسة معمقة للقضايا الكبرى التي تمس الأمة، وتقديم تصورات إستراتيجية للتعامل الفعّال معها.
- الاستفادة من سعة أفق الاجتهاد في الفقه الإسلامي: من خلال وصل الفقه التشريعي بما يُعرف بـ”الفقه الحضاري” القادر على معالجة القضايا المركبة المتعلقة بالعمران والنهوض.
3- تمهيد لبناء المؤسسة المقترحة:
انطلاقًا مما سبق عرضه، فإن الغاية التي يسعى لها مركز رؤيا للبحوث والدراسات من هذه الحلقة النقاشية تمثل في الإشارة – على وجه الإجمال – إلى أهمية البناء المقاصدي للمؤسسة المنشودة، وبيان أبرز محدداتها وأدواتها ومتطلباتها في الشأن السوداني، مع توضيح طبيعة أشكالها وأوعيتها، ووضع هذه المخرجات ومكوناتها بين يدي أصحاب الشأن.
باعتباره خطوة أساسية وضرورية نحو تكوين مؤسسة “العقل الإستراتيجي الجامع للأمة”. على أن يتم ذلك كله من خلال اجتهاد جماعي صادر عن أهله المؤهلين، بعيدًا عن الاجتهاد الفردي أو الاجتهاد المؤسسي الشكلي الناقص.
4- أهمية البناء المقاصدي لمؤسسة العقل الإستراتيجي:
يحظى البناء المقاصدي بأهمية خاصة في صياغة العقلية الإستراتيجية لأي مشروع حضاري، لا سيما في ظل ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات كبرى تستهدف هويتها وحواضرها التاريخية في مصر والسودان والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، فضلًا عن الجزيرة العربية والمغرب العربي، وغيرها.
فحسن صناعة الاستجابات الواعية والفاعلة هو الذي يعيد للأمة فاعليتها الحضارية ودورها القيادي.
إن المقاصد تمثل البنية الحضارية للأمة، وتشكل إطارًا منظوميًّا وشبكيًّا متكاملًا يراعي الأولويات، ويأخذ بالتدرج، ويتجاوز الثنائيات الموهومة، ويستند هذا البناء إلى وعاء فكري يتغذى على مجموعة من العلوم التي وصفها أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبد الفتاح بـ “علوم الواجب”، وتشمل: علم بناء المفاهيم، وعلم السنن الإلهية والسنن الكلية، وعلم فروض الكفايات، وعلم المقاصد الكلية، مؤكدًا أن البناء المقاصدي للعقل الإستراتيجي، يشمل عشرية مقاصدية تعد قواعد أساسية للانطلاق والفعل والفاعلية، وتضمنت هذه العشرية:
- الوعي بمنظومة العلاقات بين الجزئي والكلي.
- إدراك المجالات الحضارية والإنسانية والعمرانية الخمسة: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، ودور العقل الإستراتيجي في حفظها والتنسيق بينها، والأدوات اللازمة لصونها.
- الموازين الأربعة: ميزان الضرورة، وميزان الضرر، وميزان المصلحة، وميزان الحاجة، مع ضوابط كل منها.
- مراعاة الأولويات المتعددة: أولوية الشرع، أولوية الواقع، أولوية الأداة، أولوية الوقت، وأولوية الضرورة.
- استحضار الواقع بأبعاده النوعية والزمانية والمكانية والإنسانية (المحلي، الإقليمي، الدولي) وفهم التداخل والتفاعل بينها.
- توظيف قدرة تحليلية تفسيرية في إطار فقه الواقع وفقه التنزيل، مع مراعاة المآلات وحسن اختيار الوسائل والآليات التي تحقق الغايات والمقاصد.
- الالتزام بالقيم في جميع المراحل، إذ لا يُصان الدين إلا بالعدل والمساواة والحرية والمسؤولية، ولا تُحفظ النفس إلا بمنظومة قيم، وكذلك الحال في حفظ العقل والمال.
واختتمت الورقة ببيان أن المكر الكبَّار الذي يتعرض له السودان وأهله، تقوم عليه مؤسسات وهيئات ودول، وتتشعب أدواته وطرائقه ومجالاته، وتجتمع لخدمته عقول إستراتيجية ومراكز بحثية وفكرية، وكل ذلك لا يضر أهله شيئًا إذا أحسنوا مواجهته وأعدوا له العدة.
المحور الثاني: رفع الواقع الراهن: سياسيًّا، عسكريًّا، ومعيشيًّا، وعرض القوى الفاعلة:
عُرض هذا المحور من خلال ورقة البحثية معمقة أعطت توصيفًا شاملًا للواقع الراهن في السودان، من خلال عرض أبعاده السياسية والعسكرية والمعيشية، إضافة إلى تحليل القوى الفاعلة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وذلك على النحو التالي:
1-أكدت الورقة أن السودان يمر بمرحلة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها أزمات متعددة، أبرزها الأزمة العسكرية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تدخلات متشابكة من أطراف محلية وإقليمية ودولية، ورغم وجود حكومة قائمة، فإن الطريق نحو الاستقرار ما يزال طويلًا، ويتطلب عقلًا إستراتيجيا قادرًا على صياغة الرؤية وإدارة التحديات، وفي هذا السياق، تبرز القوى الإسلامية كفاعل مؤثر يسعى لتقديم حلول عملية تُرفع إلى مؤسسات الحكم.
2- المشهد السياسي:
أوضحت الورقة أنه منذ مايو الماضي 2025م تولّى الدكتور كامل إدريس رئاسة الحكومة، واختار فريقًا من الكفاءات يبدو حتى الآن متوافقًا مع متطلبات المرحلة، وقد انعكس ذلك على تحسن أداء الحكومة نسبيًّا، وحصولها على دعم الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى دعم محلي وإقليمي.
كما لفتت الورقة إلى أن قوى “الحرية والتغيير” برزت كطرف داعم لقوات الدعم السريع، لكن قوتها الشعبية تراجعت بمرور الوقت، وفي المقابل، برز التيار الإسلامي كقوة شعبية مقاومة وفاعلة، وأشارت أيضًا إلى أن العلاقة بين الجيش والحكومة تتأثر بتدخلات مجلس السيادة، بما يفرض واقعًا سياسيًّا مركَّبًا.
3-الواقع العسكري:
أكدت الورقة أن الجيش السوداني استعاد زمام المبادرة في معظم مناطق البلاد، باستثناء إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، وفي المقابل، تتراجع قوات الدعم السريع ميدانيًّا وشعبيًّا نتيجة ارتكابها جرائم ممنهجة، مما يضعف فرصها في أي مفاوضات مستقبلية مع الجيش.
وأبرزت الورقة تنامي القوى الشعبية المقاتلة الداعمة للجيش، وانضمام أعداد كبيرة من الشباب إلى صفوفها. وأوضحت أن الجيش يقاتل باحترافية في مختلف الجبهات، بينما تسعى قوات الدعم السريع لمحاصرة مدينة الفاشر لإعلانها عاصمة لها، وقد دفع ذلك الجيش والقوى الشعبية إلى الدفاع عنها بشراسة، رغم صعوبة الأوضاع المعيشية، والاعتماد على الإمداد عبر الإسقاط الجوي.
4- الواقع الاقتصادي والمعيشي:
بيّنت الورقة أن المؤسسات الاقتصادية والبنكية شهدت حالة انهيار كبير انعكست على الوضع المعيشي، إلا أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور، حيث بدأ البنك المركزي في استعادة دوره، كما أوضحت أن الإنتاج الزراعي شهد نموًّا ملحوظًا رغم ظروف الحرب، غير أن الحكومة لم تضع حتى الآن رؤية اقتصادية واضحة.
5- القوى الفاعلة داخليًّا:
- الجيش السوداني: القوة الرئيسة التي استعادت السيطرة على معظم البلاد، وتمتلك بنية عسكرية متماسكة رغم طول أمد الصراع.
- المقاومة الشعبية: تنامت بشكل ملحوظ، ويشير اعتقال “المصباح أبو زيد” قائد فيلق البراء في مصر إلى تصاعد قوتها، مدعومة بقطاعات واسعة من الشعب السوداني، مما يجعلها عنصرًا مهمًّا في موازين القوة.
6-القوى الفاعلة إقليميًّا ودوليًّا:
- مصر: نظر إلى السودان باعتباره عمقًا إستراتيجيا وأمنًا قوميًّا مباشرًا، خاصة مع ارتباطه بمسألة مياه النيل، وتسعى حاليًّا لتعزيز دورها في ملف إعادة الإعمار بما يضمن بقاء السودان ضمن دائرة نفوذها التقليدية.
- دول الجوار (إثيوبيا وكينيا): اتسم موقفهما في بداية الأزمة بالعداء الحاد تجاه الجيش السوداني، مدفوعًا بمصالح جيوسياسية تتعلق بترسيم الحدود والنفوذ الإقليمي، غير أن الانتصارات العسكرية الأخيرة للجيش دفعت هذه الدول إلى خفض لهجتها والاكتفاء بالمراقبة، في محاولة لتجنب الدخول في صدام مباشر مع الخرطوم.
- الاتحاد الإفريقي: قدَّم دعمًا سياسيًّا واضحًا للحكومة السودانية، وأسهم في تعزيز شرعيتها على المستوى القاري، ما منحها غطاءً دبلوماسيًّا في مواجهة الضغوط الغربية.
- الإمارات: تعد الممول الرئيس لقوات الدعم السريع بالسلاح والمال، مدفوعة برؤية إستراتيجية تهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة القرن الإفريقي وتأمين مصالحها التجارية والموانئ، ما جعلها طرفًا محوريًّا في إطالة أمد الصراع.
- قطر: انحازت بوضوح إلى الجيش السوداني، مدفوعة بعلاقاتها التاريخية مع التيار الإسلامي، وقدمت دعمًا سياسيًّا وإعلاميًّا وماليًّا لتعزيز موقعه في مواجهة الدعم السريع.
- تركيا: دعمت الجيش السوداني، مدفوعة برغبتها في الحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي في السودان، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والبحري.
- الجزائر: قدّمت دعمًا مباشرًا للجيش عبر مشاركة طيرانها في معارك المثلث الحدودي المشترك بين السودان ومصر وليبيا، وتستند هذه الخطوة إلى موقف سياسي مشترك معادٍ للإمارات، ورغبة في دعم حكومة تعتبرها الجزائر قريبة من خطها السياسي في قضايا الأمن الإقليمي.
- السعودية: حاولت لعب دور الوسيط بين الأطراف السودانية، لكنها لم تحقق نجاحًا حقيقيًّا، كما أنها لم تفعل دورها جديًّا ضمن مجموعة “الرباعية” (أمريكا، الإمارات، السعودية، مصر)، ويرتبط ذلك بحساباتها المعقدة في التوازن بين حلفائها الإقليميين.
- إيران: دخلت في تفاهمات أولية مع السودان قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، لكنها لم تكتمل بسبب الحرب واشتغال طهران بملفاتها الإقليمية بعد ذلك، خاصة في اليمن ولبنان.
- التطبيع مع إسرائيل: تمارس بعض القوى الإقليمية ضغوطًا كبيرة على رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، لفتح سفارة إسرائيلية في الخرطوم، في إطار مسار التطبيع الذي بدأ منذ عهد عمر البشير. وحتى الآن، يتبنّى البرهان الموقف الذي أوصت به الحركة الإسلامية سابقًا، وهو “التعايش دون صدام“، أي عدم الاعتراف الرسمي وعدم الرفض المباشر.
- روسيا: تحافظ على علاقات إستراتيجية مع السودان، مدفوعة برغبتها في تعزيز وجودها في البحر الأحمر والحصول على امتيازات لوجستية وعسكرية.
- الصين: تواصل شراكتها العميقة مع الجيش السوداني، وتقدم دعمًا في مجالات الطيران العسكري وتطوير الصناعات الحربية، بما في ذلك تصنيع الذخائر داخل السودان، وهو ما يمنح الجيش هامشًا أكبر من الاكتفاء الذاتي في التسليح.
المحور الثالث: جملة السياسات السودانية الداخلية والخارجية لمواجهة التحديات القائمة:
عُرض هذا المحور من خلال ورقة بحثية عالجت الوضع الراهن في السودان، الذي يمر بمرحلة مفصلية تتسم بتحديات متراكمة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقد بينت الورقة أن هذه التحديات نشأت نتيجة صراع داخلي مدمر اندلع في أبريل 2023، أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتزايد التدخلات الأجنبية، وهدفت الورقة إلى تحليل أبرز هذه التحديات واقتراح سياسات داخلية وخارجية تسهم في احتواء الأزمة واستعادة الدولة.
أولًا: أزمات الدولة القُطرية الحديثة: تتأصل الأزمة السودانية في تحديات بنيوية تواجه الدولة القُطرية الحديثة، وتشمل:
- أزمة الهوية القومية والثقافية.
- أزمة السيادة والتبعية، خاصة في سياق المحتل.
- أزمة التنمية ونماذجها.
- أزمة الاستقرار السياسي.
- أزمة المواطنة وغياب المشاريع والرؤى الجامعة.
ثانيًّا: التحديات الراهنة التي تواجه الدولة السودانية:
- الحرب الجارية وتحديات الوحدة وتماسك الدولة: يشهد السودان حربًا طاحنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تتداخل فيها الأبعاد الإقليمية والدولية مع البعد الداخلي، امتدت الحرب إلى غالبية ولايات البلاد، مدمرة البنى التحتية والنسيج الاجتماعي، وقد أفضت إلى تحول بعض المناطق إلى سلطة أمر واقع بيد الجماعات المسلحة، مما يرفع احتمالات تفكُّك الدولة السودانية.
- الانهيار الاقتصادي وغياب التنمية: تدهورت المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل حاد، مسجلة انخفاضًا قياسيًّا في قيمة العملة، وارتفاعًا في معدلات التضخم. كما شهد النشاط التجاري شبه توقف، ونزوحًا لرؤوس الأموال، مما عمَّق حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي لملايين السكان.
- الكارثة الإنسانية والفراغ الخدمي: تسببت الحرب في أكبر أزمة نزوح قسري في إفريقيا حاليًّا، حيث تجاوز عدد النازحين داخليًّا وخارجيًّا 10 ملايين شخص، يترافق ذلك مع غياب الرعاية الصحية، وتعطيل التعليم، وانهيار البنى التحتية، وتقييد عمل المنظمات الإنسانية.
- غياب المشروع الوطني والشرعية السياسية: عجزت القوى الوطنية عن التوافق على صيغة للحكم الانتقالي منذ سقوط نظام البشير، وتفاقم الوضع مع الإجراءات العسكرية التي عطلت الوثيقة الدستورية. أسفر ذلك عن غياب الشرعية الدستورية والسياسية وانعدام الثقة بين الفاعلين، ولم ينشأ توافق سياسي بعد الحرب على طبيعة المرحلة الانتقالية وقيادتها.
- التدخلات الإقليمية والدولية: غدا السودان مسرحًا لصراع النفوذ بين قوى خارجية، عبر الدعم المباشر للميليشيات أو المواقف السياسية المنحازة، ووجود مرتزقة أجانب (مثل الكولومبيين والتشاديين) يقاتلون في الصراع، وقد أدى ذلك إلى تدويل الأزمة وتقويض سيادة الدولة، وتشمل القوى الدولية والإقليمية الفاعلة بشكل رئيس الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا.
- تحديات إعادة البناء والتعمير وتأهيل الإنسان: دمرت الحرب جزءًا كبيرًا من العمران والبنيان وألحقت أضرارًا جسيمة بالقدرات البشرية، مما يتطلب كفاءات عالية وجهودًا هائلة لإعادة السودان إلى ما كان عليه قبل الحرب ومواصلة نهضته.
ثالثًا: السياسات المقترحة لمواجهة التحديات: تقدم الورقة مجموعة من السياسات المتكاملة لمواجهة هذه التحديات، تشمل:
- السياسات الأمنية والعسكرية:
تحقيق انتصار حاسم يقطع الطريق أمام كافة احتمالات تقسيم الدولة أو تفككها، سواء عبر العمل العسكري أو الترتيبات السياسية والعلاقات الخارجية.
التحرير الكامل وإعادة التعمير لضمان سيادة الدولة على أراضيها ورعايتها لمواطنيها.
عدم التفريط في المقاومة الشعبية التي برهنت على فاعليتها، في ظل مساعي القوى الخارجية لتجريد الشعب السوداني من قوته.
حل ودمج الميليشيات التابعة للحركات المسلحة لتجنب تجدد مشاكل شبيهة بقوات الدعم السريع.
- السياسات السياسية والدستورية:
إطلاق حوار وطني شامل يستوعب كافة الأطراف المدنية والانتقالية والمسلحة والمجتمعية، لوضع أسس الحكم وتشكيل حاضنة سياسية جديدة للمرحلة الانتقالية.
صياغة مشروع وطني جامع ينطلق من الهوية والثقافة السودانية، بعيدًا عن المشاريع المستوردة.
إعداد وثيقة دستورية جديدة ترتكز على مبدأ مدنية الدولة، وتراعي التنوع الإثني والجهوي، وتوزيع السلطة، مع تجنب عسكرتها.
إجراء انتخابات حرة وفق سجل انتخابي موثوق بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- السياسات الاقتصادية:
وضع خطة طوارئ اقتصادية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس الاستقرار النقدي والإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار.
تفعيل آليات الحوكمة المالية لمكافحة الفساد، وإصلاح الجهاز المالي والضريبي، وتفعيل دوره التنموي.
تجنب الانخراط في سياسات البنك الدولي وتبعياته، والعمل على زيادة الإنتاج وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
- السياسات الخارجية:
اتباع نهج الحياد الإيجابي وتجنب الانخراط في محاور متصارعة، مع تعزيز العلاقات الإستراتيجية المتوازنة التي تخدم المصالح السودانية.
ضبط الحدود ووقف تهريب السلاح عبر آليات أمنية إقليمية وتعاون استخباراتي.
تفعيل الدبلوماسية السودانية لحشد الدعم الإنساني والسياسي دون التفريط في السيادة.
- السياسات الإنسانية والاجتماعية:
إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتهيئة البيئة الآمنة لعودة النازحين واللاجئين.
تعزيز الجهود الإغاثية بالشراكة مع المنظمات الدولية، وضمان وصول المساعدات للمتضررين.
مصالحة مجتمعية شاملة على المستوى الأهلي، كفيلة بإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب وترسيخ قيم التعايش.
سياسات متعلقة بالحركة الإسلامية:
إعادة تقييم تجربة الحكم في السودان خلال العقود الثلاثة التي حكمت فيها الحركة الإسلامية، وتحديد مواطن الضعف والقوة.
وضع إستراتيجية جديدة تتناسب مع الواقع الجديد، وتبني على منجزات الماضي وتتجاوز سلبياته، نحو أفق جديد للمستقبل وفق الخارطة الجديدة.
إعادة الوحدة بين مكونات التيار الإسلامي كمدخل لفاعلية الإسلام في الحياة السودانية.
وضع إستراتيجية متوازنة تراعي تطلعات المكون العسكري في الحكم والمشاركة، وتؤسس للحياة السياسية وفق التصور الإسلامي الراشد بعيدًا عن هيمنة أصحاب النفوذ المالي والعسكري والقبلي.
تؤكد الورقة في ختامها أن مواجهة التحديات التي تهدد كيان الدولة السودانية تتطلب إرادة سياسية جادة، ومشروعًا وطنيًّا وإسلاميًّا جامعًا، وسياسات متكاملة تتسم بالاستقلالية والمرونة والعدالة، وتحقيق انتصار شامل ينهي الحرب، ويحقق العدالة، ويعيد بناء المؤسسات، ويحقق النهضة والتنمية، وإلا سيظل السودان عالقًا في دوامة الانهيار والعنف، معرضًا لمزيد من التدخلات الخارجية والتفكك الداخلي.
المحور الرابع: الدور العلمائي لمستقبل السودان:
تُقدِّم الورقة الخاصة بهذا المحور تحليلًا معمقًا للأسباب الجذرية التي تقف وراء الأحداث الراهنة في السودان، مع تسليط الضوء على التحديات البالغة التي تواجه الوسط العلمائي، واقتراح مجموعة من الوسائل والآليات العملية لمعالجة هذه التحديات الجسيمة.
مقدمة: أسباب ما يحدث في السودان:
تُرجع الورقة الأوضاع الحالية في السودان إلى عدة جوانب رئيسة مترابطة، تُشكل مجتمعةً السياق الكلي للصراع الدائر:
- فرض التغريب على السودان والقضاء على الحركة الإسلامية داخله: يُعدُّ هذا الجانب الأساسي من الأسباب، حيث يشمل مساعي حثيثة لفرض النماذج الثقافية والاجتماعية الغربية على المجتمع السوداني، مع سعي مقصود للقضاء على أي حراك أو تيار إسلامي فاعل داخل البلاد.
- الهيمنة على موقع السودان الإستراتيجي والخطير: تبرز أهمية السودان الجيوسياسية كونه يقع على طرق النقل البحرية والتجارية الحيوية، ويمثّل البوابة الرئيسة لنشر الحضارتين الإسلامية والمسيحية في العمق الأفريقي. هذا الموقع الإستراتيجي يجعله محط صراع محتدم بين القوى العالمية، خاصة في ظل التنافس المحتدم بين الصين والغرب للسيطرة على نفوذ الداخل الأفريقي.
- نهب موارد السودان واستنزاف ثرواته، وتمكين قيادات سودانية عميلة مستوردة من الخارج: يتضمن هذا السبب استغلالًا مكثفًا لثروات السودان الطبيعية ونهبها، مع تسهيل ذلك من خلال تمكين قيادات سودانية “عميلة” و “مستوردة من الخارج” -مثل “قحت” التي تتصدر المشهد- بهدف مساعدة القوى الإقليمية والدولية على تحقيق هذا النهب والابتزاز المنظم.
- تفكيك السودان سياسيًّا ومناطقيًّا واجتماعيًّا: يمثل هذا التفكيك جزءًا من مخطط عام يستهدف تقسيم السودان سياسيًّا ومناطقيًّا واجتماعيًّا، وهو مخطط يمر به جميع دول الإقليم. ومع ذلك، أكدت الأحداث أن جيش السودان، بتلاحمه مع شعبه الناضج بمختلف أطيافه الإسلامية والوطنية، قد شكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق هذا المخطط. وفي هذا السياق، برز دور إيجابي للعلماء والدعاة من خلال الاتحاد السوداني للعلماء والدعاة والمنابر الإعلامية والمؤتمرات والبرامج، في ترسيخ وعي الأمة وتوجيه بوصلة المجتمع نحو الثوابت الدينية والوطنية.
التحديات التي تواجه الحالة العلمائية في السودان:
تُشير الورقة إلى أن غياب الدور الفاعل للعلماء في مرحلة ماضية قد أفضى إلى تجاذبات خطيرة، فضلًا عن تحديات مجتمعية وعلمائية أخرى:
تحديات سابقة ناتجة عن غياب الدور العلمائي:
- شدة الخلاف بين الحالة السلفية والحالة الصوفية: وصل هذا الخلاف إلى درجة أن بعض غلاة المتصوفة التقى بمسؤولين من البيت الأبيض والكونجرس ووزارة الدفاع الأمريكية، مدعين أن الصوفية هي الإسلام الحقُّ.
- علو صوت غلاة المداخلة الجامية: برزت أصوات غلاة المداخلة الجامية، وشاركوا خلال الحرب في الترويج لمشروع الإمارات، بدعم من “حمديتي”.
- الانشطار والتشظي داخل الجماعات الدعوية: تفككت الجماعات الدعوية وانقسمت، حتى أن الجماعات التي كانت متماسكة عصية على الانقسام لم تسلم من ذلك.
- حدوث جمود دعوي: نتج هذا الجمود عن ترسيخ المؤسسات الدينية على أساس المحاصصة السياسية بدلًا من الكفاءة العلمية والدعوية، وهي آفة قديمة.
- الغارة اليسارية على بعض المؤسسات الدعوية: تعرضت مؤسسات دعوية مثل منظمة الدعوة، وجامعة أفريقيا، وجمعية القرآن الكريم، وهيئة الدعوة الشاملة، لهجمة يسارية خلال فترة انقلاب 2019 وحتى وقت قريب.
- انزواء العديد من الدعاة عن الساحة: ابتعد الكثير من الدعاة عن الظهور العام وتوجيه الرأي العام، خوفًا من التصنيف وعواقبه، مما أدى إلى حالة من الفراغ بين “جلد الفاجر وعجز الثقة”.
- إلحاح بعض الأطراف الإقليمية للتعجيل بضرب الحركة الإسلامية: كانت هناك ضغوط إقليمية مكثفة لتسريع ضرب الحركة الإسلامية وتقليص دورها، على غرار ما حدث في دول مجاورة.
- الرعب الحاصل لدى أطراف كثيرة بسبب عودة الروح الجهادية: حيث شعرت أطراف عديدة بالرعب من عودة الروح الجهادية لدى فئات من الشباب المسلم في السودان بعد اندلاع حرب 2023.
تحديات مجتمعية وعلمائية أخرى:
- تهتك النسيج الاجتماعي: حيث تمزق النسيج الاجتماعي بصورة غير معهودة على طبيعة الشعب السوداني؛ وذلك بفعل الحرب التي اتخذت في بعض مراحلها طابعًا قبليًّا، مما أفضى إلى التباغض والتدابر بين مكونات المجتمع.
- ظهور علل وأمراض لم تكن مألوفة: فبرزت أمراض اجتماعية غير معهودة، مثل انتشار الفحش والتفحش في الخطاب العام، والجرأة على معاداة الدين وسبِّه أحيانًا، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- علو صوت المنظمات النِسوية: حيث ارتفعت أصوات المنظمات النسوية الداعية إلى التحرر من السلطة الأبوية، والمطالبة بالانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المصادمة للشريعة الإسلامية.
- التشكيك في ثوابت الدين: وشمل ذلك التشكيك في أصول الدين، مثل إنكار السنة والتشكيك في صلاحية الشريعة.
- الفقر المدقع: حيث تعاني قطاعات واسعة من المجتمع من فقر مدقع، بدأت بوادره مع رفع الدعم عن السلع الأساسية أيام حكومة قوى الحرية والتغيير (“قحت”).
- شيوع المشاركة في جرائم الحرب: فانتشرت المشاركة في جرائم الحرب، مدفوعة برغبات الانتقام أو الانتماء الحزبي والجهوي.
- غياب المؤسسات العدلية: وهي وحدها القادرة على إنصاف المظلوم وردع الظالم، مع ذكر المحكمة الدستورية كمثال على ذلك.
- تجريف الكثير من القيم الدينية والأعراف الصحيحة: فتعرضت العديد من القيم الدينية والأعراف السليمة في العلاقات الزوجية والأسرية، وكذلك بين المعلمين والتلاميذ، وبين الوالدين والأولاد- تعرضت كلها للتجريف.
- هجرة الكثير من الكفاءات العلمية والدعوية: فهاجر عدد كبير من الكفاءات العلمية والطاقات الدعوية، إما بسبب الحرب أو المطاردة، أو بحثًا عن عيش كريم، مما أدى إلى تصدر ممن لا يحسنون القول ولا العمل.
الوسائل والآليات المقترحة لمعالجة التحديات:
تقترح الورقة مجموعة من الوسائل والآليات الضرورية للنهوض بالدور العلمائي ومعالجة التحديات السابقة:
- تفعيل العمل الدعوي المشترك بين الجماعات الإسلامية: وذلك بمشاركة الرموز الكبيرة في أعمال مشتركة لترسيخ مبدأ الوحدة الإسلامية عمليًّا، وجمع الناس على كلمة سواء تلتقي فيها الثوابت المشتركة التي لا خلاف عليها.
- إحياء دور الأوقاف الإسلامية ولمُّ شتاتها واسترداد ما سُلب من ممتلكاتها الكثيرة: وهذا يسهم في سد العوز ومواجهة الفاقة، خاصة بعد الحرب الطاحنة التي أفقرت كثيرًا من الناس.
- تشكيل هيئات علمائية ودعوية على أسس صحيحة: مثل هيئة الفقه الإسلامي، وهيئة الدعوة الإسلامية، وهيئة تزكية المجتمع، لتقوم بدور فاعل في الدعوة إلى الله تعالى.
- الضغط على الدولة لإعادة عمل المنظمات الخيرية والهيئات المجتمعية: والتي كانت تقوم بدور كبير في سد حاجة الناس وترميم الفتق الناتج عن غياب الدولة عن كثير من الملفات المعيشية.
- العمل على سن القوانين المجرِّمة لكل نشاط يراد منه تعميق الخلاف بين المسلمين: وذلك بإحياء القوانين التي تمنع العصبيات المذهبية والعقدية والحط من رموز الأمة القدامى والمحدثين، وتذكر الورقة مثالًا من عهد الإنقاذ حيث سُنَّ قانون يعاقب بالإعدام من يتناول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بتوصية من مجمع الفقه الإسلامي، حين اشتد أوار المدِّ الرافضي.
- التأكيد على وحدة الأمة الإسلامية وخطورة الفرقة: ووجوب ترسيخ مفهوم أن على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة كما أراد الله لهم، وأن تفرقهم وتشرذمهم حرام، وأن العدو يحرص على تمييزهم وتفريقهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم. ويؤكد أن كل من أعان على ذلك فقد خدم أعداء الإسلام، كما يجب على الناس تناسي خلافاتهم الفقهية والحزبية والقبلية في زمن أصبح فيه كل مسلم مستهدفًا من أجل إسلامه.
- وجوب العمل على رفع مستوى الأئمة والدعاة ماديًّا ومعنويًّا: ماديًّا بإلزام الدولة بتوفير كادر وظيفي لهم يضمن لهم أجرًا يوازي أجور غيرهم من خريجي الجامعات، ومعنويًّا بعقد الدورات التأهيلية وورش العمل التدريبية.
- إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لمواجهة التفسخ الأخلاقي والخلل القيمي الذي حدث في الفترة الماضية.
- البيان الجلي للأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل الناتجة عن الحرب: ككيفية التعامل مع اللصوص المحاربين، والبغاة الخارجين على الدولة والمجتمع، والأموال مجهولة المالك.
- تمييز العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس شرعية: بتقديم النصح لهم برفق ورحمة، مع توقيرهم ومعرفة حقهم، وعدم متابعتهم في الباطل أو تزيين المنكر لهم، بل لا بد من الإنكار عليهم بالطرق الشرعية وبيان الحق لهم، والحرص على أمرهم بالمعروف.
تُختتم الورقة بالتأكيد على أن حجم الخلل كبير والواجب الملقى على عاتق الأمة عظيم، وأن أعداء الملة والوطن لا يتوقفون عن الكيد للإسلام وأهله ليلًا ونهارًا، مما يستلزم تضافر الجهود ومضاعفة العمل، ورغم التحديات والمصاعب، تحققت نجاحات ملموسة بفضل جهود هيئات علمية مهمة على رأسها الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، من خلال المؤتمرات والبرامج الإعلامية والمنابر المختلفة، مثل تنظيم ورش تثقيفية وخطب توجيهية في المساجد، والتي أسهمت في تعزيز وعي المجتمع، وترسيخ الثوابت الإسلامية والقيم الوطنية، ومواجهة محاولات التشويش الفكري والاجتماعي مما يؤكد على لزوم مواصلة الجهود من قبل الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة وبقية الهيئات الإسلامية لتحقيق الاستقرار الفكري وتعزيز القيم الدينية.
مناقشات حول الأوراق المقدمة:
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من القضايا الإستراتيجية المرتبطة بالحالة السودانية الراهنة، مركزًة على أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، مع التركيز على دور الحركة الإسلامية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقد أبرزت المناقشات عدة محاور رئيسة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1-الوضع العسكري ومستقبل المعارك في السودان:
ركزت المناقشات على أسباب تقدم الجيش في إقليم كردفان ومستقبل السودان في ظل حصار مدينة الفاشر الإستراتيجية، وأكد المشاركون أن طبيعة المرحلة خلال الحرب تفرض على الجيش الانتقال من مرحلة الاستنزاف لقوات الدعم السريع إلى مرحلة التمركز وإعادة البناء العسكري، ما يستلزم فترة محددة من التوقف النسبي قبل شن هجمات جديدة، كما أظهرت المعلومات المقدمة أن الجيش الآن يعمل باحترافية عالية، مستفيدًا من إدخال تقنيات متقدمة بما في ذلك الطيران المسير، وهو ما قد يوحي للمتابعين بأن المعركة غير متحركة، رغم التحركات الإستراتيجية الدقيقة.
2- دور التيار السلفي السعودي وتأثيراته:
أبرز النقاش الدور الذي يقوم به أحد مكونات الحركة الإسلامية، المتمثل في التيار السلفي السعودي، وركز على بدايات هذا التيار واستقطاب الاستخبارات السعودية لطلاب ودعاة جدد، ما جعله يتبع الموقف السعودي الرسمي.
وأوضح المشاركون أن معالجة هذا التيار يجب أن تنطلق من الاعتماد على منطق الدعوة للتجرد والإخلاص، وزيادة الوعي الديني والسياسي بين أتباعه، مع الإشارة إلى الجهود الناجحة التي تحققت في هذا الإطار، والتي يمكن الاستفادة منها في صياغة برامج التوعية والقيادة المجتمعية.
3-مسارات إستراتيجية للمرحلة القادمة:
أكدت المناقشات على ضرورة التركيز على ثلاثة مسارات مركزية في النظر إلى الحالة السودانية:
- المسار الأول: الاستفادة من التجارب السابقة، مع مراعاة خصوصية السودان، فلكل تجربة عمومها الذي يمكن الاستفادة منه بجانب جوانب خصوصها المستقل.
- المسار الثاني: التفكير الإستراتيجي في مستقبل السودان، ورسم خريطة الفاعلين الرئيسة بما يضمن الانتقال إلى مرحلة البناء والإعمار ما بعد الحرب، وهي مهمة أساسية للعقل الإستراتيجي السوداني.
- المسار الثالث: تأسيس نويات للعقل الإستراتيجي في السودان، والعمل على تشبيك هذه النويات للوصول إلى تكوين “عقل إستراتيجي جامع للأمة”، وهو أحد الأهداف الأساسية لمركز رؤيا.
4-القضايا الجوهرية في المرحلة الانتقالية:
أشار الحضور خلال الورشة إلى ضرورة حسم ثلاث قضايا رئيسة خلال المرحلة الانتقالية:
- الموقف الشرعي من الدولة الحديثة.
- العلاقة مع المؤسسة العسكرية ودورها في قيادة السودان.
- الموقف من التطبيع مع إسرائيل.
وشدد المشاركون على أن معالجة هذه القضايا بشكل مبكر يُعد شرطًا أساسيًّا لضمان استقرار العملية الانتقالية وتجنب الانقسامات الداخلية.
5-التحولات العالمية وتأثيراتها على السودان:
تناول النقاش تأثير التغيرات العالمية والتحولات الإقليمية على الوضع الداخلي السوداني، مؤكدًا أهمية مراعاة الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية عند رسم الرؤية الإستراتيجية للحركة الإسلامية، بما يضمن توافقها مع مصالح السودان الوطنية ويجنبها الانجرار خلف تأثيرات خارجية ضاغطة.
6- جذور الإشكالات في المشهد السوداني:
تطرق النقاش إلى جذور الإشكالات في السودان، بما في ذلك الانتهاكات العنيفة التي ترتكبها بعض المكونات، والتي تتناقض مع طبيعة الشعب السوداني الهادئة، إضافة إلى المشكلات المتكررة داخل الصف الإسلامي، مثل الاستئثار بالحكم، التسلط، والانقسامات الداخلية أو القابلية للتفرق، وأكد المشاركون على ضرورة معالجة هذه القضايا بشفافية لضمان وحدة الصف وتعزيز مصداقية الحركة الإسلامية داخليًّا وخارجيًّا.
7-دور السودانيين في الخارج:
أكد النقاش أهمية تفعيل دور السودانيين في الخارج، باعتبارهم عنصرًا فاعلًا في دعم المعركة الوطنية ضد التدخلات الخارجية، وتوظيف خبراتهم ومواردهم في حسم الصراع وتعزيز فرص النصر والاستقرار.
9-مراجعة دور العقل الإستراتيجي في السودان:
أشارت المناقشات إلى غياب العقل الإستراتيجي خلال الفترة السابقة، والاعتماد في فترات كثيرة على العقل الجزئي المتكيف مع الظروف الطارئة بدلًا من العقل الإستراتيجي بأنواعه: التراكمي والجمعي والموسوعي والشوري، وأكد المشاركون على ضرورة تطوير هذا العقل الإستراتيجي، بدءًا من سؤال الأخلاق، الذي ينبغي أن يكون المعيار الأساسي للحركة الإسلامية السياسية، مرورًا بسؤال الهوية والحرية المتلازمين بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى صناعة الأدوات العملية التي تحقق الأهداف الإستراتيجية.
المحور الخامس: الدور الإقليمي السوداني والمثلث الإستراتيجي (مصر-ليبيا-السودان):
عُرض هذا المحور المُركز بمقدمة تشير إلى أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في إطار نظام معقد، يختلف جذريًّا عن الأنظمة التقليدية، ومن أبرز سمات هذا النظام المعقد:
1-الانفتاح والانكشاف الإستراتيجي:
يُعد النظام مفتوحًا، وتتعدد فيه المؤثرات الداخلية والخارجية، مع حالة الانفتاح الكبيرة في التقنيات الحديثة، مما يجعل السودان والدول الفاعلة فيه دائمًا في حالة انكشاف إستراتيجي أمام القوى الأخرى، ويستلزم ذلك تطوير أدوات دقيقة للرصد والتحليل واتخاذ القرار الإستراتيجي.
2-التشابك بين الفاعلين والمؤثرين:
تتداخل العلاقات بين الفاعلين في المشهد السوداني بشكل كبير، فمثلًا قوات الدعم السريع تتعرض لضغوط متبادلة من المثلث الحدودي بين مصر وليبيا، بينما تتعاون طائرات الجزائر مع الجيش السوداني في مواجهة الدعم الإماراتي، ويتشابك عدد من القوى الإقليمية الأخرى في الملف السوداني، هذا التشابك يعكس طبيعة العلاقات المتعددة الأبعاد التي تجعل أي تدخل أو تحرك محلي أو إقليمي يتأثر بعوامل خارجية متداخلة.
3- الاعتبار والتعلم من سنن الله في الكون:
إن سنن الله في الكون لا تحابي أحدًا، فهي قوانين ثابتة تجري على الأفراد والأمم، ومن يتأملها بوعي يجد فيها البوصلة الحقيقية للحركة نحو التغيير، وإن الاعتبار بما جرى ويجري من حولنا هو واجب سياسي وحضاري، يدفعنا إلى قراءة الواقع بعمق، وتفادي أخطاء الماضي، وبناء وعي جمعي قادر على قيادة الأمة نحو النهوض المنشود.
كل هذه السمات تفرض إنضاج نموذج تفسيري قادر على استيعاب هذا الواقع المتشابك، وهذا يستلزم تنوعًا واسعًا في التخصصات والمعارف، بحيث يشمل التحليل السياسي، الاقتصادي، العسكري، والاجتماعي معًا، ولابد من التفكير في هذا المثلث الإستراتيجي؛ (السودان – مصر – ليبيا) بطريقة شاملة، تهدف إلى بناء سردية خاصة بالأمة، عبر معرفة دقيقة بالعلاقات بين الأطراف المختلفة، وإقامة حوار مستمر بين العقول الإستراتيجية المهتمة بهذا الشأن، لضمان الوصول إلى حلول عملية.
وخلاصة هذا المحور: إن فهم التعقيدات الإقليمية في المثلث الإستراتيجي السوداني يستدعي عقلًا إستراتيجيًّا جامعًا قادرًا على المزج بين التحليل الواقعي والاستشراف المستقبلي، مع مراعاة التشابك بين القوى المحلية عبر الجهد الجمعي للعقول الإستراتيجية في الدول الثلاث.
المحور السادس السودان بين بناء الدولة وبناء الأمة:
لا سبيل أمام السودان للخروج من أزمته الراهنة إلا عبر تضافر جهود المشاريع الإصلاحية الفاعلة والمؤثرة، وتنسيق أدوارها في إطار جامع يوازن بين مقتضيات بناء الدولة ومتطلبات بناء الأمة.
إن ما يجري في السودان ليس معزولًا عن السياق الإسلامي العام، بل يمثل جزءًا من المشهد الكلي للأمة، الأمر الذي يستوجب استدعاء مفهوم الأمة الإسلامية باعتباره الإطار الأوسع الذي يمكن أن يوجِّه عملية الإصلاح والتماسك في السودان.
خلفية تاريخية لبناء الأمة في السودان:
شهد السودان منذ استقلاله محاولات جادة لتأسيس مقومات وحدة الأمة داخله، فقد أسهمت المؤسسات الدعوية والسياسية والتعليمية في ترسيخ الولاء الديني وتقوية الانتماء المشترك، وأدى النظام التعليمي دورًا مهمًّا في تعزيز الهوية الإسلامية، كما مثّلت الحركات الإصلاحية والدعوية عاملًا رئيسًا في تكوين وعي جمعي موحّد.
غير أنّ هذه الجهود اصطدمت مبكرًا بتحديات الولاءات الجزئية، سواء القبلية أو الجهوية أو الإثنية، ما ولّد صراعات متكررة أضعفت مناعة الدولة وأثّرت على مسار الوحدة الوطنية، ومع مرور الزمن، أصبحت هذه الولاءات السالبة أحد أهم العوائق أمام بقاء السودان موحَّدًا وقادرًا على الصمود أمام الضغوط الخارجية.
الشرخ الاجتماعي في السودان:
أفرزت الحرب الأخيرة جروحًا عميقة في النسيج الاجتماعي، حيث ارتُكبت جرائم ممنهجة ضد فئات واسعة من الشعب السوداني، من قتل واغتصاب وتهجير. هذا الواقع أدّى إلى تعميق الشرخ الاجتماعي، وولّد شعورًا بالغبن لدى شرائح اجتماعية كاملة.
إن تجاوز هذه المرحلة يتطلب:
- تعزيز برامج العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية.
- بناء خطاب جامع يقدِّم الهوية الراسخة للسودان بموروثها الإسلامي على الولاءات الضيقة.
- استعادة الثقة بين المكونات المجتمعية من خلال مؤسسات ذات مصداقية تستند إلى قيم العدل والإنصاف.
التدخل والاختراق الخارجي:
لا يمكن النظر إلى الأزمة السودانية بمعزل عن الأجندات الخارجية، فقد تحوّل السودان إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الإقليمية والدولية، تتقاطع فيها مصالح دول كبرى وإقليمية، كلٌّ منها يسعى لتحقيق نفوذه عبر دعم أطراف معينة على حساب وحدة السودان.
إنّ أخطر ما يهدد السودان في هذه المرحلة هو سيناريو التقسيم، الذي قد يُفرض بفعل ضغوط دولية تستثمر في هشاشة الداخل وتستغل الانقسامات الداخلية، ومن هنا فإن رفع مستوى الوعي الشعبي والنخبوي بمخاطر التقسيم، والعمل على تحصين القرار الوطني، يعدّان واجبين إستراتيجيين في هذه المرحلة.
من بناء الدولة إلى بناء الأمة:
يمثل التوفيق بين مشروع بناء الدولة ومشروع بناء الأمة معضلة فكرية وسياسية في الحالة السودانية، فبينما يسعى كثيرون لحصر الإصلاح في مؤسسات الدولة وبنيتها النظامية والإدارية، فإن الأزمة الراهنة تكشف أنّ بناء الدولة لن ينجح إلا في إطار مشروع أوسع هو مشروع بناء الأمة، ومن ثمّ فإن بناء الدولة السودانية يظل خطوة أساسية، لكنها لا تكتمل إلا في سياق بناء الأمة الإسلامية كإطار أوسع يوجِّه المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فيركز بناء الدولة على:
- إصلاح الهياكل السياسية والإدارية.
- استعادة السيادة على كامل الأراضي السودانية.
- إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
بينما بناء الأمة يتجاوز ذلك ويتسع إلى:
- ترسيخ الهوية الإسلامية الجامعة.
- تحقيق التكامل بين السودان وبقية مكونات الأمة.
- صياغة رؤية إستراتيجية تُعلي من المصلحة المشتركة للأمة الإسلامية.
نحو مستقبل موحد للسودان:
إن مستقبل السودان مرهون بقدرته على تجاوز أزماته الداخلية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات بناء الدولة الوطنية وبين متطلبات بناء الأمة الإسلامية، ولا يتحقق ذلك إلا عبر مشروع إستراتيجي شامل يستند إلى وعي بخطورة التدخلات الخارجية، ويستثمر في مقومات الوحدة الداخلية، ويستحضر البعد الحضاري للأمة كإطار ناظم للعمل. فالسودان ليس مجرد كيان قُطري، بل مكوّن أساسي من مكونات الأمة، واستقراره ووحدته قوة لها جميعًا، وأبرز مهددات وحدة الدولة السودانية تكمن في الإخفاق في المضي قدمًا في مسيرة السلام، حيث تواجه هذه المسيرة عدة عوائق داخلية.
من أبرز هذه العوائق الحاجة إلى تجاوز الحواجز النفسية بين أبناء الوطن الواحد، وإزالة عدم الثقة المتجذرة في النفوس، والعمل على مكافحة خطاب الكراهية، كما يُعدُّ التوافق بين جميع الأطراف الإصلاحية السودانية ضرورة أساسية، وعند معالجة هذه المشكلات الداخلية بشكل شامل، سيكتسب السودان الحصانة اللازمة لحماية وحدته واستقلاله من أي مطامع أو أهداف خارجية.
خاتمة:
خلصت هذه الحلقة النقاشية إلى أن الحالة السودانية بما تحمله من تعقيدات سياسية وعسكرية ومعيشية، تمثل ميدانًا حيويًّا يستدعي بناء عقل إستراتيجي قادر على قراءة الواقع قراءة مركبة، والتعامل مع تحدياته الداخلية والخارجية برؤية بعيدة المدى.
وقد جاءت الأوراق المقدمة لتؤكد أن معالجة التحديات الراهنة تستلزم الانتقال من الجزئي إلى الكلي، ومن الآني إلى الإستراتيجي، في إطار مشروع جامع للأمة.
محور ضرورة العقل الإستراتيجي للحالة السودانية:
تبيّن أن غياب العقل الإستراتيجي الجامع ظلّ أحد أبرز عوامل ضعف التجربة السودانية، حيث غلب منطق الاستجابة اللحظية على بناء الرؤية الشاملة، ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى عقل مركب يستند إلى الاجتهاد الجماعي، ويوازن بين الاعتبارات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية.
محور رفع الواقع الحالي: سياسيًّا وعسكريًّا ومعيشيًّا:
أوضحت الأوراق أن الجيش استعاد زمام المبادرة في معظم الجبهات، بينما تراجعت قوة الدعم السريع ميدانيًّا وشعبيًّا. غير أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا تزال هشّة، مما يفرض ضرورة بلورة خطط إنعاش عاجلة تعيد للمجتمع توازنه وثقته بمؤسسات الدولة.
محور السياسات الداخلية والخارجية لمواجهة التحديات:
جرى التأكيد على أن السودان بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساته السياسية والإدارية بما يضمن وحدة القرار، إلى جانب صياغة سياسة خارجية متوازنة تحفظ السيادة، وتؤسس لتحالفات إستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية الصديقة.
محور الدور العلمائي لمستقبل السودان:
تجلّى بوضوح أن للعلماء دورًا محوريًّا في ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة المجتمعية، وصياغة رؤية شرعية وأخلاقية لمعالجة قضايا محورية مثل الهوية، والعلاقة مع الدولة الحديثة، والموقف من التطبيع.
محور الدور الإقليمي السوداني والمثلث الإستراتيجي (مصر–ليبيا–السودان):
أكدت المناقشات أن هذا المثلث يشكل بعدًا إستراتيجيًّا لا يمكن تجاهله، وأن فهم تشابكاته يفرض رؤية تتجاوز الحدود القُطرية، بما يضمن للسودان موقعًا فاعلًا، ويحول دون استفراد القوى المناوئة بقراره.
السودان بين بناء الدولة وبناء الأمة:
تجاوز الأزمة السودانية لا يتأتى فقط عبر إصلاح الهياكل السياسية والاقتصادية، وإنما لا بد أن يأتي ضمن مشروع أوسع هو مشروع بناء الأمة، الذي يعزز الهوية الإسلامية الجامعة ويحقق التكامل مع بقية مكونات الأمة.
وبذلك خلصت الأوراق إلى أن السودان يقف على مفترق طرق حاسم: فإما أن يظل غارقًا في دوامة أزماته المتكررة، من صراعات سياسية وانقسامات قبلية وحروب أهلية وأزمات اقتصادية خانقة، تعيق حركته وتبقيه أسير واقعٍ مأزوم، وإما أن يلتقط الفرصة ليتجه نحو مشروع استراتيجي جامع، ينطلق من رؤية واضحة تضع حدًا للتشرذم الداخلي، وتجمع طاقات أبنائه على هدف مشترك، يعيد صياغة مستقبله في إطار نهضوي أشمل ليعيد تشكيل مستقبله في إطار رؤية الأمة الإسلامية الكبرى.