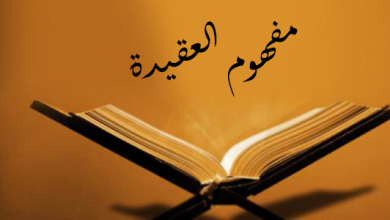القدرات الرمزية للقدس والأقصى

عاش الفكر الإسلامي في القرن الأخير الكثير من الأزمات والإشكالات نتج عنها انزواء وتأخر حضاري للأمة الإسلامية، ودخل المسلم في حالة من الحيرة المطبقة بين عقيدة وشريعة سماوية، ومجتمع مادي وواقع يكاد أن يؤسس لحالة ازدواج وربما انفصام، فظهر على إثرها تيارات فكرية ومعرفية وثقافية مختلفة التوجهات والوجهة لتقدم حل لهذه الأزمة، ومالك بن نبي من أبرز المفكرين “إذا عُدَّ المفكرون من المسلمين في هذا العصر فإن «مالك بن نبي» هو من هذه القلة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؛ فالمفكر هو الذي يدرس ويتأمل ويقارن، ويحلل المشكلة إلى أجزائها، ثم ينسق ويركب ويجتهد في إيجاد الحلول”. الذين قدموا مشروعا حضاريا تحت عنوان “مشكلات الحضارة” للأمة الإسلامية؛ أراد من خلاله طرح بديل فكري لتحقيق النهوض.
فانتقد الحضارة الغربية أفكارا ومعارف، وانتقد مشاريع إحياء العالم الحضاري الإسلامي من خلال الاستعانة أو القابلية لأفكار قاتلة وافدة ومقتبسة من حضارة أخرى في نطاق قانونا للانتظام السنني ضمن معادلة الغالب والمغلوب وقانون الولع في إطار الفكر الخلدوني العمراني، ونحت مالك نظريته المعروفة بالعوالم الثلاث وهي الجمع بين عالم الأفكار؛ وعالم الأشخاص؛ وعالم الأشياء؛ كنظام فكري متوازن يؤسس لنهوض إسلامي معاصر.
كان من أهم إسهامات المفكر مالك بن نبي نظرته ونظريته حول العوالم الحضارية المختلفة عالم الأفكار عالم الكلمات عالم الأحداث عالم الأشخاص عالم الأشياء؛ حاصل هذه العوالم الخمسة في تفاعلها وجدليتها ما بين المبنى والمعنى والمغزى يولد ويخرج عالم الرموز.
واهتم بعض المفكرين والأكاديميين والباحثين بما يسمي بالقدرات الحضارية وعلى رأسها القدرات الرمزية بحيث تشكل حالة رمزية فعالة وإيجابية تسعى لاستثمار الطاقات الرمزية لتقوم بآثارها الدافعة والرافعة للمجتمعات وفعاليتها الحضارية؛ القدرات الرمزية هي القدرة على استخدام وتفسير الرموز، وهي مفهوم واسع يختلف معناه حسب السياق، فيشمل القدرة على التفكير وتوظيف الأفكار المجردة، واستخدام هذه الرموز للتعبير عن الذات والمشاعر، بالإضافة إلى توظيف الرموز في بناء المعاني المجتمعية كالثقافة والأفكار الدينية.
كما يُقصد بها أحيانًا القدرة على خلق أو توظيف الرموز لتوصيل رسائل معينة في السياسة وهي من أهم الرسائل الاتصالية ضمن الوظيفة الحضارية للدولة والمجتمع والكيانات الاجتماعية الحضارية.
ومن ثم تولدت نظريات ونظرات حول ما يمكن تسميته بالتفاعل الرمزي كنظرية اجتماعية تطورت من اعتبارات عملية، وهي تشير إلى استخدام الناس الخاص للغة، لرسم صور ومضامين طبيعية، للاستنباط، والانسجام مع الآخرين. بكلماتٍ أخرى، هو إطار مرجعي لفهم كيفية تفاعل الأفراد مع بعضهم بشكلٍ أفضل لخلق عوالم رمزية، وكيفية تشكيل هذه العوالم بدورها السلوكيات الفردية والجمعية على حد سواء. إنه الإطار الذي يساعد على فهم كيفية المحافظة على المجتمع وخلقه من خلال التفاعلات المتكررة بين الأفراد. تساعد عملية التفسير التي تحدث بين التفاعلات في خلق وإعادة خلق معنى. إنه الفهم والتفسيرات المشتركة للمعنى التي تؤثر على التفاعل بين الأفراد.
يرتكز الأفراد في تصرفاتهم على الفهم المشترك للمعنى ضمن سياقهم الاجتماعي. بالتالي، يُؤطَّر السلوك والتفاعل من خلال المعنى المشترك الذي يرتبطون به مع الأهداف والمفاهيم. انطلاقًا من وجهة النظر هذه، يعيش الناس في بيئات طبيعية ورمزية.
للقدس والمسجد الأقصى رمزية دينية؛ ومن الأهمية بما كان أن نؤكد على عقائدية صراع الأمة مع الكيان الصهيوني؛ يقول الحكيم البشري معضدا المعنى والمغزى حول القدس “عندما نتكلم عن القدس؛ إن القدس ليست (مثلًا) “برلين” بعد الحرب العالمية الثانية التي أمكن لألمانيا أن تستبدل بها “بون” –كما أن القدس ليست “استنبول” التي أمكن للدولة التركية أن تستعيض عنها “أنقرة”.
فالقدس هي القدس التي لا بديل عنها ولا مثيل لها، فهي متوحدة في طابعها وفي أوضاعها. فلا يمكن القول بأن هناك مكانًا آخر يصلح بديلًا عن القدس يستحيل! هذه نقطة؛ النقطة الثانية: أن الوعاء الجغرافي للقدس هو فلسطين، ويستحيل أن نتصور القدس بدون الكيان المسمى فلسطين، فليست القدس هي بيت المقدس، ويستحيل أن نتكلم عن القدس خارج هذا الإطار الذي قامت على أساسه وعاشت به وعشنا معها به على مدى زمني استمر قرونًا طويلة جدًا بقيت في أيدي العرب من أول التاريخ. فلا يمكن تصور القدس معزولةً عن فلسطين، كما لا يمكن الحديث عن فلسطين معزولةً عن إطارها العربي والإسلامي الكامل المحيط بها.
يواصل الحكيم “عندما كنت أقرأ عن القدس وجدتُ ما كُتِب عن قيمتها على جوانب عدة لا تقتصر عن القيمة الدينية الروحية (أول القبلتين وثالث الحرمين، و”أرض المحشر والمنشر”)، بل ظلت القدس ذاتَ قيمةٍ استراتيجية في المنطقة؛ فهي “المدينة الثغر” الذي يمكن أن ينفذ منه العدو إلى الكعبة المشرفة وإلى قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهناك عمق استراتيجي ووحدة المصير دفاعيًّا وعسكريًّا.
إذًا، فالقدس لم تكتسب مكانتها وقدسيتها من الجهة الروحية والدينية فحسب، بل كان الحرص عليها يجمع بين ما هو ديني وما هو دنيوي. أن القدس ميزان المقاومة وميزان عزة هذه الأمة، الأمة حينما تكون في قوتها تكون القدس في عزتها، وحينما تهون النظم العربية والأمة الإسلامية وتتهاون قد تهرول مطبعة ومتراجعة ومنسحبة ومتساهلة ومهدرة للحقوق وهي بذلك تكون في أضعف حالاتها.
بصلة المسلمين الروحية بالقدس، بوصفها أحد الأماكن الثلاثة التي تكوّن جغرافيتهم الروحية إلى جوار مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فلقد اشترك المسلمون وأصحاب الديانات والثقافات الأخرى، في إسباغ القداسة على مكان خاص، وفي تعيين منطقة مرجعية مقدسة، هي ما يُعرف بالجغرافية المقدسة، حيث ينغمر الدنيوي بالمقدس ويرمز إليه، ويشكل هذا جزءاً من التجربة الدينية العميقة للأفراد والجماعات، التي يكوّن الفكر الرمزي بعداً من أبعادها، في التصاق عميق بالشعائر والطقوس، التي تنتمي إلى الحقل الرمزي في الفكر، علينا إضاءة التجربة الإنسانية من رمزية (قداسة المكان). كما يؤكد شمس الدين الكيلاني.
“القدس هي القدس ولا بديل عنها أو لها”. هذه هي القضية الكبرى التي تتعلق بعالم المسلمين وتتعلق بأن وضع القدس منا هو مقياسُ للتحدي والاستجابة والتعامل الاستراتيجي في أمة المسلمين. القدس ليست أول مرة تضيع من أيدي المسلمين، ولا هي المرة الأولى التي يمكن أن تُسترد، وأن وصف الأجيال لمعيار فعلها هو الذي يحدد مكانة القدس منا ومكاننا من القدس. فالقدس هي مكان مفتوح وأفق ممتد للإنسان والإنسانية، تنفتح على الإنسان والعمران، هكذا علمتنا إنسانية الإسلام وحركة العالمية فيه. أما القدسُ بالنسبة للصهيونية؛ فمكان محجوب وأفق انغلاقٍ صهيوني، وعزلها عن الإنسان والعمران هو الذي يؤكد عنصرية الصهيونية وحركة عزلها عنا.
فالقدس “قداسة” و”مقدس”، وهي وصلٌ بين الأرض والسماء؛ إن عملية الإسراء والمعراج إنما تؤكد معاني شد الرحال وشد روابط الوثائق والصلة بين المساجد الثلاثة: المدينة، وبيت الله الحرام، والمسجد الأقصى؛ المدينة: مدينة الحضارة، ومكة: الفتح الإنساني، والأقصى: المعراج الحضاري. القدس ميدان النقد منا ولنا وفينا. فلا نريد تحرير القدس مرة عبر طهران، ومرة عبر الكويت أو غزوها، ولكن نريد تحرير القدس تحريرًا للبلاد وللعباد، وقبل كل ذلك تحريرًا للإرادات. ومن هنا، فإن القدس ليست معركةً واحدة، بل هي حربٌ كبيرة ومهمة يجب أن نخوضها مع أنفسنا تمهيدًا لخوضها مع مَنْ يريد أن يخرج القدس من كيان الإنسان وحقيقة العمران. هنا فقط يمكننا أن نتدبر أسماء آخر معركتين “معركة سيف القدس” والتي حملت شعار “وحدة الساحات”؛ والمعركة الكبرى التي حملت الاسم الكبير “طوفان الأقصى”؛ وفي هذا استلهام عظيم.
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)